![]()
د. تهاني محمد
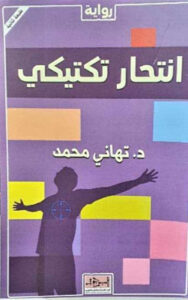
لم يعيدوني إلى زنزانتي المعتمةمرة أخرى، ولا أعلم لماذا.. فهم لايأبهون كوني أصبحتُ بكليةٍ واحدةٍ وبساقٍ معوجَّة.
فما الذي دفعهم أن يبقوني تحت المراقبةالمشددة في المستشفى لشهر ونصف! وفي غرفة منعزلةٍ يقفُ على بابها عسكريان يتناوبان على حراسةِ غرفتي، وينصتان لحركاتي وسكناتي، هل عمدوالتنظيفِ السجنِ من آثارِ جرائمهم لسبب ما؟
وهل علي أن أصدِّقَ قصةَ الحصاةِ الكبيرةِ الناتئة التي احتلّتْ كليتي، فرفعوها وتركوني بكليةٍ واحدة ؟
أنا لا أذكر شيئاً عن آخرِ ليلةٍ قضيتها في الزنزانة القذرة، سوى بعضٍ من خيالاتٍ متفرقةٍ تجثمُ على صدري كأنها صخرةٌ ضخمةٌ من جبال الجحيم.
أذكر ركلاتِ الثورِ الهائج أجدع،وعصاه الكهربائية التي تلسعُ جسدي، فترميني مثل كرةٍ أهتزُّ وأتدحرج على الأرض، وصرخاتي بعد كل ركلةٍ على ساقي المصاب، هذا كل شيء.
******
سلّموني كتاباً موقّعاً من جهاتٍ عسكرية عليا بأني غير مناسبٍ للخدمة العسكرية،لأنَّني بكلية واحدةٍ وساقٍ معوجَّة، ثم أخبروني أن أذهبَإلى البيت، وحذّروني من أن أفتحَ فمي بأيِّ شيءٍ له صلةٌ بماحدث في الزنزانة، وأنني سأكون تحت المراقبةِ، حتى أنهم قد يستدعوني للاستجواب في أيةِ لحظة.
هل كنت أحمقاً ضعيفاً عندما قرّرتُإطلاقَ الرصاص على قدمي،فخرجتُ بساقٍ تالفٍ وكليةٍ واحدة؟!
هل لأنَّني أفكر، بأن لاأساقَ مثل البهيمةِ، يجب أن أُقتلَ،أو أخرجُإنساناً معاقاً من سجونهم؟
ألم تنتحرِ البغالُ من شدّةِالإنهاكِ على الجبهات الشمالية؟ ألم يجنَّ كثيرٌ منا، ويسلّم نفسَه للجيشِ المعادي بعد أن فقد قدرته على الصبر في الخنادق لسنواتٍ حمراء وسوداء لا نهار فيها!
حتى الأطفال استبدلوا لعبةَ الغمّيضةِ في حيّنا بلعبةِ القاتل والمقتول، كان أكبرهم سنّاً يحملُ مسدّساً بلاستيكياً، ويتقمّصُ دورَ الرامي خلفَ الساتر، فيما يتقمّصون هم دورَ الضحية، يهربون ويصرخون ثم يسقط أحدهم أرضاً، وقد غطّوا رفاقه جسدَه بالعلمِ ورفعوه على أكتافهم يصرخون الله أكبر، فيما يتقنُ هو دور الشهيد.
هل أنا معتوهٌلأنَّني أتألم ولأنَّني غير راض؟ ولأنَّني أستنكر النذالة! لقد خلقني الله من دمٍ دافئ وأعصاب . إنَّ النسيجَ العضوي لابد وأن يتجاوبَ مع المؤثراتِ الخارجية، لذا إن شعرنا بالألم، نصرخ ونبكي، وأن رأينا النذالةَ؛نغضب.
عدتُ بعد ثمانيةِأشهرٍإلى المنزلِ، كان الشتاءُ قد حلَّ وسماءٌ رماديّةٌ ملبّدةٌ بغيومٍ سوداء تخيّم على بغداد، طرقتُ البابَ بيدٍ ناحلةٍ، ففتحتْ لي المرأةُ المسكينةُ البابَ وكان السوادُ يغطّيها من قمةِ رأسها إلى أصابع قدميها، يبدو أنها تقبّلت موتي وفقداني، ولبستْ السوادَ. لاأدري هل أخذتْ في روحي العزاء من الأقارب والجيران،أم جلستْ تنتحبُ وحيدةً في وكرنا المتهالك.
– حسيييييييين!!!يا ألله…
“يمة وليدي، معقولة رجعتلنا…حسين! يمة فدوة أروحلك”
كانت تحتضنني بكلِّ قواها المتبقية، تشمني، تقبّل وجهي ورأسي، تغفو على صدري كأنها هي طفلتي، ترتعش رهبةً وفرحاً، وتصرخ باسمي بصوتٍ متقطّع..ح..س..ي.. ن.. حتى أغمي عليها وهي بين يدي.
صرختُ..أمي، أفيقي أرجوك..
أخذتها بين ذراعي ووضعتها قربَ المدفأةِ، ثم رششتُ وجهها ببعضٍ من الماء الباردِ، فوجدتها تحاولُ فتْحَ عينيها المجْهدتين بصعوبة..وحين أفاقتْ من غيبوبتها سألتها:
– أمي، لماذا تلبسين الأسود، هل أخبروك بموتي وصدقّتي بخدعتهم؟
لم تجبني، كانت ما تزال في خضمِّ دهشتها، وراحت تحدقُ في وجهي، وتضمني إلى صدرها، كما كانت تفعل حين كنت صغيراً وحين كان حجرها وصدرها بيتي ومخدعي.
جلستُ متربّعاً على الأرضِ بجوارها، قربَ المدفأة،أنصتُ لقطراتِ المطرِ التي تنقرُ النافذة.. فقد أطلقتِ السماءُ غيظَها برذاذٍ قليل، ثم بدء يشتدُّ حتى صار ودقاًشديداًيبللُ واجهاتِ البيوتِ ويضرب النوافذ.
وضعتُ ذراعي على كتفها الذي تبرز منه عظامها الصغيرة، واحتضنتها.وأنا أردُّ على أسألتها الكثيرة، بما يناسبُ ضعفَ قلبها وجسدها..أخبرتها عن حماقتي وإطلاقِ الرصاصةِ على ساقي، واخترعتُ كذبةً كبيرةً عن احتجازي في سجنٍ نظيفٍ للتحقيق معي. ولم أخبرها كيف كانوا يعاملونني مثل كلبٍأجرب. يطفئون أعقابَ سجائرهم في جسدي، ويتبوّلون على جرحي المفتوحِ في ساقي حتى تقيح.
خبأتُ عنها قصة كليتي المفقودة، ورفعتُ في وجهها كتابَإعفائي من الخدمة العسكرية، كي أريحَ قلبها،مستفيداً من عدمِ معرفتها للقراءة والكتابة، فلايمكنها تمييز سببَإعفائي على أنني معاقٌ وبكليةٍ واحدة.
(17)
ثلاثةُأيامٍمرّتْ على وصولي إلى البيت، وأنا أتصل بندى، لكن في كلِّ مرة كانت والدتها هي من يرد على الهاتف، صورتها وهي مقيّدةُ اليدين، والدموعُ السوداءُ تغرق وجنتيها الناصعتين، لا تفارق مخيلتي، أعلم أنها تعتبرني خائناً لها ولم أفِ بوعدي، لكنني قلقٌ جداً، ولا أدري ماذا حل بها.
قررتُأن أتكلّمَ مع والدتها، وأسالها عن ندى، فأدرتُ قرصَ الهاتفِ وانتظرت الرد:
– أللووو
– مساءُ الخير
– أهلا بني، من يتكلم
– عفواً، أنا زميلُ ندى في العمل..كنت مسافراً لأسبوعٍ كاملٍ، وقد عدتُ اليوم.الحقيقةُ لدي خللٌ في تدقيقِ الحساباتِ، وأبحث عن الست ندى، طالباً المساعدة.
– أنت زميلها قلت لي؟!
– نعم
– إن كنتَ زميلها في نفس المكانِ، فكيف لا تعلم أن ندى تركتِ العملَ منذ شهرين، وتزوّجت، ولم تعد تسكن معي الآن، يابني، إنها في بيتِزوجها العقيد سلام في حي اليرموك.
ارتجفتْ يدي..انتقلتْ الرجفةُ لسائرِ جسدي، لروحي، شعرتُ بالدوار، وكأنني غبتُ عن الدنيا في دوّامةٍ بلا لون، وقعتْ سماعةُ الهاتفِ من يدي،بينما أم ندى في الطرفِ الآخر من الهاتف،وكأنها تصرخ من عالم بعيد.
– ألللووووو..ألوووو
راحتْمعاولُالأسئلةِ تحرث في رأسي.. كيف يمكن لندى أن تخونني! كيف لها أن تسحقَ تحت قدميها كل ما حلمنا به وخططنا له معا؟! كنتُ أود أن أبصقَ دمَ حزني في وجهِ عقيدها المشؤومِ، ضخم الأنف ذاك، كم مرةٍ حدّثتني عنه ندى، كان جلدها ينكمشُ وهي تخبرني بطلبهِ للزواج منها، عقيدٌ أرملٌ بلا أطفالٍ تُوفيتْ زوجته في حادث سير، يعاقر الخمر، هوايته المفضلةُ إطلاقُالرصاص على الطيورِ والحمام، وهي تحلّق وتدور تحت السماء الزرقاء، فتتساقط واحدة تلو أخرى بريشٍ ملطخٍبالدم على الرمال الساخنة للبرية.
في حي اليرموك إذن يا ندى! حيُّ الأغنياءِ وليس حياً شعبياً فقيراً نتكدس فيه مثل البهائم في المسلخ، وزوجٌ برتبة عقيد..حلقتِ نحو رغدِ العيش يا ندى،ونكثتِ عهداً حفرتُهُ في نخاعِ عظامي وأضلعي…
اخترتِ رجلاً غنياً.. ماذا سيعطيك أجيبيني؟ بعضَ الأحذيةِ والفساتين من الماركاتالعالمية، عطوراً مستوردة، أرائكاً وثيرةً فارهةً وسجاداً فاخراً، أريكةَكيلوباترا، المصنوعةَ من ريشِ النعام، أم فراشَ هارون الرشيد العائم؟!
أتعلمين شيئا؟…كنت سأعطيك أنا كُلّي.. نعم كلي..
لكن ماذا ستفعلين برجلٍ لا يمنحك سوى قلبه، رجلٌ معاقٌ ..مثقوبُ الجيب، حرُّ الفكر، يلعن القيودَ ويستنكرُ أن يُساقَ الرجالُ سوقَ البهائم؟ ربما أنتِ محقّةٌ يا ندى،فماذا سيمنحك قلبُ عاشقٍ مفلس، يحملُ في كفّهِ فتاتِ الخبزِ للحمام، بدلاً من بندقية الصيد على كتفه، رجلٌ يُطعمُ الطيورَ، وينصتُ لهديلِ الحمائم، وتغريدِ العنادل.. يزدري صيدها، ويشمئزُّ من لؤمِ صيادها.
(18)
ساقونا إلى الجبهاتِ قسراً، كُنّا بين مؤمنٍ ومعتقدٍبما يقاتل ويدافع عنه، وبين رافضٍ منساقٍ جبراً، لكن عندما تمتدُّ وتطولُ الحربُ مثل لعبةِ جرِّ الحبلِ ويُسحقُ الرجالُ كأنهم أسرابُ نملٍ لاتساوي شيئاً في نظرهم؛ لاتصدِّقُ بعدها أنَّ من يقفُ على الجبهاتِ هو مؤمنٌ بحب الوطن..إنه يقف رغماً عنه، فسياطهم تلوحُ في وجهه، وسجونهم تغصُّ بالفارّين من الخدمةِ العسكرية، شبابٌ تفتّحوا مثل الرياحين والأزهار حين أبصرتِ ضوءَ الشمس،ساقوهم مثل الخرافِ ليدافعوا عن مجدِالزعيمِ، وكان جزاءُ رفضِهم؛وصْمُهم بعلاماتٍ فارقةٍتدلُّ على التخاذلِ والخيانة.
كانوا يقطّعون آذانهم وألسنتهم، ويوصّمون جباههم بخطٍّ أسودٍ غليظ، كي يبقى العارُ يلاحق رجولتهم مدى الحياة.
لكن أيٌّ عارٍ هذا؟ هل أصبح حبُّ الحياةِ ورفضُما لا نؤمنُ به عارا؟
نحن في السنةِ السابعةِ من الحرب، والرفاقُ والقادةُ يعيشون في القصورِ يقتسمون أوهامَالنصرِ الكاذب.
خرجتُ من سجونهم معاقاً، حبيبتي استباحها ضابطٌمن ضبّاطهم برتبةِ عقيدٍ في الجيش، يؤمن بما يؤمنون به، وهو – بالتأكيد – يحملُ شارباً أسوداً طويلاً على وجههِ مثلَ شواربهم، وينظرُإلى الناسِ باستعلاءٍ كما ينظر زعيمهم.الكلُّأصبح نسخةً من الزعيم، يرتدي البذلةَ العسكرية ويرفعُ أنفه ورأسَهُ بكبرياءٍ مزيّف، يضحك كما يضحك الزعيمُ، ويمشي كما يمشي، ويتكلم بمفرداتِ الحزبِ، والثورةِ، والحرية، والاشتراكية، كما يتكلم هو.. إلا سيجاره الكوبي الفاخر لم يجرؤ أحدٌ على حملهِ بين شفتيه تحت شواربهِ مقلداً الزعيم، ربما لو فعل سيغمسون رأسَهُ في المنفضةِ بدل السيجار.
كلهم رؤوسٌ فارغةُ ترددُ شعاراتٍ مستهلكةٍ كي يحتفظوا برتبهم العسكرية،والنجومِ الذهبيةِ على أكتافهم.
لم نكن مواطنين.. كُنَّا مجموعةُ خرافٍ بيد جزّارها.
سرقوك مني ياندى…
صار نهاري مظلماً، وليلي طويلاً، أتقلّبُ بنارِ شوقي إليك، محاولاً التغافلَ عن جرحي،والتناسي، حتى ينفدَ ما تبقّى لي من النسيانِ في قعرِ الزجاجة، فأبدأ برجمِ تلك الزوايا المظلمةِ حتى أملاها بشظايا الندم.
سرقوك مني حبيبتي…
الآن فقط فهمتُ معنى تلك الرؤيا المشوّشة، وأنا بين الحلمِ والواقع،أترنَّحُ على سريرِ غرفةِ العنايةِ المركّزةِ الأبيض.
يداك المقيّدتان..دمعك الأسود.. فستانُ الزفافِ الذي كنتِ ترتدين.. سرقوا عشبَ عينيك ياحبيبتي، وحوّلوه إلى حقلٍ يابس أضرموا النار فيه.
إنهم يضرمون النارَ في كلِّ خضرةٍ حولهم، في كلِّ رأسٍ تدورُ فيه فكرةٌ تعارضُأفكارهم.
هشّموا كليتي اليمنى..لاأعرف على وجهِ التحديدِ ماالذي حصل في سجنهم الأسود، واحتلوا حبيبتي برتبهم وأموالهم..
أشعلوا النار في قلبي ياندى، ناراً لن تنتهي، فهم ماهرون في إشعال النيران..وهاهي مشتعلةٌ منذ سبع سنوات.. ولا أظنها ستخمد.
(19)
(الهدنة )
لم أتمنَّ أن أمتلكَساقين قويتين، وجسداً شابّاً كما تمنيته هذا اليوم، الفرحةُ تقفز من صدري وروحي، تسحبني إلى أصواتِ الزغاريدِ هناك.كلُّ جاراتي خرجنَإلى الشارعِ يزغردْنَ ويرقصْنَ بحركاتٍ مضحكة، لكنها من القلب، فقد حصلَ ما لا يخطر على البال.
قد انتهتِ الحربُ.. يا إلهي! لا أكاد أصدق.. لستُ وحدي المجنونةُ هنا من الفرح، فقد جُنَّ الجميع.
إنهم يتجمّعون في كلِّ مكان.. الأزقةُ والساحاتُ تكتظ بالناس، يرقصون بجنون، ويضحكون بهيستيريا… انتهتْ حربُ الثمان سنوات في يومٍ وليلة.
حسين.. حسين..هيا يا ولدي، اخرجْ واحتفلْ مع الجيران، فلم يبقَ أحدٌ في بيتهِ سوى العجائز أمثالي، ولو لم تمنعْني مفاصلي المتهرئةُ من الخروج؛ لخرجتُ ورقصتُ مع الناسِ حتى الصباح…
– نعم يا أمي، انتهتِ الحرب، انتهتْ الخديعة، انتهتْ أطولُ حربٍ في تاريخِ القرنِ العشرين، والتي كان ممكناًأن تنتهي منذ أول سنةٍ لها. دعيهم يرقصون.. دعيهم، قد جُنَّ الناسُولا ريبَ،فالمجنونُ لا يعلم لماذا يضحك، ولماذا يبكي أحياناً أخرى..
– شششششش اسكتْ ياحسين، مابك! أتريدُأن يرموك في السجن مرة أخرى؟
اتركِ الناسَ وشأنهم، إنهم يحبون الرئيسَ ويفدونه بدمائهم.
-أضحكتيني والله يا أمي، حتى أنتِ يا حاجّة! تتكلمين مثل الأهازيجِ الوطنيةِ التي صدَّعَ رؤوسنا بها التلفازُ والمذياعُ ليلَ نهار.”بالروح بالدم نفديك يا…..”.
اسمعي يا أمي، إنَّ الرجلَ لايقوى على البقاءِ ساكناً هكذا دونَ حروب، فأين سيجدُ مجدَهُ وعظمتَهُإذا عشنا بسلام! انتظري وسوف ترين، إنها محضُ هدنةٍ تافهة، يخدعُ بها المساكين،لكنه سيسوقنا إلى حربٍ جديدة.. أنا واثق من ذلك..
لكن مع من ستكون تلك الحرب ومتى؟ وحده الله يعلم.
هل تعلمين كيف دخلنا الحرب ياحاجة؟ دخلناها بعد أن تراجعنا عن اتفاقٍ مبرمٍ في سنة 1975وحاربنا ثمانية سنوات، ودفعنا آلافَ الضحايا، ثم انتهتِالحربُ بعد أن عدنا واعترفنا بتلك الاتفاقية مرغمين.
– لا أفهم ما تقول يا حسين، على ماذا اتفقنا، ولماذا نقضنا الاتفاق؟
– وأين ذهبت أنا يا حاجة.. صبّي لنا الشاي وسأقصُّ عليك الحكايةَ، لكن أعديني أن لا تأتيك الكوابيسُ ليلاً.
غادرتنيأمي،ودخلتْ تعدُّ الشايَ في المطبخِ، وبعد عشر دقائق عادتْوهي تحملُ بيدها أكوابَ الشاي التي تفوح منها رائحةُ الهال ووضعتها بيننا ثم بادرتني قائلة:
– احكي لي الآن الحكاية..
– يا للعجائزِ كم تعشقن القصص والحكايات.
– اخرسْ يا ولد، أنا لست عجوزاً..ألم ترَ ضفائري؟َ خذْ قلبها بيدك إن وجدتَ فيها شعرة شيبةً واحدة؛ تكلم ساعتها بما تشاء.
– حاضر يا ست البنات، اسمعي:
كان ياما كان في قديمِ الزمانِ ولا يحلو الحديثُإلا بذكرِ الرسولِ عليه أفضلُ الصلاة والسلام..
– ما بك يا ولد، هل تراني طفلةً صغيرةً تحكي لها حكايات ما قبل النوم؟ هيا تحدّثَ كالرجالِ. أريد أن أفهمَ في السياسة كما تفهمون أنتم.
– الله الله يا أم حسين..تتهمينني بأنني أحشر أنفي في السياسةِ، وأقرأ الكتبَ التي تتلفُ عقلي وتفكيري، وتبين أنني ورثتُ هذا عنك.
اسمعي يا أمي اتفاقية 1975 تُسمى باتفاقية “الجزائر” وقد وقعها نائبُ الرئيس العراقي والذي هو الرئيس اليوم.مع شاهِإيران الذي كان يحكمها آنذاك،وكانتْ بحضورِ الرئيس الجزائري “هواري بومدين” ولذا سُمّيتْ باتفاقية الجزائر.
– طيب عرفنا الاسم الآن.. لكن على ماذا اتفقنا؟ هل تشاجر معنا هذا الشاه على نفطٍ،أممال؟
– لا.. لا هذا ولا ذاك، بل كان بيننا وبينهم خلافٌ عميقٌ بعمقِ التاريخِ على النقطةِ الفاصلةِ في مياهِ شطِّ العرب، والتي ترسم حدودنا مع حدودهم الدولية، وهذه النقطةُ تُسمى نقطة خط القعر، وتعني النقطةُ التي يكون فيهاا لشطُّبأشدِّ حالاتِ انحداره.وهذا الكلام رفضه العراق تماماً وقال:إنَّ شطَّ العربِ كلهُ مياهٌ عراقية ولادخل لإيران فيه.
شربتْأمي كوبَ الشاي الساخنِ، وشمّرتْ عن ساعديها استعداداً لحديثٍ طويل:
– هذا الكلام صحيح..
إنَّأسمَهُ شطُّ العرب، هذا يعني أنه ملكنا نحن العرب.
-تريّثي قليلاً يا أم حسين، ولا تأخذْك الحماسةُ، دعيني أكملُ حديثي بالله عليك
اسمعي يا أمي:
في سنة 1975قامتْالحكومةُ العراقية بتوقيعِ الاتفاقيةِ مع إيران، ووافقتْ على (نقطة القعر) في شطِّ العربِ لرسمِ الحدود بيننا.
لكن حين حدثتْ الثورةُ في إيران وقُتلَ الشاه تراجعنا عن تلك الاتفاقية، فشبَّ النزاعُ بيننا من جديد.
– يعني صارتِالحربُ بسبب البلوةِ السوداء.. نقطة الصفر
– نقطة القعر ياأمي.. القعر
– أوووه يا حسين دوختني.. صفر أو قعر ما دخلنا نحن..المهم انتصرنا
– انتصرنا!..على من ….ياحاجة على من انتصرنا أخبريني؟ دخلنا أطولَ حربٍ في القرن العشرين، وخرجنا منها دون أن نحدثَ تغييراً في التاريخِ، سوى تسجيلٍ عددٍ قياسي من القتلى والمعاقين.
أتعلمين من نشبه نحن يا أمي؟
– من يا حسين ؟
– نحن نشبه فيلاً حِيكتْ عليه مؤامرةٌ من أجلِ ترويضه.. انهالوا عليه عشرةُ رجال، أو يزيد، ضرباً بالعصي والهراوات، وحبالهم تقيده بالكامل، ثم دفعوا به نحو حفرةٍ عميقةٍ، وحين سقط فيها مغلوباً على أمره؛ راحوا يضاعفون ضرباتهم عليه حتى أصابهالإنهاك الشديد.عندها يأتي رجلٌ من خارج تلك المجموعة من الرجال الذين أشبعوا الفيلَ ضرباً، وقد ارتدى لباساً مميزاً، فيرفع ذراعه، ويأمرُ الرجالَ بالتوقّفِ عن ضربِ الفيل، يطيعُ الرجالُ أمره ويخرجون من الحفرة، تاركين الفيلَ فيها. وهكذا تعادُ هذه المسرحيةُ كل يوم، فيعذِّبُ الرجالُ الفيلَ بهراواتهم، ثم يأتي الرجلُ المنقذُ ويمنعهم عن فعلهم المشين، وقد تستمر تلك المسرحية عشرة أيام أو أكثر، حسبما يحدده الرجل المنقذ، وبعدها يأتي يومُ ختامِ المؤامرة، يومُ خلاصِ الفيلِ على يد المنقذ الذي يأتي في اليوم الأخير، فيرفع ذراعَهُ، عندها يرمي الرجالُ عصيَّهم ويخرجون من الحفرة تاركين الفيلَ والرجلَ المنقذَ فيها. يمتطي المنقذُ ظهرَ الفيل، ويأمره بالخروج من الحفرة بمساعدةِ الرجال، فينحني الفيلُ صاغراً، مطمئناً، مذعناً لأمر منقذه وسيده، ويسيرُ الفيلُ، والمنقذُ يعتلي ظهره.. وقد آمنَالفيلُ المخدوعُواعتقد تمام الاعتقاد ببراءة منقذه، وحسنِ نيّتهِ، وسعةِ فضله، ومن المحال أن يرفضَ لمنقذه أمراً بعد اليوم، أو يخالجه الشكُّ في صفاءِ سريرته.
-أووووهكفاكهذيان ياحسين..ما بك يا ولدي أنت تهذي كمن تلبّسه جِنٌّ خبيث.. تعال معي عند الشيخ أبي محمود، دعْهُ يرقّيك بآياتِ الله، فيُخرجَ منك كلَّ خبيثٍ تلبَّسك.
-قد أصبتِ والله يا أمي..
-ماذا ! هل وافقتَ أن تأتيَ معي عند الشيخ أبي محمود؟
– كلا يا أمي المسكينة الطيبة، أنا لا أتحدث عن شيخكم، لكنك أصبتِ في نعتِ كلِّ من فهمَ الحقيقةَ بالمجنون، نعم إنَّ من يكتشفَ الحقائقَ لن يسمحَ بأن يعتلي ظهره منقذٌ دجّال.
********
لم تكن أمي تعي غير ما تسمعه من الهتافاتِ الحماسيةِ التي يضخّها لنا التلفازُ والمذياعُ ليلَ نهار.وماذا يريد الناسُ البسطاءُ أمثال أمي سوى السلام! بل ماذا يريد الناسُ غيرُ البسطاءِ أمثالي سوى السلام! ألم يكن هناك حلٌّ لننعمَ بالسلام! أم إنَّ تلك الكلمةَ نُزعتْ من القاموس لأنَّها خرافة، مثل طائرِ العنقاءِ، أو حورياتِ البحرِ ذواتِ الأثداءِ العاجيةِ والشعور الطويلة؟
وربما تطالنا الخرافةُ نحن أيضاًطلابُ السلام في يوم ما.. فتقصُّ الجداتُ حكايتنا على مسامعِ الأطفالِ، تحت ضوءِ الفوانيس الخافتِ في رداء العتمة، بين الجبال العالية، أو في خيمِ البدو الرُّحَّل مع طقطقةِ فناجين القهوة المرة!
(20)
سنتان وديعتان.. لملمتِ الناسُ فيها جراحَها، وملأتْ رئاتها من الهواء النقي غير الممزوج بالدخان والبارود، ولملمتُ فيها أنا بعضاً مني، محاولاً ترميمَانكساراتي، ومدارياً ألمي.
خبَّأتُ عينيك العشبيّتين في ذاكرتي.
نعم، أعلم أنك ملكُ رجلٍ آخر.. تنثرين الربيعَ في زوايا بيتهِ بخضرةِ عينيك.
أتذكرين حين كنتُ أغني لك؟
ما زلتُ أدندنُ بتلكِ الكلماتِ حين يغشي خيالك وحدتي، ويحملُ لي نسيمَ الصباح شذاك:
يانبعة الريحان حني على الولهان.. حني على الولهان..
جسمي نحل والروح ذابت وعظمي بان ذابت.. وعظمي بان
من علتي ال بحشاي ما ظل إلي من راي.. ما ظل ألي من راي
دائي صعب ودواي ما يعرفه إنسان.. ما يعرفه إنسان..
الخيالُ هبةٌ من الحياةِ، تتعطفُ بها على كلِّ عاشقٍ مفلس. ستسكنين أحلامي يا ندى ما حُييتُ؛ إنه وعدُ عاشق.. ولن يخلفَ العاشقُ المجنونُ وعده.
*******
تزوجتُ بعد أن انتهتِ الحرب، وبعد أن أقسمتْ أمي أنها ستضربُ عن الطعامِ إن لم أتركْ جنوني وأتزوج، كانت ترتعدُ خوفاً عليَّ، وتعتقدُ بأنني جننتُ بسببِ حبسي في الزنزانة، وبسببِ وحدتي، أهيم على وجهي دون زوجة أو حبيبة.. يا للعجائز، كم يملكن من خيالٍ واسع!
ليس خيالهن فقط هو الواسعُ، بل شبكةُ اتصالاتهنَّ العجيبةِ، والممتدةِ من حيٍّ إلى حي، فقد كانت تعرض عليَّ كلَّ ليلةٍ خارطةً لبناتِ الحي، وتطلبُ مني أن أختارَ زوجةً منهنَّ، وقد كانت تذكّرني بفعلها هذا، بصاحبِ محلِّ الستر الرجالية، وهو يضعُ أمامي ستراً بألوانٍ وموديلاتٍ مختلفة،منتظراً مني أن أختار سترتي.
أظنُّ أن شريكَ حياتنا هو من ينادينا، ولسنا نحن من نبحثُ عنه.. شيء ما فيه سيجذبك، سيقول لك اقترب، أنا بيتك؛ وهذا عينه ما حدث معي.
كنت أصادفها كل صباح عند خروجي لعملي، فتاةٌ شقراءُ بضفيرةٍ تنسدلُ حتى ما بعد خصرها الرقيق، عيناها البنّيتان تملئاني بالراحةِ والسكينة، أحسستُ أن عينيها تخبرني بشيءٍ تحاولُ هي إخفاءه، وميضٌ يفضحُ مشاعرَ حبٍّ يغمرُ روحها، لكن لسانها يرفض التصريح.
زوجتي سلمى امرأةٌ طيبة، تعملُ باحثةً اجتماعية في المدرسة الثانوية للبنات، الواقعةُ على رأسِ الزقاق الذي يقع فيه بيتنا، كان زواجي ضرورةٌ من ضروراتِ الحياةِ الكثيرة، ولم يكن بدافع الحب.لكنني الآنأكنُّ لها مشاعرَ الودِ والامتنان، فقد جاهدنا معاً طيلة سنوات زواجنا، وأنجبتْ لي أولَ طفلٍ بعد سنةٍ واحدةٍ من زواجنا، أسميته علي، على اسم والدي، ولأحققَالرغبةَالملحّة لوالدتي.
مشكلتي الوحيدة في زواجي هذا هو والد زوجتي، إنه بهلوانٌ متمرس، رجلٌ انتهازي، لا يحمل ولاءً سوى لنفسه وأمواله.
فكلما قدّمَ كشفاً بأسماءِ رجالٍ رفضوا الانتماء لحزبهِ؛ يُكافأ باعتلاءِ السلّمِ درجةًأخرى.
الأستاذ شاكر والد زوجتي، رجلٌ قصيرُ القامة،أصلعُ الرأس، له عينان كعيني الصقر، ولسانٌ مثلُ شفرةٍ حادة.يتجنبونه الناس حفاظاً على ماءِ وجوههم، ويتملّقون له آخرون خوفاًوطمعا.
كلما رأيته وددتُ لو غسلتُ صلعته بالرمال الساخنة..
فالهدنةُ القصيرةُ انتهت، ولم تمر على سعادةِالناسِ بانتهاء الحرب سوى سنتين. وفي صيفٍ قائظٍ لشهرِأغسطس جُررنا إلى هوّةٍ سحيقةٍتسمى غزوا.. غزو دولةِ الكويت، الجارةِ القريبة جداً.
إنه المهرُ الذي علينا أن نقدّمَه كي يرضى الزعماء، نقدّمُ حياتنا التي لانملك سواها؛ كي يحققَ الرؤساءُ مجدَهم الفردي.
لكننا لسنا في زمن المعلّقات ، ولا زمنِ الفتوحات، إننا في زمنٍ تحكمُهُ الولاياتُ المتحدة، وتحفر البئرَفيه إسرائيل.. ليسقطَ فيه الأغبياء.
فها نحن في بئرٍ مظلمة، نعيشُ في قاعِها منذ عُوقبنا بحربِ الخليج الثانية،جزاءَ غزونا للدولة الجارة..عُوقبنا على فعلٍ لايدَ لنا فيه.
وبدل عملٍ واحدٍ، صرتُ أعمل صباحاً ومساءً كي أسدَّ حاجتي وحاجةَأولادي الأربعة اللذين رزقت بهم في سنواتِ الحصار والجوع.
كنتُ أشتري الملابسَ المستعملةَ،أنظّفها وألبسها؛ كي أتمكنَ من أن أوفّرَ لأولادي ملابساً جديدة، إنها لعنةُ الغزو.. سنواتٌ من الحصارِ لم تبقِ لنا مانسترُ به أجسادنا..
باعَ جاري السجادةَ الوحيدةَ التي يجلس عليها في الشتاءِ ليدفئَ عجيزتَه اليابسة.واشترى بثمنها طحينا ورزّا.
كان بعضُ الناسِ يُقْدِمُ على الانتحارِ حفاظاً على كرامته من الهدر، كانوا يفضّلون الموتَ على أن يمدوا أيديَهم للناسِ ولذلِّ العوز.
في أحدِ الأيامِ سمعنا أنَّ رجلاً من البصرةِأقدم على قتلِ بناته الأربعةِ من شدّةِ الفقر.. فضّلَ قتلهنَّ على تشردهنَّ وضياعهن,أحياناً يتمنّى أحدنا الموتَ من شدّةِ بؤسه, كلما شاهدتُ الأطفالَ بثيابهم الرثّة في الطرقاتِ؛ أتذكّر تلك اللوحةَ الحزينةَ للرسامِ الدانماركي “هانز أندرسون” وهو يصوّر صبياً صغيراً متشرّداً، شاحبُ الوجهِ، ناحلُ الجسمِ، قد أخذَ منه الجوعُ مأخذاً,يختبئ خلف الجدار من البردِ والعواصفِ في قريةِ صيدِ الأسماك، ويظهرُ الموتُبهيأةِ رجلٍ عجوزٍ مخيف، محدودبُ الظهرِ، يضعُ يدَه اليمنى على رأسِ الصغير، فيما تحمل يدُهُ اليسرى منجلاً يخطفُ به الأرواح..كان اللونُ الترابي يخيّم على اللوحة، وملامحُ الطفلِ والعجوزِ تبيّن أنَّ الموتَ قد يكون رحمةً للصِبيةِ المتشردين.
سنواتُ الحصارِنشّفتِ البطونَ،وكشّفتِ العورات…
إننا في القاع نقتاتُ الحصى والرمال.
لا أدري وأنا في جوعي ومعركتي مع الحياة.. هل كانت تعاني مثلي!
هل زوجةُ العقيدِ جرّبتِ الجوعَ والمهانةَ في هذه السنواتِ العجاف؟
ياترى..أين أنتِالآن يا ندى؟
هل أصبحتِأمّاً، هل أنجبتِ بنتاً لها لونُ عينيك العشبيتين؟
لا أعلم هل يحرّم اللهُ عليَّأن أشتاقك، وأتلهّفُ لنظرةٍ واحدةٍمن عينيك؟
أبنائي يكبرون يا ندى، ولدي عليّ بدأتْ تتفتحُ زهرةُ صباه وشبابُه هذه الأيام، لو رأيتيهالآن لقلتُأنَّ له لونُ عينيَّ العسليتين، ونظرةُ الإصرارِوالتمرّدِ نفسها.
هل مازلتِ تذكرين عيني ياندى! أم طَوتِ الأيامُ ذكراي،وصار وجهي نسياً منسيا..
(21)
كنا نفترشُ الأرضَ في غرفةِ المعيشةِ نتحلقُ حولَ صحنٍ من الخبزِالمنقوعِ بالبهارِ والماءِ والملحِ،كانت قد وضعته زوجتي وسطنا أنا والأولاد.كان هذا النوع من الطعام هو ما نلجأإليه حين ينفد كل مالدينا من مخزونٍ للرز والخضروات، وغالباًما كان ينفد بعد أول أسبوع من الشهر.مددتُ يديَّإلى صحنِ الخبزِ المطبوخِ، فلسعتِ السخونةُإصبعي،فأبعدت يدي بانتظار أن يبردَ الطعامَ قليلا،ثم جلتُ بنظري على أولادي الجالسين معنا، وانتبهتُإلى أنَّأصغرَهم سنّاًلم يكن في موضعهِ،فهممتُ بالسؤالِ عنه وقبل أن أبدأ سمعتُ صراخاً يأتي من صوبِ المطبخ، فركضتُأتفقّد الصغيرَ خوفاً من أن يكون قد ارتكبَ حماقةً، وراح يلعبُ بنار الموقد، وحين وصلتُإلى هناك شاهدتُ ولدي وقد أمسكَ بعنقهِالأجدعُذو الحدبة، الذي كان يعذبني في زنزانتي! ورأيتُ سفوداً مشتعلاً في يدهِ اليمنى، وقد علّقَ فيه قطعةً كبيرةً من اللحمِ المشوي، لكنِ الدم ما زال يتقاطر منها.وحين دققتُ النظرُ جيداً في قطعةِ اللحمِ؛أدركتُأنها على شكلٍ كليةٍ شويتْ على النار حتى تفحّمت، ولم يوقفْ تفحّمها نزفَ الدمِ منها.ثم راح يحاول إطعام ولدي الصغير من تلك الكليةِ الفاسدةِ،حينها صرختُ بصوتٍ كالرعدِفأدار المسخُرأسَهُ الكبيرَنحوي وعيناه تشتعلانمثل لهيبِ الجحيم الأسود،بينما كان ولدي يصرخُفزعاًشعرتُ بقدميه الصغيرتين تركلني في خاصرتي، رغم أنه لم يتحركْ من موضعهِ وكفُّالمسخُمطبقةٌ حول عنقه الصغير.
وحين أمسكتُ بطفلي من كتفيه، محاولاً سحبه من بين ذراعيّ وحشٍ الزنزانة ذاك؛ رفعَ طفلي من حدّةِ صراخهِ.عندها سمعتُ زوجتي سلمى تنادي باسمي حسين.. حسين..ما بك؟
وحين استيقظتُ، وجدتني ممسكاً بولدي الصغير النائم بيننا أهزّهُ بقوة، و قد راح صراخُه يوقظُ الجميع.
(22)
توفَّيتْأمّي خلال سنواتِ الحصار،وذهبتُإلى رحابِ ربِّها راضيةً مرضية، بعد رحلةٍ طويلة قطعتها مابين الصبر والجزع، وثقلِ ما تحمل من همومٍ.. نحن جزءٌ كبير منها..والحربُ تلو الحرب، ثم حصارٌ وجوع، ويبدو أنها كانت محظوظة، فغادرتْ قبل أن تحلَّ علينا حربُ احتلالِ أو تحريرِ بغداد، لا أدري أيّاً من المسمياتِ أختارُلأنَّها تعاسةٌ في كل الأحوال.
أغمضتْ أمي عينيها إغماضتها الأخيرة،بعد أن قُرّتْ عيناها وارتاحَ بالها بزواج أختي من ابن جارنا عمر الصباغ..الصباغُ لم يكن لقباًلعائلته، بل هو اسم الشهرةِ الذي أغدقه عليه أهلُ الحي تيمّنا بمهارةِ أصابعه في تدويرِ فرشاةِ الصباغةِ على الجدران،الحائلة اللون، أو التي لم تُلوّنْ بعد، عمر أشهر صباغ في بغداد، عمر الصباغ.. هكذا كانوا ينادونه.
لم يكن عمر ميسوراً، ولا حاله أفضل من حالنا، لكن أمي كانت تعد عمرا بمقامِ ولدها، وتردّدَ دوما أمام أختي فضائلَ عمر وشهامته، حتى اقتنعتْأختي بالزواج. ثم أنها كانت تمكثُ في كل صفٍّ دراسيٍّ سنتين حتى تتمكن من اجتيازه.
أما أنا فقد أعطيتُ موافقتي على هذا الزواج متأخراً، بعد أن أعيتني كل الحيل في تحبيبِ الدروس إلى أختي،التي لا تكره شيئاً في الدنيا ككرهها للدراسة.
فليكنِ الزواجُ حياةً أخرى لها،يبدو أنها لن تخفقَفي استيعابها.
كنتُ أزورُأختي كثيراً، فهي لم تبتعد عنا بعد زواجها، بل قد غيّرتْ مكانها فحسب، من بيتنا إلى بيت جارنا عمر، ولم أشاهدها في كل زياراتي تلك في حالة من عدمِ الرضا أبداً، يبدو أنَّأمي كانت تتميزُ بفراسةٍ كبيرة حين أكّدتْ لنا أنَّ زواجَأختي بعمرَ سيكون زواجاً سمته الودُّ والرحمة.
أمي لا تعرف القراءةَ والكتابة، لكن فطرتها كانت نقيةً، لم تلوثْها أفكارُ التطرّفِ والعدوانية، فلم تبالِ بكيفية ذراعي عمر حال صلاته، أكان يسبلهما أو يكتّفهما..كان يكفيها أنه يصلّي، وهو متوجّهاً إلى نفسِ القبلةِ التي نتوجّه نحن إليها عند صلاتنا…
هناك من يولدون بفطرةٍ سليمة، ثم يدلقون على بياضها المشعِّ نجسَ المياهِ الآسنة من تعصّبٍ غير مبرر. دوماً تنمو يرقاتُ البعوضِ والديدانِ حين يكون الماءُ راكداً في البرك والمستنقعات..من المثيرِ للدهشةِ أنهم يصرّون على إطفاء ظمأهم بالشربِ من المستنقعات، وكأنَّ ما فيها من عفنٍ رانَ على قلوبهم، فلم يعد بمقدورهم رؤيةَالماء الزلال.
(23)
لم يكن حالي يختلف كثيراً عن حال أمي، فقد كنا نتناوب أنا وهي القلقُ على مستقبلِ أخوي اليتيمين، وحين أكملَأخي دراسته وتخرّج من ثانويةِالصناعة، وأصبحتْ لديه خبرةٌ جيدةٌ في عملِ الكهربائيات للأبنية؛ مدَّ له زوجُأختي يدَ العونِ، وعرضَ عليهِالعملَسويةً مع المقاولِ البدين عبد السلام في أعمالِ تشييدِ الدورِ والمحالِ التجارية، كفريقِ عملٍ واحد، فيأخذ أخي بعملِ خريطةِ الكهرباء للأبنيةِ المشيّدةِ، ويقوم زوجُأختي بصبغِ الجدران والأبواب.
عرضُالعملِ هذا كان فرصةً غير متاحة للجميع، فحين تجدُ عملاً في بلد خنقه الحصار، وجفّتْفيه أمعاءُ الناسِ من الجوعِ لن يرفضهامتعالياً.. أيّاً كان نوعها.
ولا أدري كيف أصبحا أخي وزوجُأختي مثل توأمٍ متماثل.ربما هي ذائقتهما المشتركة،أو عملهما محاذيان لبعضهما طيلةَ النهار، أو روحُ الدعابةِوالنكتةِ التي تضجُّ بها روحيهما.
أو ربما هي تلك السمراءُ واسعةُ العينين،شقيقةُعمر التي طيّرت لبَّأخي وحولتْه إلى مجنونِ ليلى.. ترقدُ الهالاتُ السوداءُ تحت عينيه، ويشحبُ وجهه كلمّا مرّتْ سيرتها على لسان أمي.
كان ارتباكه يفضحُهيامُه بها،وحين رمقته أمي بنظرتها الثاقبةِ مثل نظرةِ خبيرٍمحترفٍ لكشفِ الجرائم، وفاجأته بسؤالها عن اهتمامه وسرِّ خجله وصمته وارتباكه حين تزور ليلى منزلنا، وهل هو واقعٌ في حبها؛ كانتِ ابتسامته العريضةُ تكفي لتحملَأمي نفسها وتلفُّ حولها عباءتها السوداء التي تغلق عليها خزانتها ولا تخرجها للنور إلا في الأعياد والمناسبات السعيدة،أو الحزينة وتنتعل(شحاطتها) السوداء الجلدية، ذات الحلقة الفضية في وسطها، وتحلُّ ضيفةً عزيزةً على أمِّ عمر، زوج أختي، طالبةً منها يدَ ابنتها الجميلةِ ليلى لأخي مرفقةً طلبها بجملة:
(لن أشربَ قهوتكم، إلا بعد قبولكم طلبي)
تزوّجَأخي من ليلى صاحبةِ العينين السوداوين الناعستين، وسكنَ في الطابقِ العلوي من بيتنا بعد أن أضافَ له حماماً صغيراً بجانبِ غرفةِ نومهِ وصمّمَ هو بنفسهِ الكهرباءَ وشدَّ مصابيحه وطلا عمر له الجدران والأبواب.فأصبحنا بعد زواجِأخي وأختي مثل قبيلةٍ تسكنُ في حيٍّ واحد، نجتمعُ في يوم الجمعة في بيتنا في الطابقِ الأول، الذي أسكن فيه أنا وأمي وسلمى زوجتي
وأولادي.
كان يحدث بعضُ الهمزِ واللمزِبين أخي وزوجِ أختي عمر، حين يرى من يصلي مسبلَ اليدين والآخرَ مُكتِّفَ اليدين،أو حين يرى أحدهما يسجدُ على تربةٍ صغيرةٍ بحجمِ قطعةِ البسكويت،والآخرَ يلصقُ جبهته على سجّادةِ الصلاة.
ورغم أنَّ”ويلٌ لكلِّ همزةٍ لمزة”إلا أنَّ الاعتدادَ بالرأي كان مشكلةً كبرى، تثير الجدلَأحيانا.
ولم تكن اجتماعاتنا يوم الجمعة على الغداء تخلو من بعض التقاذف بالكلمات بين أخي وعمر،إلا أنَّ ذلك لم يتعدَ حدودَ السخرية والجدل الأحمق بين شابين، يثير كل منهما الآخر حتى يدفعه للغضب ثم يختتما جدالهما بنوبةٍ من الضحك،فيبدو وجهُأخي المحتقنِ، كأنه حبةُ طماطم في أواخر موسمها،أما عمر بحاجبيه الكثيفين، واللذين زاد التقطيب من بشاعةِ منظرهما،يبدو مثل صقرٍ عجوزٍ حانقٍ مغتاظ.
(24)
كانت أمي تشاركنا غدائها الأخير في جمعتها الأخيرة،حين قرَّرَ ملكُ الموتِ النظرَ في وجهها، وأمرَ روحَها الطيبةَ بتركِ الجسدِ الترابي المتعب والتحرر منه نحو حياة أخرى نجهلها.
حينها كانت أمي تجلس بيننا متربعةً على البلاطِ البارد، في الجمعةِ الثالثة، من شهر تموز، تمسكُ بيدها كوبَ الشاي الساخن، وتنصتُ لحديثِأخي الطويل، حول رجلٍ كان قد صادفه في أحدِ المباني التي يعمل فيها لمدِّ الأسلاك الكهربائية على الجدران.
قال أخي:إنَّالرجلَ كان أحد العائدين من الأسر، فقد أخذه الجنودُ الإيرانيّون أسيراً هو ومجموعةً كبيرةً من الرجال في إحدى المعارك التي اشتدّتْأيام الحرب العراقية الإيرانية، وظلَّأسيراًهناك سنواتٌ طويلة،إلى أن عاد بعدانتهاء الحرب بسنوات،ولم يكنِ الرجلُ قد تزوّجَ قبل أن يذهبَ للحرب، وكان اسمه ضمن عدادِ المفقودين، لذا كان من الأفضل لمصالحِ أخوتهِالثلاث، الذين كانوا يديرون العملَ معه في محلٍّ لبيعِ الأقمشةِ في حي الكاظمية؛أن تكون كلمةُ مفقود تعني متوفي.. ليكون تكالبهم فيما بينهم واختلافهمذريعةًلبيعِ المحل الكبير، وتصفية الحسابات كلها.وحين عادَ الرجلُ من الأسر الطويل لم يجد شيئاًليعتاشَ منه.. ولا مال ليديرَ به تجارة جديدة، وقد أدارَ له أخوته ظهورَهم.. بعد أن كانت بيوتهم عامرة بسببه هو.
فأخوة يوسف لم تزلْ قصته تتكرر.. ولطالما كان الذئبُ مظلوماً، وبريئاً من دم يوسف.
قد عاد الرجلُ من أسرهِ الطويل في حال لا يحسد عليه، فهو قليلُ الكلامِ، لا يكاد ينطق بجملةٍ حتى يقطعها راكناً إلى صمتهِ مرة أخرى، منعزلاً، منغلقاً على عالمه الخاص،وكأنه ما زال في سجنه الذي عزلوه فيه، هو ورفاقه بعيداً عن العالم الخارجي، لا راديو، لا تلفزيون، لا صحف.. وكانوا يكثرون من جلبَ الكتبِ الدينيةِ لهم، حتى أقاموا مكتبةً خاصة بها داخل المعسكر.
يقول هذا الرجلُ الذي عاد من أسرهِ – وكأنه عادَ من الموتِ – أنهم كانوا يعاملوننا في الأسر على أننا كفّارٌ، أو ضالّون، أو علمانيون، أو أتباع آديولوجياتِ النظام الكافر، حتى أنّا كنا نصوم ونصلي مثلهم.
لم يكن أمام الرجلِبعد عودته وقد استحالَ حالُهُ ومالُهُ إلى إرثٍ تفرّقَ بين الأخوةِ؛إلا أن يحملَ نفسَهُ ليعملَ في طلاءِ الجدرانِ مع عمر، الذي لم يبخلْ عليه بالتوسّط لدى أبي سلام المقاول ليوافق على تشغيله معه.
كانت أمي تستمعُ لقصةِ الرجل وتُحوقلضاربةً كفّاً بكفٍّعلى ما آل إليه حالُ الرجلِ المسكين، فانتبهت إليها وقد شحب لونها،ووضعتْ يدها فجأةً على صدرها، وهمستْ بصوتٍ ضعيف:
– ولدي حسين، أشعر بضيقٍ في صدري.. وكأنَّ ثقلاً كبيراً يجثم فوقي..
قفزتُ من مكاني، وقرْفصْتُأمامها أمسح وجهها بماءٍ بارد، لكنها سرعان ماسقطتْ على جانبها الأيمن، مغمضةُ العينين، وقد توقفَ صدرها عن العلو والهبوط معلناً توقفَ تنفسِها.. صرختُ بها أمي.. أمي… بماذا تشعرين.. هل أذهب بك إلى المستشفى؟!!
كان الجميعُ قد تحلّقَ حولي، وأنا أحتضنُ جسدَأمي، واضعاً رأسي على صدرها.. مرةًأحاول الاستماعَ لدقاتِ قلبها، وأتحسسُبسبابتي رسغها مرة أخرى، باحثاً عن أيِّ أثرٍ للنبض، لكنها كانت قد غادرتنا إلى غير رجعة.
بعد وفاةِأمي أصبحَ البيتُ معتماً، كمن أطفأ سراجَهُ الوحيد، وراح يغطُّ في ظلمةٍ موحشة.
كنتُأمرُّ على خزانتها الخشبيةِالمصنوعةِ من خشبِ الخيزران، والمنقوشةِ بيدِ نجارٍ ماهر، يحسنُّ حفرَ الأخاديدِ والمرتفعاتِ على ألواحِ الخشب، حتى تبدو الزهرةُ التي حفرَها بأوراقها الكبيرة، والفراشةُ الحائمة حولها كأنها روضةٌ نبتتْ فوق لوحِ الخشبِدون أن تمنَّ عليها الشمس بالضياء.
كنتُ أقضي ساعاتِ حزني في غرفةِ نومِ أمي، أفتحُ بابَ خزانتها، وأبحثُ عن عباءتها السوداء المعطّرة برائحة المسك،تلك الرائحةُ التي تعبقُ من طيّاتِ ثيابِ العجائز الطيبات في الجنوب، حيث حرارةُ الشمسِ قد لفحتْ وجوههنَّ الودودة، وملأتْ قلوبهنَّ بعاطفةٍ لو وزَّعتها على الكوكبِ بأسرهِ ما كانت لتنفد.
أحتضنُ عباءتها وثيابها، وأشمّها طويلاً،فتعود بي رائحةُأمي إلى دفءِ ساعاتٍ مضتْ،حين كنتُ أقتربُ منها لأقبِّلَ رأسها ويديها.
عطرُ عباءةِ أمي، وخزانتها الخشبية، وغرفةُ نومها الصغيرة التي تركتها كما هي والتي لم أغيّرْ أيَّ شيءٍ فيها؛ كان يخففُ عليَّ عذابُ الفراق.لكن عذابي لفراقِ تلك التي غابتْ عني، ولم تترك لي أثراً منها لم أجد حلَّاً له.. ولا بلسمٌ يداويه، سوى علقم الصبر.
فحتى صورتها الوحيدة التي كنتُ أحتفظُ بها في جيبِ بذلتي العسكرية أيام الحرب العراقية الإيرانية، فقدتها في رحلتي الدهماء بين المستشفى والزنزانة.
لكن عينيها محفورتان في مخيلتي، وحبتا الكرزِ في شفتيها لم تذبلا في قلبي رغم الغياب.
وكثيرا ما كان يشتدُّ بي الشوقُ لخضرةِ عينيها ويجافي النوم جفني، فأقضي ساعاتِ الليلِ مع أقداحِ الشاي والسجائر، وأنا أدندن بصوتٍ خفيض تشوبه الحسرة:
من تزعل.. توحشني الدنيا واتخيل غيرت ظنونك
ومن ترضى.. يظل شوك البيه يذوبني بنظرات عيونك
بس حبك قدري المكتوب.. تدري شكد حمّلني ذنوب…
*******
قلبي يئنُّ يا ندى.. يئن…
وذاكرتي أرهقها الغياب..
ومنفضةُ سجائري تستغيثُ متّخمة..
لا الصبرُينفعني..ولا النسيانُ يواسيني…
مذاقُ المرارةِ في فمي..
والسكرُ في فناجيني..
ألا يا عشبيةَ العينين..
هل من موتٍ رحيمٍ يوافيني؟
(25)
مارينززززز
الوقت ربيعاً.. شمسٌ دافئةٌ تشقُّ اضطرابَ الغيوم، ورجالٌ من كوكبٍ آخرَ يحتلّون العاصمة.
صباحٌ جديد، وفزعٌ جديد.. خلاصٌ مدفوعُ الثمنِ سلفاً، فشعبٌ محكومٌ بالحديدِ والنارِ؛ لن يحررَ نفسَهُ بنفسِهِ…
ومادمتَ لا تقوى على تحريرِ نفسك، فاستعدْ لدفعِ ثمنِ الحريةِ للغريبِ، الذي مثّلَ دورَ المنقذ والمخلص، وابتلعتَ أنت الطعمَ دون أن تعي حقيقةَ عبوديتك الجديدة.
في ليلةٍ واحدةٍ انهارَ نظامُ حكمِالثلاثين سنة، اختفى الزعيمُ دون أن يجدَأحدٌ له أثراً، وذاب الرفاقُ مثلَ حبّاتِ رملٍ في نهر..
الجيشُ الأمريكي، وقوّاتُ التحالفِ تتجول في كلِّ مكان، رجالٌ ببذلاتٍكاكية، ونظاراتٍسوداء غريبةِ الشكلِ، تعتلي أنوفَهم الحمراء، وجوهٌ شمعية، أجسادٌ رشيقة، وبطونٌ ضامرة، تحت صدورٍ عريضة، وعضلاتٍ مفتولة.. طالما كنا نشاهدهم في الأفلامِ ونتعجّبُ من طولهم الفارع، ولونِ البحر في تلك العيون، التي أخفوها بنظاراتٍ كبيرةٍ،ورؤوسٌ تقبعُ عليها خوذٌ مرقّطةٌ،تجعلهم يبدون مثلَ كائنٍ فضائي حطَّ تواً على ترابِ العراق الممزوجِ بالبارود.
حملاتُ مداهماتٍ واسعةٍ، تجتاحُ الأحياءَ السكنيةَ، بحثا عن إرهابيين ومتطرفين…
دباباتٌ و أرتالٌ محمّلةٌ برجالٍ ذواتِ وجوهٍ شمعيةٍ، يصوّبون رشاشاتهم بخوفٍ وفزعٍ إلى المارّة، يشقّون السيرَ وهم ينظرون إلى الأمام، وأسلحتهم مصوّبةٌ نحو السياراتِ وقد يضربون السياراتِ بقناني الماءِ بعنجهيّةٍأمريكية لايمكن أن تُخطئ، ويواصلون شتائمهم بحقِّ كلِّ من يرونه في الشارع، وقد كتبوا على مؤخرات همراتهم “أذا اقتربتَ بمدى 100 م ستكون عرضةً للقتل” وعبارةٌأخرى كُتبتْ بخطٍّ فسفوري يشعُّ في العتمة “منطقة القتل أقل من 100م”
القتل..كلمةٌ صار تداولها أكثرَ من تحيةِ الصباح والمساء..
عبواتٌ مزروعةٌ في الطرقات، شوارعٌ خاليةٌ من هويتها، مدنٌ بأكملها قُلِبتْ رأساً على عقب، جثثٌ تلقى في القمامةِ كل صباح، عصاباتُ خطفٍ وقتل، ملثَّمون مجهولو الهويةِ والانتماء، جثثٌ تلقى في دجلةَجعلتْه يتقيَّأ مياهه..
يبدو أنَّ هناك موضةً جديدة، تسري مثل الحمّى في بلدٍ صار على جرف الانهيار، حتى شاكر والد زوجتي صار يجاري موضةَ العصر الرابحة، عندما أتى لزيارتنا قبل أسبوع، فاجأتني هيأته الجديدة، فقد خلعَ البذلةَ العسكرية التي يلبسها الرفاق، واستبدلها بجبّةٍ وعباءة، وغطّى صلعته اللامعة بكوفيةٍ بيضاء، والتصقتْ سبحةٌ من الكهرب الأصفر في يده اليمنى، فلم تكد تفارقه، وهي تلتفُّحول مركزها مثل أفعى.. كانت يده اليمنى تقّلبُ حبّاتِ الكهرب دون توقّفٍ، ويتمتمُ بكلماتِ شكرٍ واستغفار، كما يفعل الزاهدون، ولاحظتُ خاتماً بفصٍّ أبيضِ اللون في بنصرهِ الأيمن، يومها ضحكتُ حتى أصابني سعالٌ شديد، وغضبَ مني شاكر،ناعتاً إياي بالملحد، فقط لأنَّني سألته عن سببِ تديّنه المفاجئ.
كان مثلَ الحرباءِ يغيّر لونَه حسبَ المحيط ..
أذكرُ أياماً كان الرفيقُ شاكر يافعاً أو أقلَّ هرماً مما هو عليه اليوم، كان يتبخترُ بمشيتِه وسط محلتنا، وأرنبةُ أنفهِ ترتفع بزهوٍ حتى تكاد تلامس السماء، كان يردُّ التحيةَ بإيماءةٍ من رأسه الأصلع، إيماءةٍ متكاسلةٍ متثاقلةٍ على هؤلاء الذين يسوقهم سوءُ الحظِّ، فيلتقون به على قارعة الطريق ذهاباًأو إيابا..وبما أنَّ الواجبَ الوطني يحتِّمُ على كلِّ مواطنٍ شريفٍأن يحترمَ الرفاقَ؛ فكان من الجرمِ على تلكم المساكين أن يشيحوا بوجههم عنه،أو يتماهلوا في تحيتهِ وتبجيلهِ، وعليهم أن يبتلعوا تلك الإيماءةَ الباردةَ التي دفعتها صلعتُهُ اللامعةُ الموقرة إليهم، فهي صلعةُ رفيقٍ حزبي كبيرٍ ناضل أيامَ النضال السلبي والإيجابي،والتركوازي،والمائي، والبرمائي، إلخ… من المسمياتِ الرفاقيةِ الثورية. كان الرفيق شاكر يخدمُ الوطنَوترابَه،ُ ويرهقُ جسده الجاف مثل سمكةِ الزوري في اجتماعاتٍ حزبيةٍ مكثّفة لتوعيةِ الشبابِ لما تحمله الثورة من فكرٍ وهوية، والخائنُ هو من يأبى التلاحمَ مع المناضلين والنضال، ثم إنَّ شاكر يحمل على كاهلِه مسؤوليةً ثقيلةَ الوزن، ذوتْ تحت ثقلِها عظامُهُ وتسطَّحتْ عضلاتُ ذراعيه وساقيه وردفيه، مع أني اذكرُأنَّ ردفيه يابسان منذ الأزل، لا عضلَ ولا شحمَ فيهما,يشبهان مؤخرةَ قردٍ مصابٍ بمجاعةٍ مزمنة,وحين أرى مؤخرةَ الرفيقِ شاكر وهو يسرعُ الخطى أمامي في الطريق أحياناً؛ لا تنفكُّ مؤخرةُ القرد الذاوي ترتسم قبالتي، ثم بكثيرٍ من القرفِ والغثيان يذهب خيالي ليقارنَ بين المؤخرتين، فتبدو لي مؤخرةُ القردِأجملُ من مؤخرةِ الرفيق شاكر؛ كونها غير مغطاةٍ بالشعر.
كانتِ المسؤوليةُ شديدةَ الوطأةِ على والدِ زوجتي المناضل أيامَ نضالهِ في صفوفِ الحزب,فكان يجتهدُ في صنعِ بيئةٍ ملائمةٍ للقادةِ الكبار في الحزب والثورة، ليتمكنوا من متابعةِ نضالهم وتضحياتهم الجمَّة في سبيلِ الوطنِ وأبناءِ الوطن الكسالى,ولأنَّ كلَّ رجلٍ مناضلٍ يكون مثقلاً بالهموم؛ لذا يتحتمُ على الشعبِأن يسعى في مؤاساتهِ وتوفيرِ كلِّ وسائلِ الراحة له,فكان الرفيقُ شاكر على أهبَّةِ الاستعدادِ لخدمةِ القادةِ المناضلين، الذين هدّتْ خدمةُ الوطن أجسامَهم، حتى صارتْ تغلي الدماءُ في عروقهم ليلاً، وتحتقنُأعضائهم التناسلية بمائها الحبيس، وصار من الواجبِأن يعبِّرَ الرفيقُ شاكر ومن حذا حذوه عن حبِّهِ لخدمةِ وطنِه، فكان يأتي بالراقصاتِ والغجرياتِ، وصغيراتِ العاهرات، ممن لم يُستهلكْ جمالُهن َّولحمُهنَّ الأبيض بعد,ثم يشرفُ بنفسهِ على جلساتِ النضال تلك، ولياليها الحمراء الدامية بكلِّ مايمليه عليه الوطن من إخلاص من المساء وحتى انبلاج الفجر الصادق، وبعد أن يتبيَّنَ الخيطُ الأبيضُ من الخيطِ الأسودِ من الفجر بوقتٍ طويل,وحين يطمئنُّ على القادةِ والمناضلين، بعد أن أعياهم الهزُّ الرقصُ وقد انطرحوا مخمورين على الأسرّة في أحضانِ العاهرات، اللواتي كنَّأيضاً يخدمنَ الوطنَ وأبناءَ الوطن حين يفتحنَأفخاذهنَّ ويمكننَّ القادةَ العظامَ من أن يقذفوا في فروجِهنَّ ماءهم العظيم؛ ينسحب عندها الرفيق شاكر، عائداًإلى بيتهِ يعلو الزهوُ صلعتَهُ، ويتلألأ عرقُ الكبرياء على جبهتهِ الضيقة، فقد أمضى ليله ساهراً، يحرس الوطن ويتفانى حدَّ الموتِ في تبجيلِ الثورة والحزب، الذي لو أخبره أحد يوما أنَّ الشمسَ ستشرقُ من مغربها لصدَّقه، على أن يصدقَأنَّ تلك الثورةَ وقيادةَ الثورةِ ستنهارُ بضربةٍ زلزاليةٍ واحدة لا ارتدادَ فيها، عكس قوانين الضرباتِ الزلزاليةِ المتعارفِ عليها,وستأخذ معها – في انهيارها-كلَّ ما كان يتمتعُ به الرفيقُ شاكر من وجاهةٍ وسلطة، ثم تجبره الليالي السوداءُأن يختبئ مثلَ جرذٍ مذعورٍ في منزلِ أحدِأقربائه غربَ بغداد.. منزلٌ من ثلاثةِ طوابق، وسطَ مزرعةٍ وارفةٍ، تزدحم بالنخيلِ وأشجارِ البرتقال والليمونِ والرمان، فمهما حصلَ من هرجٍ ومرج، وحملاتِ مداهماتٍ واعتقالاتٍ من قوات التحالفِ وأفرادِ المقاومةِ في بغداد؛ فإنَّ ما قد يحصلُ في مزرعةٍ نائيةٍ أقلُّ بكثير،أو يكاد يكون لا يذكر,لذا كانتِ المزرعةُ بأسوارها، وأجمتها الخضراء، ونخلاتها الباسقة، مخبئاًآمناً لوالد زوجتي شاكر، الذي وقع عنههالآن لقب الرفيق.. وصار نكرةً مهددةً بالسحقِ تحتَ الأحذيةِ الأمريكية،أو العراقية. ظلَّ في عزلتهِ الريفيةِ هناك يتأملُ ويترقَّبُ, ويقرأالأحداثَ عن بعد، ويحلّلها تحليلاً منطقياً يتيحُ له أن يمسكَأولَ خيطٍمن خيوطِ البكرةِ المتشابكةِ، يمكِّنُهُ من العودةِإلى بغدادَ؛ لمواصلةِ نضالِهِ، وخدمتهِ للوطن.. ولكن حسبما تقتضيه الظروفُالمؤاتية، والحالةُ الجوية، ودرجةُ الحرارة والرطوبة,حينها سيختار الزيَّ المناسبَ للدورِ المناسبِ، ومن ثمإلى ساحةِ النضالِ بطلٌ قياديٌّ جديد، بتاريخٍ نضاليٍّ جديد، تدمع له الأحداقُ، وتسيل له الأنوفُ، ويعظُّ له الناسُ الأصابعَ على شدَّتِهِ وطولهِ وعتمةِ لياليه.
في الريفِ، وفي وسطِ المزرعةِ المتراميةِ الفيحاء، كان الرفيقُ شاكرُ يأخذُ مجلسَهُ مع قريبهِ، صاحبِ المزرعة، تحت ظلالِأغصانِأشجارِ الحمضيّات، وشجرةِ التوتِ العملاقة بأغصانها المتشابكة، حيث تجاهدُأشعةَ الشمس، كي تشقَّ طريقها بين الأوراق والأغصان، وتسقطُ بخيوطٍ حريريةٍ دافئةٍ على العشب الذي يفرشُ الأرضَ تحتها,وتهبَ نسماتٌ رقيقةٌ تداعبُأوراقَالأشجارِ الخضراء، فيعبق عطرُأزهارِ القرنفل والقدّاح، مختلطاً برائحةِ الهواءِ والعشبِ الرطب,كانتِ المقاعدُ البلاستيكية تصطفُّ ويُفرشُ الحصيرُ على العشبِ، حيث يحتشد عليهما الأصدقاءُ، والشيوخُ، والوجهاءُ في مزرعةِ حسّان قريب شاكر,حسان رجلٌذو وجاهةٍ وغنى، وعلاقاتٍ متداخلةٍ مخيفة، مثل أذرعِالأخطبوط, وجههُ القرمزي الممتلئ ،ولحيته البيضاء كالقطنِ النظيفِ المنفوش، وتلك الطاقية البيضاء التي يضعها فوق رأسه المدوّر؛ يعطيك انطباع بالراحة والاسترخاء المزيفين حين تنظر إليه لأول مرة , لكنك إن أمعنت النظر جيدا في وسط عينيه الضيقتين، اللتين احمرَّ بياضهما دونما مرضٍ،أو تحسس، ستجد أنَّ الرعبَ والشكَّ يزحفُ نحو روحك، فتلكما العينان لا تعرفان الرحمة، ولا يمتّان لعيونِ بني البشر بصلةِ قرابة،إلا في شكلهما الظاهري، لكن ما ينبعث منهما من خبثٍ ومكر؛ تجعلانهما عينين شيطانيتين – إذا صح التعبير- رغم أنَّ لا أحداً منا أبصرَ الشيطان،أو عينيه يوما,لكننا مجازاً نشعر بخسّةِ النظرةِ الشيطانيةِإن نظرنا في عينين مثل عيني حسان.
(26)
في جلساتِ السمرِ تلك، التي يختلط فيها دخانُ السجائر بعطرِأزهارِ القرنفل، وسط المزرعةِ وطقطقةِ(استكانات) الشاي المتلاحقة،كانت الأحاديثُ تزدحمُ حول النهضةِ الجديدة للبلد، وعنِالمناضلين الجدد، الذين وصلوا تواً إلى أرض الوطنِ لخدمةِ ترابهِ المقدّس، وأحياناً كان حسان يستقبل في مزرعتهِ ضيفاًأو ضيفين، وربما ثلاثةً من المناضلين الجدد، رفيعي المستوى، فتتلاحمُ الأيادي، وتسخنُ الضمائرَ، وتشحذ الهمم من أجلِإيجادِ حلولٍ سريعةٍ تنقذ البلدَ من سقوطهِ في الهاوية, حصل الرفيق شاكر على ثقةِ أحدِ المناضلين في تلك الموجةِ الهوجاءِ الجديدة، فأعجبتْ ذلك المناضل، صفةُ الورعِ والتقوى التي بدتْ على هيأةِ شاكر بعد الاحتلال,وهو متسربلٌ بالرداءِ الأبيض الناصع، والعباءةِ البنّية المعطّرة بالمسك، التي وضعها بهيبة على كتفيه العظميتين اليابستين,وتلك الدائرةُ الصغيرةُ السوداءُ التي حطَّتْ رحالها وسط جبهتهِ تشي بطولِ سجودهِ، والتصاقِ جبهتهِ بالأرضِوبليالي تهجّدهِ وعبادته.
كانت دموعُ زوجتي سلمى ترهقني، وبكاؤها على والدها، يقلب البيتَإلى مقبرةٍيعلوها العويلُ على الموتى، وفراقِ الأحبة, لذا كنتُ أحملُ نفسي وزوجتي مكرهاً، رغم سوءِ الوضع الأمني والاشتباكات هنا وهناك، وأذهب بها حيث المزرعة البعيدة، فنمكثُ هناك ليلةًأو ليلتين، تقضيها سلمى في الحديث مع أبيهاوأقاربها، وأقضيها أنا في التسكّع بين الحقولِ والمزارعِ وأشجارِ التوت,كان يدعوني والدُ زوجتي للجلوسِ معه حين يستقبل الحاج حسان رجالاً رفيعي المستوى ومجهولي التاريخ النضالي,رجالاًببذلاتٍ لامعةٍ، وذقونٍ حليقة، ورجالاًآخرين بذقونٍ طويلةٍ ومسبحاتٍأطول, وآخرين يرتدون لباسَ الشيوخِ وعباءاتهم مع الكوفية البيضاء والعقال,كان المتوافدون على مزرعةِ الحاج حسان من كلِّ نوعٍ، وكلِّ زي، يبدون مختلفين في المظهر واللكنة، لكن هناك ما يجمعهم ولا ريب, كنتُ أستجيبُ لشاكر أحياناً، وأجلس لدقائقَ أحتسي الشاي، وأدخّن، وأستمع لما يقولون, وأستطيعُأن أجزمَأنَّ من يسمعُ لذلك الحديثِ؛ سيرى الجنائن المعلقة قد بُنيتْ من جديد في كل زقاق, وأنَّ فرجَ اللهِ لآتٍ على يد هؤلاء، لكن جرّبْ فقط أن تنظرَ في عمقِ عيونهم، وستفهم أنَّ الغرقَ هو الآتي، وليس الفرج,لذا كنتُ أنسحبُ مسرعاً من تلك الجلساتِ الوطنية جداً، وأطلقُ ساقي للريحِ بين المزارع، مستنشقاً الهواءَ النقي الذي يحمل معه رائحةَ العشبِ الرطبِ، وخبزِ تنورِ الحطب,وحين ترتوي زوجتي سلمى من رؤيةِأبيها؛ نعود إلى بغداد، حيث نقطع الطريق إليها بزمنٍ مضاعفٍ بسببِ الأرتال الأمريكية التي تُوقفُ السيرَ،وتقوم بعملياتِ تفتيشِ الركّاب، رجالاً ونساءً، من الرأسِإلى القدم.
(27)
كنتُ أعتقدُأنَّ جميعَ الناسِ تمتدُّأصولهم إلى (آدم) حسب النظريةِ الدينية،أوإلىأجدادهم القرود،أو أحدِ الكائنات أحادية الخلية،التي تطوّرتْ شيئاً، فشيئاً،حسب نظريةِ التطور ل “دارون” ولم أكنْ أعلم أنهم مقسّمون إلى أنواع،ولهم أصولٌ أخرى.
لكن ما حدث بعد احتلالِ بغداد،أو تحريرها، قُسِّمَ لنا الناسُ إلى فصائلٍ بشريةٍجديدة.
شيعةٌ وسنةٌ على أنواعٍ متعددة، ثم فصائل الدين النصراني بأنواعها، والصابئة والإيزيديون، وكثيرٌ من المعتقداتِ الأخرى، التي يتحددُ من خلالها نوعُ الفصيلِ البشري.
ثم اصطفَّ الناسُ كلّاً حسب فصيلته، فأصبح لدينا خمس.. سبع..أو ثمانيعشرةفصيلة، بدل شعب واحد، ثم بدأتْ تلك الفصائلُ بالتناحر فيما بينها، فصار هلالُ العيدِ يظهر في أيامٍ عدة، وينقسمُ عيدُ الفطرِ والأضحى إلى عيدين أو ثلاثة، حسب الطوائف والمعتقدات.
ولم أكنقد تنبّأتُ مسبقاً بموسمِ التناحر هذا، لذا وقعتُ في الفخِّ حين أسميتُ ابني البكر عليا.
لأنَّ القتلَالآنأصبح حقاً مشروعاً بين الفصائل..
وكل ذلك القتلُقد اكتسبَالشرعيةَ بصرخةِالله أكبر…قتلٌ مباحٌ ليس بالضرورةِ أن تمتلك دافعاً دينيا.. قد يكون الدافع الكره، الغيرة، السرقة، الانتقام للشرف، القتل للقتل فقط…لن يسألك أحدٌ لمَ قتلتَ؟ إنه جنونُ القتل، جثثٌ مكدّسة..والمدافنُلم تعد تتسع.
أذكر في ليلةٍ من الليالي، كنتُ عائداً من عملي، فأوقفتني إحدى نقاطِ التفتيش المنتشرة في مداخلِالأحياءِ والأزقّة البغدادية.خمسةُ رجالٍ ملثّمون يحملون سلاحاً ويرتدون السواد،
ولم يكن بمقدوري التفريقَ،إن كانت نقطةُ التفتيشِ تلك وهميةً من متطرفين،أمنقطةٌحقيقةٌ،أفرادها من الشرطة أو الجيش؟.
لكنني مجبرٌ على التوقّفِ وإطفاءِ محرّكِ السيارةِ والإجابةِ عن أسئلتهم. كان السلاحُ موجَّهاًإلى صدري، حين سألني أحدهم ما اسمك؟
في تلك اللحظةِ تحشرجَالكلامُفي حنجرتي، واحترتُ بالإجابة.. فإن قلتُأنَّ اسمي حسين، قد أُقتلُ على يدِ الفصيلة المخالفة، وإن قلتُأن اسمي عمر، سأقتلُ على يدِ النوع الأول.
فالقتل هنا هو للقتل فقط، إن كنتُ علياًأو حسيناً.. وإن كنتُ عثمانَأو عمر، وحتى إن كنتَتُدعى جورج،أو زياد،أو حتى سرمد؛ يمكنهم قتلك ورميك على قارعة الطريق، لتأكلك الكلابُ دون أن تفهمَ سببَ قتلك.
ليلتها قبل أن أنطقَ باسمي، وأبرز لهم هويّتي، رددتُ الشهادة في سرِّي، واستسلمتُ للموت، لكنِ الرجلُ الملثّمُ نظرَ في هويتي ثم رفع بصره، وأطال النظرَ في وجهي، بعدهاأشار لي بحركةِمن رأسهِ دون أن يتكلم، وأمرني بالتحرّكِ والذهابِ فورا.
أعتقد أنني نجوتُ من الموتِ تلك الليلة لانَّ الرجلَ لم يكن له مزاجٌ في القتلِ،أو ربما كان متّخماً حدَّ التقيؤ من جثثِ النهار التي تكدّستْ على قارعةِ الطريق.
(28)
سكبتْ لي الشايَ الساخنَ، في الكوبِ الخزفي، الموضوعُ أمامي على طاولة المطبخ، ثم جلستْ قبالتي تنظر إليَّ كمن يريد أن يلقي بقنبلةٍ، أو رمانةٍ يدوية.
كان وجهها ذابلاً، وزرقةٌ باهتةٌ تحيطُ بعينيها الوديعتين، يبدو شكلها كمن قضى ليلتهمُسهدا.
بادرتها أنا بالحديث، لأخففَ من وطأةِ الكآبة التي حلّت بيننا:
– ما بك سلمى؟ تبدين متعبة، هل أزعجتك كوابيسي المتكررة، وصراخي الذي يخترق سكون الليل؟ لا تنكري وتكلمي مباشرة، هل تحبّين أن أذهبَ للنومِ في غرفةِ أمي – رحمها الله – كي تستريحي في نومك؟
– وهل تعتقد يا حسين أنَّ ما يتعبني هو قلة النوم، أم هو خوفي عليك مما أنت فيه.
ألا يوجد حلٌّ لحالك يا حسين، فأنت لم ترَ نفسك كيف ترتعش مفزوعاً بين يدي كابوسك المتكرر،وسجّانك، وأنتَ تصرخُ باسمهِ في العتمة، حتى الأولاد باتوا يسألونني عن كوابيسك تلك! وقد صارحني ابنك علي برغبتهِ الملحّة في علاجك عند طبيب نفسي.. فما رأيك يا أبا علي ؟
(وكأنَّ سلمى صفعتني بيد ابني علي )
– سلمى أرجوك، انسي أمري، أنت وعلي، سأحلُّ المشكلةَ هذه الليلة، فغرفةُ نومِ والدتي تنتظر من يدفئ فراشها البارد.
_كلا …لن أوافق على أن تترك سريرك …وقد أخبرتك أن قلبي يضيق كلما شاهدتك على هذه الحال ..أما كوابيسك تلك فقد أصبحت موسيقاي المفضلة التي أستمع لها كل ليلة
– حسنا إذاً..سأتكلم مع وحشِ الزنزانةِ أن يعزفَ لنا أغنيةً لأمِّ كلثوم هذه الليلة حين يزورني في كابوسي..قولي سيدتي ماذا تريدين أن تسمعي لستِّ الكل؟
***********
مسكينة سلمى,فقد كانت تحتملُ معي عذابي، وتتقاسمه مثلَ رغيفِ الخبز,كانتْ تنظرُإليَّ وتبتسم،وعيناها تنطقُ بخوفٍ وقلقٍ لم تقوَ على مداراته. هناك حاجزٌ غير مرئي، يقف شامخاً بيني وبين زوجتي,حاجزٌ بوجهين,مثل جدارٍ بوجهين ملونين بألوانٍ متنافرة, في صفحةِالجدار قبالتي، كانتْ عينان خضراوان واسعتان مرسومتان تحدقان بي طيلة الوقت, تراقباني, تخلعان قلبي,تقفان بين التحام قلبي، وقلب زوجتي,أما واجهةُ الجدارِ التي قبالة سلمى، فقد كانت مطليةً باللونِ الرمادي، أو ربما لا لونَ فيها,حاجزٌ غامضٌ- حسبما تراه سلمى – دون أن تنطقَ، أو تشكو منه يوما, لكن عيناها كانت تشي بها,تنظر لي بحيرة، وكأنها تعاتبني على سرِّ الجدار الذي تجهله، ولا تجرؤ على البوح به، أو سؤالي عنه, كان فمُها مُطبقاً بشدةٍ وبمرارة، على خيبةٍلا تريدُ الخوضَ فيها,لم أخبرْ سلمى يوماً عن جرحي الغائر، وعن العينين الخضراوين اللتان لا تفارقان قلبي وروحي، حتى صارتا جداراً صلداً لا تطاله الندوب,ولذا كنا نكتمُ صراخنا الداخلي حين نجلسُ منفردين أنا وزوجتي,لا أحدَ مِنَّا يريدُ تحطيمَ الجدارَ بمعاولِ الأسئلة,لا أحدَ مِنَّا كان يمتلك الشجاعةَ للنزولِ إلى منجمٍ مظلمٍ باردٍ مليءٍ بالأفاعي، مغلقٌ منذ عقود طويلة,أو ربما منذ أن التحمَتْأجسامُنا كزوجين.
(29)
عاد الحاج شاكر الزاهد إلى بغداد، بعد أن صار محصَّنًا، وله صوانٌ وصولجان,وحاشيةٌ مدججةٌ بالسلاح، والفرسان تشع بالهيبة والإيمان.
انتقلَ من حيِّنا الشعبي، وسكن قصراً في أحدِ أحياءِ بغداد الراقية على ضفافِدجلة، يتعبّدُ فيه، ويخدمُ فيه الوطنَ من جديد،ووضعَ رجُلين أمام قصرهِ يسهران على حراسته ليلَ نهار، وتقفُفي باحةِ قصرهِ الطويلةِ الواسعة، سيارتان مظلّلتان مخيفتا الشكل.كانتا تحت تصرفهِ، هما وسائقاها.
وحتى أنا – زوج ابنته – لم يكن بمقدوري الدخولَ عليه دون أن أحجزَ موعداً عبر الهاتف مع مديرِأعمالهِ الحاج عبد الصبور, وكما كان يخبرني عبد الصبور:أنَّ الحاج شاكر، منهمكاً طيلةَ الوقتِ في اجتماعاتِ وورشِ عملٍ لبناءِ وترميمِ الخرابِالذي خلفه الاحتلال بعد عام 2003 . فكان قصرُه المنيفُ الذي يعسكر أمام بوابته الحراس ببنادقهم خوفاً على سلامةِ المناضل شاكر،يعجُّ بالضيوفِ كلَّ مساء,أناسٌ من أصحابِ المقامِ الرفيعِ، والكروشِ المتدليةِ فوق البنطلونات المكوية ببراعة، والذقونِ المحددةِ بأناملٍ حلاقٍ مبدعٍ تمكّن من تحديدها دون المساسِ بمظهرها المهيب.
كان شاكر يناضلُ ويجاهدُ ويخدمُ الفقراءَ بعقدِ صفقات، يكون هو الوسيط فيها,صفقاتٌ لبناءِ وحداتٍ سكنية، ومدارس, ومستشفياتٍ يلجأإليها المتضررون من الحرائق والقذائف,المشوهون والمرضى بعللٍ تفطّرُ القلب,صفقاتٌ لاستيرادِأدويةٍ لمن تعطّلَ عنده البنكرياس،أو الكُلية،أو الجهازُ التناسلي، وتدلّى عنده القضيبُ مثل خرقةٍ لمسحِ الأحذية، وهذا عينه ما كان يؤلمُ قلبَ شاكر والد زوجتي,فلا بدَّ للمناضلين ولأبناءِ الشعبِ أن يكونوا منتصبين تتأجّجُ منهم الرغبةُ وتطفحُ من بنطلوناتهم الرجولة، كي يتمكنوا من النهوضِ بوطنٍ مترمّلٍ منهارٍ جاثٍ على ركبتيه، ينعى تاريخاً مخضرماً من الرجالِ في عصرِ الفرسان، ما بين النهرين، في أرض السواد.
كانتْ عظامُ الناسِ قد هُرسَتْ تحت القذائفِوالدبابات, والأورامُ السرطانية هبّتْ في وجهنا مثلَ وحشٍ استفاقَفاتحاًفمه ليلتهمَ الأجسام الصغيرةَ والكبيرةَ على السواء,وحشٌ تغذّى على اليورانيوم المنضّب، الذي رُشقَتْ به بغداد يوم حربِ الخليج الدامية.
أعتقدُأن هذا الأصلعَيجيدُ اتباعَ الموضة، وأظنُّ لو أنه عاشَلسنواتٍأخرى، في ظلِّ حكمٍ جديد، لكان أوّلّ من ارتدى لباسَموضةِ الحزبِالجديد،حتى لوكان لباسَ بحرٍ من قطعتين.
ولو اقتضى الأمرُ لحلقَ شعرَ ساقيه، ولمَّعَهما، ليكونَ بمظهرٍ شهي، وهو يرتدي لباسَ البحر ذاك.
كان شاكرُيفتخرُ بحفظهِ لأسماءِ الله الحسنى التسعة والتسعين،وبصلاةِ الليلِ التي عرفها متأخراً، ويدَّعي أنه يواظبُ عليها كل ليلة.ويزدري من لا يقوم الليلَ ويتشدّقُ متفاخراً بعملِه ذاك، فتذكرتُ حينها، وأنا أستمعُ إلى حديثهِ هذا قصةَ الشيطان الذي خرجَ من الجنة بغضبٍ من الرب، ولعنةٌ دائمة تطارده، وكل ذلك لم يكن لقلةِ عبادته، فالشيطان كان يُسمّى “عزازيل” وهو من الجِنِّ العابدين، الساجدين، الحامدين، المسبحين، لكن لعنةُ اللهِ طالته؛ لمعصيته لأمر الله، لغرورهِ وازدرائه لتنصيبِ غيره من غير جنسه، وشعورِه بالأفضليةِ والتميزِ عنهم.
كان الرجلُ بهلواناًماكرا..يفهم جيداً من أين تؤكل الكتف.ثم على أيّةِ حال، كان الرجلُ يخدمُ الوطنَ، حتى لو كانت نتائجُ ذلك النضال مخزونةً في البنوك السويسرية، بأرقامٍ سريةٍ تؤمِّنُ له مايحتاج،إن قرّرَ يوماًأن يعتزلَ النضال،أو يعتزلَ الوطن.
********
عشرُ سنواتٍ مرّتْ على احتلالِ بغداد..
ونحن مثل ثيرانٍ هائجةٍ في سباقِمصارعةِ الثيران. أصبحنا مقسّمين إلى ثلاثِ مجموعات: مجموعةٌ رداؤها بلا لون, شفافٌ تماماً، تظهر من خلاله عوراتهم، فهم لصوصٌ لا يشعرون بانتماءٍ للوطن على أيّةِ حال.
والثانية تتقاسمُ الكوابيس والأحلامَ الوردية، ليلها الطويل الذي تمتدُّ أذيالُهُ لتغلّفَ ضوءَ النهار الخجل، فيبدو الصباحُ رمادياً، يصلح لكوابيسِ الليلِ الفاردِ أجنحته مثل كائنٍ عملاق، بجناحين ثقيلتين من الرصاص.
لا صباحَ في وطنٍ تطفح فيه البالوعات مع أول هطولٍ لغيمات سمائه الحبلى بماء الموت الأسود.
فكيف لشفاهِ الوردِ أن تبتسمَ، وهي تحملُ نعشَ الأحلامَ، وتصلّي عليه صلاةً بلا سجود، عند كل فجر وزوال؟
واليتمُ يتقاطرُ على الوجناتِ الشاحبةِ،مُزيحاً بكلِّ وقاحةٍ، قطراتِ الندى.
أما ما تبقى منا..فهم هؤلاء الهائمون على وجوهِهم يلتحفون السماءَ، ويفترشون ترابَ
الشوارع. المعدمون والأيتام والأرامل..تغصُّ بهم الأزقةُ والساحات، يتقافزون بين إشارات المرورِ، يستجدون ويلعنون اليوم الذي ولدوا فيه.وبعضٌ منهم ممن جفَّ جلدُه وشاخَ عظمُهُ،ووصل إلى أرذلِ العمرِولم يعد يقوى على التنقّلِ في الشوارع، راح يفترشُ الأرضَ، ممدداً على فراشٍ قذرٍ، ملتحفاً بما تبقى من غطائه الممزق، وهو يرصدُ المارة بعينين فيهما ذلُّ الحاجة، وازدراءُالذات.وكل ما يحصلُ عليه هو ثلاثُ وجباتٍ يومية من أصحابِ الدكاكين القريبةِ من بقعتهِ التي يفترشها،أو من بعضِ المارّة طيّبي القلبَ، كرماءَ اليد.
سنوات صيفها يزدادُ سعيراً وجفافاً، وشتاؤها تغرقنا أمطاره، فنعومُ في الشوارعِ مثل سفينةِ نوح في الطوفان.
فوضى عارمة، والسيادةُ لقانونِ العشائر، والعصابات المسلحة.تحوّلت المدنُ إلى قرى، والقرى إلى أراضٍ جرداء مخيفة.حتى الذائقةُ العامةُ للناسِ تدنَّتْ، وصار الهابطُ والتافه هو السائد.
لكن من الغرائبِ والمفارقاتِ أنَّ الملاهي الليلة، ازدهرتْ وتكاثرتْ أكثر من ذي قبل، وعاهراتها، كلُّ واحدةٍ منهنّ لها سلطة قائمةٌ بذاتها، فلو جرَّبتَ أن تتشاجرَ مع إحداهنَّ–مثلا – ستجدها قد رفعتْ هاتفها، وتكلَّمتْ مع فلان، وبلمحِ البصرِ؛ سترى عدداً من القواتِ، بمركباتٍزجاجها معتم، وسرعتها مخيفة،هبطتْ عليك من السماء، ورمتْ بك إلى ما وراء الشمس،لأنَّك أزعجتَ سيادةَ العاهرة المقدسة.
بينما قد تستيقظُ ذات صباح، لتسمعَ أنَّ جثةً لشابٍ وجدتْ مرميةً على قارعةِ الطريق، معصوبُ العينين، منزوعُ الأظافر، تبدو عليه آثارُ تعذيبٍ وحشية، وحين تسأل عن سببِ قتله، تأتيك الكلماتُ متخفيةً خلف صمتٍ مريب، إنَّ هذا الشابَّ كان فاسقاً، عاصياً، لا دين له،لأنَّه قد أطالَ شعره، وربطه كذيلِ حصان، متشبّهاً بالنساء، وفوق هذا فإنَّ ألوانَ قمصانهِ كانتْ زاهية، كأنه فتاة، وهذا يجلبُ العارَ ويضلُّ البلادَ والعباد، ويمنع غيثَ السماءِ، وكان لا بدَّ من نحرِ رقبته، ورميهِ كالكلاب، طاعةً لله ورسوله.
أصبحنا ننزلقُ نحو الهاوية بسرعةٍ ضوئيةٍ عجيبة.
ولم نعد نعلم، هل نحن أحياءٌ، أم أموات! مهرجون، أم دمى محشوة بالقطنِ،معلقةٌأطرافها بخيوطٍ واهية.
تتداخلُ الحياةَ بعضها مع بعض، كالضفيرة،
وكلُّ شيء فيها هو جزءٌ من شيءٍ آخر.
“أوشو”
(30)
شتاء 2014م
(لعينيك..لون العشب الطري..بعد ليلة ماطرة)
إنه أولُ يومٍ لي في الوظيفة، بعد تخرّجي من كليةِ الهندسةِ، قسمُ العمارة، بتفوّقٍ، ومعدلٍ كبير، فحصلتُ على وظيفةِ معيدٍ في قسمِ العمارة نفسه، كان صباحاً بارداً، لكنَّ السماءَكانتْصافية، ترصَّعُ وجهَها بعضُالغيمات البيضاء المتناثرة مثل ندفٍ من القطن.
دخلتُ قاعةَ المحاضراتِ ووضعتُ أوراقي على المنضدة، وحاولتُ أن أبدو بمظهرِ الأستاذ المتمرسِ قدرَ استطاعتي، وقد أعطتني بذلتي السوداء، وأناقتي التي بالغتُ فيها، بعضاً من الثقةِ والراحة، وأنا أبدأ يومي الأول هذا.
كان أمامي حشدٌ من الطلبةِ والطالبات، يصطفّون في خطوطٍ أفقية، فوق مقاعدهم..ألقيتُ نظرةً فاحصةً، ثم خرجَ صوتي قويّاً مرحا:
صباح الخير..أعرفكم بنفسي، أنا الأستاذُ علي حسين، معيدٌ في قسمِ العمارة، سأشغلُ مكانَ الأستاذِ رمضان، الذي أنهوا خدماتَه بعد هجرتهِ خارج العراق، وسأحاول أن أكملَ معكم ما فاتكم من المحاضراتِ في غيابه.
كنتُ مبتسماً، بسيطاً، وقد بادلوني التحيةَ بمرحٍ كبير، وراحةٍ أكبر، أعتقدُ أنَّ أعمارنا المتقاربة، كانت سبباً في هذه الألفةِ التي تكوَّنتْ بيننا منذ اليوم الأول.
انتبهتُ إلى عددِ الطالبات، كان عددهنَّ قليلاً جداً، قياساً بالطلبةِ الذكور، وفي الصفِّ الأولِ كانت تجلس طالبتان مميزتان جداً، ورغم أنَّ الشمسَ كانت تدخلُ قاعةَ المحاضراتِ من جميعِ النوافذِ، وتضيء المكانَ، وتنشرُ فيه الدفء؛ إلا أنها لم تستطعْ أن تخفي النورَ الساطعَ لطالبتي كانتا تجلسان لصقَ بعضهما،تتهامسان بصوتٍ خافت، وتضحكان خلسة.
أحداهما كان لها شعرٌ أحمر نحاسي،وبشرةٌ بيضاء، يطرّز خديَّها بعضُ النمش، وتطوّقُ عنقها سلسلةً ذهبية، تحملُ في وسطها صليباً ذهبيا.
أما رفيقتها، فقد كانت تبدو مثلَ نجمةٍ هاربةٍ من عتمةِ الليلِ، جلستْ في وضحِ النهارِ أمامي،تتلألأ بوجهٍ ملائكيٍّ ناصعِ البياض، تزيّنه عينان خضراوان، تشبهان بخضرتهما، حجرَ الزمرّد النقي.
لم أرَ في حياتي وجهاً مثل وجهها! كان شعرهُا الكثيفُ حالكَ السواد، يغطّي كتفيها، وينسدلُ حتى خصرها الأهيف، لم يكن جمالُها فقط هو مالفتْانتباهي، ولا الصليبُ المعلقُ في رقبةِ رفيقتها، ذات الشعرِ الأحمر، لكن نظراتها التي تتجه نحوي، والتي لم تتركْني لحظةً واحدةً طيلة وجودي في القاعة..
عيناها كانت تخبرني بشيءٍ ما..شيءٍ يشبه ضوءَ شمعةٍ خفيف، في نهاية طريقٍ معتم.. شيءٍ له رائحةُ الترابِ المبللِ بعد يومٍ ممطر…
(31)
يبدو أن الأرقَ رفيقي هذه الليلة، فمنذ ساعةٍ وأنا أتقلَّبُ في فراشي، دون أن يقتربَ النعاسُ من جفني..لا أعتقدُ أنني على طبيعتي هذه الليلة، فأفكاري مشوشةٌ وتلك العينان لا تفارقان مخيَّلتي
ماهذا العبث ؟!
كيف أنجرُّ لمشاعرِ المراهقة، وأنا في العقد الثالث من عمري ! أمِنْ أجلِعينين خضراوين يجافي النوم مضجعي!
لكنها تربكني، وسؤالٌ يلحُّ في رأسي.. لِمَلَمْ تكنْ تعلق صليباً في رقبتها كرفيقتها، فشكلها وبياضها المرمري؛ يرجِّحُ أنها من الديانةِ المسيحية، مثل رفيقتها حمراء الشعر.. ثم ما سرُّ نظراتها تلك، فعيناها كانتا تتبعاني، وتحصي علي سكناتي وحركاتي طيلةَ الوقت.
أزعجتني أفكاري، فخرجتُ من غرفتي، واتجهتُ نحو غرفةِ الجلوسِ، حيث كان أبي يسهرمع قدحِ الشاي، وعلبةِ سجائره المرافقة له دوما. شاهدته مسترخياً مغمضَ العينين، يستمعُ لأغنيةٍ كل ليلة، أغنيةٍ عراقيةٍ لمطربٍجنوبي،صوتُهُ شجيٌّ مثل ناي..كان والدي يرددُ معه بصوتٍ يشبه الهمس:
“بس حبك قدري المكتوب ..المكتوب… تدريشكد حملني ذنوب.. ذنوب”
– آه يا أبي.. ما قصتك وهذه الكلمات! ألا تملُّمن سماعِها كل ليلة؟
التفتَ أبي ناحيتي، ثم قهقهَ بضحكةٍ قصيرةٍ ومقتضبة ومستعارة,فتلك العينان المجهدتان,عينا أبي اللتان عرفتهما، هكذا مذ أن رأيتُ النورَ أوّلَ مرةٍ في حياتي، لم يكن باستطاعتهما الفرحَ,فكان يزيّفُ الضحكَ والسعادة، ويستعيرُ الطمأنينة، ثم يغلّفُ بها محياهُ، مثل قناعٍ شفّافٍ يفضحُ دواخلهِ المشتعلة، ومُعتركَهُ مع الحياة.
– أهلا يا بني، أرى أنَّ النومَ جافاك هذه الليلة، تعال واجلسْ بجانبي.
– بالفعل يا أبي، لا أدري ما الذي يقلقني، قد يكون صوتُ الريحِ في الخارج، فهي تدوي بصوتٍ مزعج، ولا يمكنني النومَ بصحبةِ هذا القلق.
– لكنّها كانت تدوي بصوتٍ أقوى في الليلة الماضية، وقد نمتَ ملءَ جفنيك يا ولد.
وكالعادةِ أردفَ أبي كلامَه بتلك الضحكةِ المستعارةِ،ثم سألني:
– كيف كان يومك الأول في التدريس؟ حمامة، أم غراب
– بل صقرٌ شامخٌ يا أبا علي، كان يوماً رائعاً يا أبي.
– الحمد لله.. نجاحك يا علي، يزيح كلَّ تعبِ السنين عن كاهلي..
سأذهب لأنّامَ يا بني، قد تأخّر الوقتُ.. تصبح بخير.
– تصبح بخير يا أبي…
لا تنساني بالدعاء، عند استيقاظك لصلاةِ الفجر.
لاحقتْ عيناي والدي، وهو يتجهُ صوبَ الرواقِ المنخفضِ الإضاءة، متجهاً نحو غرفةِ نومه، تأمّلتُ ساقه النحيلةَ المعاقة، وكتفيه المحدَودبتين، كأنَّ عقوداً كاملةً تتكئ بكل ثقلها على ظهره، حتى انحنى..أشعرُ أنَّ هذا الرجلَ يحمل تأريخاً كاملاً فوق كتفيه..تاريخاً لم أكنْ موجوداً فيه،وحتى أبي لم يعشْسوى جزءٍ منه، عهوداً لم أتعرّفْ عليها، سوى من الكتبِ وانحناءِ ظهرِ أبي، ودخانِ سجائره، عهداً ملكيّاً، انقلاباً عسكريا، إبادةً للعائلةِ المالكة، حكمَ العسكر، تبرعمَ نبتةِالانقلاباتِ العسكرية، رجالاً ببذلات عسكرية، يتولَّون الحكمَ؛ ثم يقتلهم رجالٌ آخرون، ببذلاتٍعسكريةٍ أيضاً، يتنازعُ الجميعُ على دفَّةِ الربّان.. حكمٌ جمهوري، ثم ديكتاتوري، سجونٌ تمتلئ، ثم تُجهَضُ، جثثٌ مجهولةُ الهوية، حربٌ، ثم حربٌ، ثم سقوطٌ، ثم خراب..كلُّ ذلك كنتُ أتحسسُ ثقلَ وزنهِ على كتفيّ أبي المحدودبتين، حتى اختفى ذلك الرجلُ اليافعُ، منتصبُ القامة، فارعُالطول، الذي أشاهده في الصور، نظرتُ لصورةِأبي المعلَّقةِ على جدارِ غرفةِ الجلوس، رجلٌ طويلٌ، منتصبُ الكتفين، يرتدي بذلةً، تنسابُ بأناقةٍ على قدِّهِ الرشيق، رغم نحافةِ ساقهِ المعاقة، الظاهرةِ من خلف قماشِ بنطاله السميك.
نظراتُه يملؤها العناد، تشعُّ من عينين واسعتين،بلونٍ عسلي براق..كانت صورةُ عرسهما؛ تظهر أمي بجانبه، تمسكُ بذراعهِ، مرتديةً فستانَ زفافها الطويل، وهي تبتسمُ بخجل،وضفيرتها الشقراء، تتدلَّى على كتفها الصغيرة.
فكرتُ.. كم يحملُ أبي من الهموم،حتى صار كأنه جد، ذلك الشاب في صورة عرسه..
كنت أشعرُ دوما أنَّ هناك شيئاً ناقصاً في علاقةِ أبي وأمي، شيئاً لم أستطعْ أن أقبضَ عليه، لكنني متأكدٌ من وجوده، كان شيءٌ يُشبهُ غيابَ الطعمِ اللاذعِ من الطعام، وكأنك تقضي حياتك تتناول طعاماً باهتاً، باردا.. لا نشوةً فيه.
تلك النشوةُ التي يبعثها فينا تذوّقُ الطعمِ اللاذع، حين تشعرُ أنَّ حرارةً تنبعثُ من جوفك، وتتدفقُ في وجهك، وأوصالك تمدُّك بالطاقةِ، والنشاطِ، والجنون.. كان هذا ما تفتقرُ له علاقتهما..
كانا لا يشتعلان.. كانا منطفئين؛ بل كانا رماداًفوقَ جمرٍ بارد.
أشعر أحياناًأنَّ في داخل أبي جزءٌ ميتٌ,لا بل أجزاءٌ، قد ماتتِالواحدُ تلو الآخر، بتسلسلٍ رقمي منضبط ,إنها تتسع,تحتلُّ روحَأبي بالكامل،أو أقل بقليل,فحين أتأمَّلُ ظهرَهُ المحدودب، وتجاعيدَ وجههِ، التي تغرقُ في أخاديدها الدموعُ خفيةً؛ يتملّكني أحساسٌ أنَّ موتاً قديماً يحتلُّ روحَ والدي,موتاً مُعتَّقاً، كلما تعاقبتْ عليه السنون؛ تضوعُ منه رائحةُ الكبرياء. يذكرني موتُه بالنبيذِ المعتَّق، رغم أنني لم أذقْ يوماً طعمَ النبيذ، لكنني سمعتُأنَّ النبيذَ المختنقَ في قنانيهِ الزجاجية المغلقة لعشراتِ الأعوام؛ يطلقون عليه اسمَ النبيذ المعتق، وهو أجودُ، وأغلى أنواعِ النبيذ.
ياترى، ماالذي خسره أبي، ليموت هكذا بالتجزئة!
في مرّاتٍ كثيرة، أُصابُ بالهلع، حين أفكرُ باليوم الذي سيموت فيه آخرُ برعمٍ أخضر في شجرةِ روحِ والدي الجافة,يُخيّلُإليَّإن مات والدي؛ سيموتُآخرُ رجلٍ يحملُ طائرَ الحرية بين أضلعه,قد يرحلُ برحيلهِآخرُ رجلٍ نطقَ بكلمةِ ” لا” قبالةَ زبانية الجحيم,آخرُالأحرارِ في زمنِ العبيد، والمتملقين، لاعقي الأحذية والأقدام.
دخلَ والدي غرفتَهُ، لينامَ وبقيتُ وحيداً، أسترجعُ في مخيّلتي أحداثَ الصباح، وصوتُ الريحِ يدوّي في الخارج،وصريرٌ مزعجٌ يُسمَعُ من الأبواب الخشبية، والنوافذ التي تضربها الرياح الغاضبة. نظرتُ إلى الساعةِ المصلوبة على الجدار، فوجدتُها قد شارفتِ الثانيةَ بعد منتصف الليل.
دخلتُ غرفتي، ووضعتُ وسادةً على رأسي، وغرقتُ تحتها في ظلمةٍ عميقة,علَّي أطردُ تلك العينين العشبيّتين الملتصقتين في مخيلتي.
(32)
ستونَ يوماً عددتها على أصابعي، وكل صباحٍ فيها تتأخرُ الشمسُ فيهبالشروق، حتى أرى وجهها، وهي تجلسُقبالتي – كشأنها كل يوم – في الصفِّ الأولِمن صفوفِ المقاعد الأفقية, عندها أشعرُ أنَّ الصباحَ قد بدأ، وخرجتِ الشمسُ من مخبئها، ونثرتِ الضياءَ في كلِّ زوايا قلبي.
طيلةَ تلك الأيام، لم أتمكَّنْ من التحدّثِإليها. كنا نتبادل الابتسامات فقط، لم أجرؤعلىبدءِالحديثِ معها، وحاجزُ الدينِ كان يقفُ بيني وبينها، لم أسالْها.. لكنني شبهُ متأكدٍ من أنها مسيحيةُ الديانةِ، مثل رفيقتها.
لكنَّ هذا الصباحَ يبدو غريباً قليلا.. فحين دخلتُ قاعةَ المحاضرات، لم ترفعْ سارة رأسها لتبادلني التحية، ولم تبتسمْ لي مثل كل يوم، كانت تجلسُ وحيدةً من دون رفيقتها،ذات الشعر الأحمرالمتوهج،وكثيرٌ من الانقباضِ والحزنِ يبدو واضحاً على وجهها الحليبي.
أكملتُ محاضرتي، وحزمتُ أوراقي، ووضعتها في الحقيبةِ الجلديةِ الكبيرة، مع حاسوبي المحمول،الذي يرافقني دوماً خلال يومي، ووضعتُ الحقيبةَ على كتفي، وهممتُ بالخروج، لكنني لم أستطعْأن أخطو خطوةً واحدة، دون أن أفهمَ سببَ حزنِها اليوم.
اقتربتُ منها، فانتبهتْ ورفعتْ رأسَها تنظرُإلي ….
– صباح الخير
– صباح الخير، أستاذ علي
– مابك سارة.. تبدين لستِ على مايرام، ثم هذه أوَّلُ مرةٍأراك وحيدة، دون رفيقتك.
هل حدث مكروهٌ لا قدّرَ الله؟
– تركتني أستاذ علي، تركتني هند، رفيقة عمري، وهاجرتْأمس إلى كندا…
لم تكن ترغب بالهجرة، لكنك تعلم بما يحدث في أيامنا هذه، فقد جاءهم تهديدٌ صريحٌ قبل يومين، وخيّروهم بين ترك دينهم، ودخول الدين الإسلامي،أو القتل.
هند وأهلها أناسٌ طيبون ومسالمون، إنها رفيقتي مذ كنتُ في الثانوية..
فلم يبقَأمامهم سوى الهرب، بعد أن صار القتلُ أسهلَ من تقشيرِ موزة.
“كانت سارة تتكلمُ والغصة تعتريها، ولونٌ أحمر يلوث بياضَ عينيها الصافيتين”.
– نعم الآن فهمتُ سببَ الضيق الذي أنت فيه، ففقدانُ الأحبَّةِ سيفٌ حارقٌ، مغروسٌ في القلب..لكنِ اسمحي لي بسؤالٍ ياسارة
– نعم تفضل
– هل فكَّرتِأنتِأيضاً بالهجرة؟ أو هل تعرَّضتم لأيِّ تهديدٍ مثل عائلة هند؟
– لا يا أستاذ علي…
أنا وحيدةُ أمي، وأمي ترفضُ فكرةَ الهجرةِ تماماً، ثم أنَّ ديانةَ هند المسيحية،وهي السببُ وراء هجرتها .
– الستِأنتِأيضاً من ذات الديانة؟
– لا.. أنا مسلمةٌيا أستاذ، هل لأنَّ صديقتي الحميمة مسيحية، اعتقدتَ بأنني على ديانتها؟
– الحقيقة، طيلةَ الوقت وأنا أعتقد انك مسيحية الديانة.. فجمالك والصليبُ المعلَّقُ في رقبةِ رفيقتك الحميمة أعطاني تلك الفكرة الخاطئة.
كانتْ تنظرُإلى عينيَّ، وتلتقطُ نظراتي المرتبكة، وأنفاسي اللاهثة، وقطراتِ العرق التي تزاحمتْ على جبهتي، فترتسمُ ابتسامةً لذيذةً على شفتيها المرسومتين مثل حبَّةِ فراولةٍ طازجة.
لم أستطعْأن أخفي عنها ارتباكي، ولم يخطئْ راداري، في التقاطِ موجاتِ الحب التي تبعثها عيناها الرائعتان، فكنت أهمس في سرّي:
سارة… يبدو أنَّ لا مفرَّ منك…
(33)
لو كان أبي على قيد الحياة الآن، ماذا سيكون ردُّ فعله يا ترى؟ وهو يرى مدينته مستباحةً من كائناتٍ غريبةٍ،يتكاثرالقملُ في فروةِ رأسها، وشعر ذقنها، ويحرّم الاستحمام في شريعتها مدى الحياة.كائنات يحسبون على الجنسِ الذكري من البشرِ، فقط لأنَّهم يمتلكون عضواً ضخماً بين أرجلهم.
هل كان والدي الرجلُ العسكري الذي يحلقُ ذقنه مرتين في اليوم، ويرفضُ ارتداءَ بيجامته قبل النوم،إلا إذا كانت مكوية، ويظهر على بنطاله حدَّ السيفِ من شدّةِ الكي، يحتمل رؤية مدينته الموصل، يحكمها رجالٌ برائحةٍ عفنةٍ، وملابسٍ سوداء قذرة، وذقونٍ، تمرح فيها الحشرات، وتبني فيها العناكب بيوتها وتتكاثر!؟
أبي القائد العسكري الكبير، الذي خاض الحربَ الطويلةَ، وتحمَّلَ الويلاتِ في السنواتِ الماضية،كان يهمسُ في أذني قبل أن يفارقَ الحياةَ، وهو على فراشِ المرض:
– سارة حبيبتي..كوني صلبةً وشامخة، مثل شجرةٍ عميقةِ الجذور..لا تسمحي للعواصفِ باقتلاعك، لا تقلقيني في قبري يا ابنتي.. أنت وحيدتي، لا أشقّاءَ ولا شقيقات لك..فكوني فتاة بمئةِ رجل..اجعلي الله في قلبك، وليس في مظهرك، فليكن قلبك طاهراً، مثل ماءِ الفرات، الذي لم تلوثْهُ فضلاتُ الجبناء، مهما تكدَّست على سطحه.
لم أفهمْ- وقتها – كلماته تلك، كانت مثل لغزٍ بالنسبة لي، وأنا لم أبلغْ الثالثةَ عشر من عمري بعد، لكنه حفرها في قلبي وذاكرتي.
تسكنُ عشيرةُ أبي مدينةَ الموصل.كان يقول لي دوماً: سارة لم تَرِثي منّي سُمرتي، ولا ضخامةَ أنفي، وضيقَ عيني، أنت محظوظةٌ يافتاة، فقد ورثتِ حسنَ والدتك، ببشرتها البيضاء، وخضرةِ عينيها، لكنك أخذتِ مني الشجاعةَ والصلابةَ، وعزيمةَ الرجال، ابنةُأبيك بحق.
لكنني الآن أفهم كلماته جيداً، فحين تأكدتُ من حبِّ علي لي، ومن صدقهِ، وقلبهِ الطاهر؛ أخبرته عندها، أننا مختلفان في المذهب.لكنه اختلافٌ شكلي، فكلنا نعبد إلهاً واحداً، ونصلّي خمسةَ فروضٍ في اليوم، ونصومُ ثلاثين يوماً، أو تسعةَ وعشرين أحياناً، ونحجُّ إلى قبلة واحدة.
فمتى يفهم الناسُ أن ما يجمعنا أقوى من الذي يفرقنا.
عمّاتي وأقاربي وأجدادي ما زالوا يسكنون مدينة الموصل.لكنني في أوقاتٍ كثيرةٍ كنت أذهب بصحبةِ والدتي لنزورَ الأمامَ الحسين في كربلاء، لم أشعر يوماً بأنَّ مرضَالأنواعِ، والفصائلِ، والطوائف قد أصابني،لأنَّني ببساطةٍ شديدة؛ أؤمن بالإنسانية قبل الدين.وفي هذه النقطةِ بالذات كنا أنا وعلي متفقان جداً.
.في بدايةِ علاقتنا كان علي متخوفاً من رفضي له بسببِ اسمِهِ الصريح، الذي يشي بمذهبهِ الشيعي.فرجلٌ يحملُ اسم “علي حسين علي” ماذا يمكن أن يكون سوى شيعيٍّ بالوراثة.
المذهب يمكن أن يأتي بالوراثة..لكنَّ القلبَ الطاهر، والعقلَ المتفتحَ، والخلقَ الطيب؛ نحن من نصنعُهُ بتنقيةِ الروحِ من شوائبها.
نعم قد كنتُ معجبةً بعلي، من أولِ يومٍ دخلَ فيه علينا قاعة المحاضرات، فقد كان شابّاً، وسيماً، ذا طولٍ فارع، وبشرةٍ سمراء صافية.كانت نظراتُهُ تخطفني، وتحلّقُ بروحي في سماءٍ بعيدة، لايسكنها سوى لونِ عينيه العسليتين.لكنني أحببته جداً بعد أن تحدثنا.
علي، رجلٌ يحملُأيمانَهُ في قلبه، وتربطُه جذورٌ، قويةٌ، صلبةٌ، بترابِ الوطن.
كان يقول لي:
سارة، هناك حبلٌ سرّي، خفي، يربطنا بالوطن، فيمكن لنا أن نكرهَ من خان الوطن، أو نكرهَ من يحكمُ الوطن، أو أن نكرهَ ما آل إليه مصيرُ الوطن..على أن لا نكرهَالوطنَ نفسَه.
لكن لأيِّ منحدرِ يسيرُ هذا الوطن؟
فعماتي وأقاربي محتجزون هناك في الجانبِ الأيسر، من مدينتي الموصل، وانقطعتْ كلُّأخبارهم عنا، منذ قرابةِالثلاثة أشهر.أرى مشاهدَ الرعبِ كلَّ يومٍ تنقلها القنوات، الجرذان بلحاهم القذرة، وثيابهم السوداء، يتجوّلون في الشوارعِ الخربةِ للمدينة، ويزرعون راياتهم السوداء على سطوحِالبيوت، والدوائر الحكومية.
لو كانتْ رفيقتي المسيحية هند هنا، لماتتْ كمداً على مدينتنا.فهي مسيحيةٌ موصلية، ولو كانت اليوم في الموصل؛ لصارتْ سبيةً، ملكَ اليمين لأصحابِ اللحى القذرة، والجسدِ العفن، ولَتبادلوا الأدوارَ على جسدها الغض الطاهر، باسم نكاحِ ملك اليمين.
كانتِ الأخبارُ عن حكم الدواعش القذر، في مدينتي الموصل، تأتينا من بعض أقاربنا الذين هربوا من المدينة، وتركوا منازلهم وراءهم، يطلبون النجاة بأرواحهم، ومن خلال القنوات الفضائية، وبعض الأخبارِ المسربة من هنا وهناك.
أخبرتني عمتي الفارّة من المدينة: أنَّالدواعشَ المجانين، حرموا على النساء هناك، طلاءَ شعرهنَّ بالأصباغِ، ونتفَ زغبِ حواجبهن، ووجوههن، ومن تفعل ذلك؛ تعاقب بالجلدِ، والمرأةُ صاحبةُ صالون التجميل، التي كانت تقوم بهذا العمل، تكون عقوبتها قطعُ أصابعِ كفِّها.
أخبرتني أيضاً أنَّهؤلاء الممسوسين،علموا عن طريق نسائهم “الداعشيات” اللاتي كُنَّ يتخفينَ ويدخلنَ بين نساءِ المدينة، وصالونات الحلاقة، يقتنصنَ الأخبار.. بأنَّ فتاةً طلبتْ من صاحبةِ صالون الحلاقة، أن تضعَ لها وشماً مؤقّتاً، لاصقاً على ظهرها، وحين وصلَ لهم الخبرُ؛ قاموا بجلبِ المرأةِ المسكينة، صاحبةِ صالونِ الحلاقة، وجلدوها مئة جلدة، وقطّعوا لها أصابعَ كفِّها، جزاءً على عملتها تلك.ثم بعدها قاموا بغلقِ كلِّ الصالونات، وحرموا تجميلَ النساء، عدا نسائهم، فكانوا يأمرون بعضَ الصالونات النسائية بالعمل على تزيينِ نساءِالدواعش بحجةِ أنهم يقاتلون، ويجب أن يتلذذوا برؤيةِ نسائهم في أجمل صورة.
في أدِ الأيامِشاهدتُمقطعاً مسرباً من مدينة الموصل، لفتاةٍ كانوا يعذبونها بآلةٍ تُسَمَّى “العضاضة” وهي شيءٌ معدني، يشبه مصيدةَ الحيوانات، ولها أسنانٌ معدنيةٌ مدببة.فكانوا يعاقبون تلك الفتاةَ بقرضِ يدها، بالعضاضة،لأنَّها خرجتْ دون أن ترتدي القفازات، مع أنها كانت ترتدي النقابَ كاملاً، وهو الزيُّ الذي فرضته داعش على نساءِ الموصل بعد استباحتها.
يبدو أن أصابعَ الفتاةِ كانت مصنوعةً على شكلٍ فرجِ امرأة, وما أن تقع نظراتُهم على أصابعها حتى تستثارَ غرائزُهم، وتنتفخَ أوداجُهم، وتحمرَّ أحداقُهم، ويسيلَ لعابُ شهواتهم، لذا قطّعوها لها؛لأنَّها أصابعُ فاجرةٍ، فاسقة، خرجتْ من الكفِّ،دون أن ترتدي ملابسَها الداخلية.
أحيانا وأنا أشاهدُ وأستمعُ لأخبارِ مدينتي المستباحة وأراها خَرِبَةً، يتجوّلُ فيها الغربان، تنتابني نوباتُ تقيؤٍ متكررة. وأشعرُأنَّ كلَّ فتاةٍ اغتصبوها هناك، تلبسني روحُها، فانفرُ من جسدي، وتراودني كوابيسٌ مرعبة، وأرى نفسي وسطَ رجالٍ يلبسون السواد، ويتحدثون إليَّ بكلماتٍ غريبة، وكأنها عدّةَ لغاتٍ، من عدّةِ دول.يحيطون بي، وأيديهم تحاولُ لمسَ جسدي.فأرى نفسي وأنا أمسكُ خنجراً، وأسدُدُ نصلَهَإلى قلبي، وأحدهم يكشفُ عن ساقي، فأرفع يدي عالياً، وأغرزُ الخنجرَ في قلبي، وأصرخُ لكنني لاأسمع صوتي، ولا يسمعني أحد، يتبللُ ثوبي، وجسدي بالدم، لكنهم لايبالون بدمي، ولا بصراخي، فتمزقُأظافرُهم القذرةُ ثوبي، ويتعرَّى جسدي، ثم يجثمُ أكبرهم سنَّاً فوق صدري، ويبدأ باغتصابي، والخنجرُ مغروسٌ في صدري،أصرخُ ولا أموت..
أصبحت أحلامي كوابيساً..وفكرةُ الهجرةِ، والهربِ من البلدِ، بدأتُ تدقُّ في رأسي، مثل ناقوسِ الكنائس.
(34)
(قشورٌ ملونة)
كان الغداءُ “سمكا مسقوفاً” الأكلةُالتي يجيدها زوجُ أختي عمر، ويبرعُ فيها كبراعتِه في طلاء الجدران.
وضعَ السمكةَ المشويةَ على المائدة العامرة بالرزِّ والبصلِ والسلطات، لم يكن ينقصنا في جلسةِ غداء يوم الجمعة – الذي تركناه منذ أن انتقل أخي وزوجته مع عمر وأختي إلى حي آخر، بعد أن هجَر عمر وأهله قسراً من حيّنا غير أمي – رحمها الله – والتي كانت ذكراً يطوف بيننا، وترفرف روحها، تمسح وجوهنا المتعبةَ بضياءٍيتسللُ من شقِّ الذاكرة.
كنتُ أزورُ أخي، الذي سكن مع عمرَ في بيتٍ واحد. لأنَّ من المحالِ على أخي، أن يبتعدَ عن رفيقهِ الروحي عمر، فما كان منه إلا أن تركَ الحيَّ معه، واستأجرا منزلاً في حيٍّ آخر.
بعد أن تحوَّلتِ السمكةُ على المائدةِ، إلى فوضى عارمةٍ من العظام، رفعتِ النساءُ كلَّ تلك الفوضى، واستبدلنْها بصحنٍ كبيرٍ، لفواكهٍ متنوّعة.
أمسكتُ بسكينِ تقطيعِ الفاكهة، ورفعتُ تفَّاحتين من الصحنِ الكبيرِ الشفاف، ووضعتهما في صحني، ثم رحتُ أقشِّرُ التفاحةَ الصفراء، وأقطّعها إلى قطعٍ صغيرة، ثم قشَّرتُ التفاحةَ الحمراء، وفعلتُ بها كسابقتها.ثم قلت لعمر:
-خُذْ هذهالقطعة،واخبرني ما هي؟
نظر لي عمر باستغراب، ثم راح يقضمُ قطعةَ التفاح، وهو يواصلُ كلامه،ويكتمُ ضحكته.
– إنها تفاحةٌ طبعاً.. هل تظن أنها باذنجان مثلاً!
– إذاً..خُذْ وتذوَّقْ هذه القطعة، واخبرني عنها.
تناولها مني، وراح يطحنها بتلذذٍ بين فكيه ثم قال:
– تفاحٌ أيضاً.. ما بك يا أبا علي؟ قد نقيتُ لكم التفاحَ الأصفر والأحمر بيدي، واخترته من أجود الأنواع.
– لكني لم أطعنْ بجودتِهِيا عمر، فقط لدي سؤال واحد..
هل انتبهت إلى أنَّ الاختلافَ كان في القشرةِ فحسب.. أما في المضمون؛ فكلاهما تفاح.
وهذا ما نحن عليه يا عمر.. أو ما يجب أن نكون عليه، نشترك بالمواطنةِ والإخاء، رغم اختلاف العقيدة.
(35)
– لا مكان لنا هنا حبيبي..أرجوك يا علي، يجب علينا أن نحزمَ أمرنا، ونتخذَ قرارَ الهجرة.
الخوفُ والموتُ يحاصرنا من كل جانب..قلبي يتمزَّقُ خوفاً عليك، إنهم يترصَّدون كلَّ من يحمل شهادةً عليا، وأنت أستاذٌ وتدريسي، وهذا يضعك في دائرةِ الخطر.
– ماهذا الفزعُ الذي يسكنك ياسارة..مابك؟
لن يبقى الحال كما هو حبيبتي.. فما زال في البلد رجال، إنهم يحتشدون ويهيئون أمرَهم، لتنظيفِ الموصلمن تلك الجِيَفِ العفنة..لا تخافي حبيبتي، لابد أن يحينَ اليوم الذي نتكاتفُفيه جميعنا.. أنا واثقٌ من ذلك.
أطلقتْ سارة ضحكةً عالية، لكنّها تضجُّ باليأس,هي تعتقدُ أنني ساذج، مغرمٌ بالوطن، أحفظُ الملاحمَ التاريخية، والشعارات، وأرددها مثل ببغاء، سرعان ما ينتفون ريشه بالملقط، ريشةً بعد أخرى، بسببِ حماستي التي تصفُها بالخيالِ العلمي دوما.
– ما هذه الرومانسية يا علي! أيُّ يوم، وأيُّ تكاتفٍ هذا..إننا نأكلُ لحمَ بعضنا بعضا.
– سارة..أنا لن أتركَ بلدي، سأختنقُ إن لم أتنفسْ هواءه، حتى لو كان ملوَّثاً، تثقله السموم.لقد وُلِدتُ هكذا حرَّاً مثل أبي..أبي الذي عرض نفسه للموتِ والسجن، وخرج معاقاً من سجن الدكتاتور، فقط لأنَّه يقدِّسُ الحريةَ، ويحملُ شعارَالإنسانيةِ فوق الجميع، بينما كان يحملُ غيرُهُ شعار(الزعيم فوق الجميع).
اسمعيني حبيبتي..نعم، كثيرٌ منا محبطون لأنَّ البلدَالذي نعيش فيه،أصبح نَتِناً مثل بالوعةٍ للصرفِ الصحي، مغلقةُ المجرى، وطافحةٌ بالقذارة.كلنا يشعر بهذه البشاعةِ التي نعيش فيها ياسارة، لكن إن لم يقم أحدٌ بالمغامرة، والنزولِبجسدهِ إلى منتصفهِ في تلك البالوعة، ومحاولةِ فتحِ مجراها، ماذا تتوقعين أن يحلَّ بنا؟
ستغرقنا البالوعةُ بمياهها الآسنة؛ ماذا عن والدتك، وأبي، وأمي، وأخوتي، وجارتنا العجوز، التي تودّعني كلَّ صباح، وتلوّح لي بيدها المكسوةِ عظامها بجلدٍ ناشف، فأنا أراها كلَّ يوم، تتكوّمُ بجسدِها الجاف على عتبة بابها، وتدعو لي بقلبٍ طاهر، وترى الخلاصَ من هذا العفن في عيني، وعيون شبابِ الحي، الذين لم تلوّثْهم الجرذانُ، ولم تسحبْهم لأوكارها النتنة بعد.
وأقاربك في الموصل، وأبناءِ عمومتي في الجنوب.. هل نهاجرُ كلنا؟ هل ينجو كلٌّ منا بنفسهِ، ويترك الشيوخ والأطفال والضعفاء، ليموتوا غرقاً في مياهٍ قذرة!
لن ينتصرَ شعبٌ متفرقٌأعلم ذلك،لكن هذه هي جدليةُ الحياة ياسارة،إنها بين نقيضين..أمس كنت أشاهدُ على اليوتيوب فيلماً قصيراً عن كلبةٍ تبحثُ مفزوعةً عن جرائها الأربعة، وتحومُحول كثبٍ من الرمالِ والأحجار، تنبحُ بصوتٍ يشبه العويل، فانتبه عليها أحد الشباب، وقد كان المكانُ في أحد المحافظات، فشاهد قدماً صغيرةً لجروٍ مدفونٍ تحت هذا الكثبِ من الرمل والتراب، وبلمحِ البصر، تجمَّعَ مع الشاب خمسةُ شبابٍآخرين، وراحوا يحفرون الأرضَ بأكفِّهم للعثور على الجراء، والكلبةُ الأم معهم تبحث بأطرافِها الأربعة.. وبعد ساعةٍ من الزمن نجحوا في إخراج الجراء من تحتِ التراب أحياء.
مايزال هناك نقاءٌ في القلوبِ ياسارة..مايزال هنالك رجالٌ يحملون الشهامةَ والشجاعةَ في دمائهم العراقية..لن أهاجر، لن أتركَ الوطنَ للرعاع، يفسدون عطرَ ترابه بعفنهم وصديدهم.
إنني أشعرُ وكأنَّ طاقةٌ من بخارٍ في داخلي، إن خرجتْ ستحدث صفيراً، طاقةُ الشباب يا سارة، الطموح، طموحي بخارٌ مضغوط، إن خرج؛ يمكنه أن يشغلَ مضخاتٍ وعجلات.. وإن لم يخرج سيفجر الآلة نفسها.. هكذا أشعر، وأريد لهذا الطموح أن يتفجَّرَ مثل عينِ ماءٍ زلالٍ في بلدي، وليس في بلدٍ آخر.
سأسألك سؤالاً واحداً,ماذا تريدين أن تكوني، نهراً، أم بحيرة؟
– ماذا؟ هل هذا وقتٌ للمزاحِ والفوازير! أقول لك الدنيا تحترق حولنا، وأنت غير مكترث، تجلس أمامي وترمي لي بفوازيرك العجيبة، يا لبرودة أعصابك!
– مهلاًمهلاً ..هذه ليست فزورة يا جميلة، بل هي فلسفة,سؤالٌ فلسفيٌّ عميق,فالنهرُ مجنونٌ لكن جنونه ليس خاوياً، بل ينطوي على فلسفةٍ عظيمة, إنه يقطعُ ثلاثةَ أرباعِ المسافة، التي يقطعها إن أرادَ أن يسيرَ بطريقةٍ مباشرةٍ للوصولِ إلى مجراه. الأنهارُ لا تحبُّ الطريقَ المباشر، بل هي ترقصُ بتعرّجات والتواءات,تمر هنا وهناك,تترنَّحُ وتتسكَّعُ طويلاً في الأرجاء، قبل أن تصبُّ في مصبِّها الأخير. الحقيقة لا أعرفُ لِمَ تفعلُ ذلك,ربما لأنَّها لا عقلَ لها, فقد تكون مجبرةً على فعلها ذاك منذ أن خُلِقتْ، في حين أنَّ البحيرةَ مغلقةٌ تقفُ مكانها، تاركةً الجداول تصبُّ فيها وتنعشها,البحيرةُ عديمةُ الخبرة، فهي لم تجرّبْ الطرقَ الوعرة، ولم تلتف حول الحواجزِ والصخورِ لتشقَّ لها طريقاً، كما يفعلُ النهر. لم تدخلْ صراعاً مع محيطها,تقف متصلّبةً في مكانها، متكبرةً دون سببٍ تفخرُ به, أما أنا شخصياً، فلا أودّ مطلقاً أن أعيشَ مثل البحيرة، بل سأكون نهراً مجنوناً يشقُّ بقاعاً غريبة,يرتفعُ ويهبطُ ويجذب معه الوحلَ، والحيوانات،والطيور النافقة، ومياه متخمة برواشحِ أراضٍ وبلدان بعيدة, وأجتاز صراعاتٍ مع نفسي، ومن يحيط بي، وحين أصلُ أخيراً إلى المصبِّ؛ يمكنني أن أفخرَ بنفسي، شاعراً بنشوةِ الفوز، بعد رحلتي الطويلة.
لابد من مقارعةِ الفسادِ والفاسدين.ضِعي كفَّك بكفي حبيبتي، ولنرسمَ لأولادنا مستقبلاً جديداً، وأرضاً جديدة، نتشارك جميعنا فيها، بلا طائفية، بلا تمييزٍ عنصري، تحت مُسمَّى المذهب والعشيرة.
صفَّقتْ لي سارة، بكفيها الصغيرتين، بعد أن أنهيتُ حديثي، ساخرةً مني، ومن فلسفتي، ثم قالت بصوتٍ فيه لحنُ سخريةٍ واستهجان:
– نعم..أعتقد أنك تتحدثُ عن المدينةِ الفاضلةِ لأفلاطون..
وتحلمُ بتناولِ الفطور مع العصافيرِ في صباحاتِ الملائكة..أيُّ أرضٍ خضراء هذه، التي تكلّمني عنها يا علي.
أقول لك كلمة واحدة، نحن إن بقينا هنا، فسنكون إما مقتولين أو مقتولين!!
هذه أرضُ الموتِ يا علي، بلدُ رجالِ الظلام، والأزقةِ الخلفية، بلدُ الموتِ والرعب،
ولا وجودَ للمدينةِ الفاضلة، إلا في خيالك، لا تظن أنني سأتخلّى عنك يوماً، لكن صدّقني أنك حالمٌ وخيالي، وقد يؤدّي بك ذلك إلى فقدان حياتك.. هذا البلدُ ليس لمن هو على شاكلتنا يا علي، فقد استباحته الشياطين، ولن تتركه إلا وأرضه يباب.
كلُّ ماحولنا غيرُ مناسبٍ لتحقيقِ ماتسمّيه طموحاً، بل إنك بمكوثِك هنا؛ ستقتل نفسك، وكأنك ذلك الضفدعُ الموهومُ الذي وضعوه في قدرِ ماءٍ تحته النار..
– ماذا؟ إن كنتُ أنا الضفدع، فأنتِ حبيبةُ الضفدعِ المسحور، هيا اعطني قبلةً، وسيزول عني السحر.
– دعني أكملُ كلامي يا خفيفَ الدم..كنتُ أقصدُ أن الإنسان يحاولُ أن يجبرَ نفسَهُ أحياناً على التكيّفِ مع ظروفٍ قاهرة، وهذا خطأ فادح، لذا كنتُ أقصُّ عليك تجربةً قاسيةً وضعوا فيها ضفدعاً في قِدْرٍ على موقدٍ مشتعل، وحين بَدءَ الماءُ- في القدر– يسخنُ؛ قَفَزَ منه الضفدعُ، وقد كان قرارُهُ صائباً، لكنّهم أعادوه مرةً أخرى إلى القدر، فراح المسكينُ يجبر نفسَه على التكيّفِ مع حرارةِ الماء، وكلما ارتفعتِ الحرارة، يرفعُ هو من حرارةِ جسمهِ، مستهلكاً بذلك طاقتَهُ،وعندَ وصولِ ماءِ القدرِ إلى الغليان؛ مات الضفدع، لكنه لم يمتْ مسلوقاً بالماءِ الساخن، بل ماتَ بعد أن استنفدَ كلَّ طاقتهِ في محاولةِ التكيّف..
– كلا، لا أعتقد أن ذلك هو سبب موته.
– وماذا تعتقد إذاً، أيها العبقري..قلتُ لك أنَّ الماءَ المغلي لم يقتله، بل عناده وغباؤه هو من قتله.
– لا يا صغيرتي المدللة، بل الأميرةُ العنيدةُ هي من قتلته، فلم يطلبْ المسكينُ سوى قبلة، قبلة فقط يا سارة، وسيذهبُ عنه السحر، هيا.. اقتربي يا مجنونة.
– أوووه..كلُّ مرةٍأُحدِّثُك فيها عن الهجرة، تَقلبُ الحديثَ مزاحاً.
– نعم سأهاجر، لكن إلى عينيك، ففيهما من الحياةِ ما يكفيني،بل سأكون البطلَ الخالدَ في غابات عينيك.
***********
كنا في بيتِ سارة، حين صارحتني بفكرتها عن الهجرة، فمنذ بدايةِ حبنا، كانت سمةُ علاقتنا هي التعاون والتفاهم، وحين طلبتْ مني سارة أن أتعرَّفَ على والدتها؛ وافقت مباشرة، ولبيَّتُ دعوةَ الشاي عصراً في منزلهم، الذي يشبه قصراً تتقدَّمُهُ حديقةٌ غنَّاء، تصطفُّ فيها أشجارُ الحمضيات،وشتلاتُ الورد بكلِّ ألوانه، وعطرُ شجرة الغاردينيا المزروعة في الزاويةِ البعيدة من الحديقة، يعبقُ متداخلاً مع نسماتِ الهواء، التي تداعبُ أغصانَ شجيراتِ البرتقال والليمون، ثم بابُ المنزلِ الخشبي الكبير، الذي يعجُّ بالزخارفِ ويربضُ على جانبيه، نمران كبيران من الرخام، بفكَّين مفتوحين، وأنيابٍ طويلة. حين اجتزتُ الرواقَ، واجهتني صالةٌ واسعةٌ جداً، صعدتُ إليها عبرَ ثلاثِ درجات من الرخام، كانتِ الجدرانُ مطليَّةً باللونِ الأزرق الباهت، وقد عُلِّقَتْ عليها لوحاتٌاصطفَّتْ بخطٍّ أفقي،تظهر فيها رسوماتٌ تحكي الحياةَ البغدادية القديمة..فتياتٌ بأثوابٍ منزليةٍ زاهيةِ الألوان، وضفائرٌ سوداء طويلة، ورجالٌ بعمامةِ الرأسِ البيضاء، تلك التي يرتديها البغداديون على رؤوسهم في الخمسينات والستينات، ثم صورةٌ كبيرةٌ مُذهَّبةُ الإطار، لرجلٍ ضخمٍ كبيرِالأنف، ضيقِ العينين، يتدلَّى شاربُه الكثيفُ الأسودُ اللون على زاويتي فمه، كان ينتصبُ في الصورةِ بشموخ، بزيهِ العسكري، ورتبتهِ المُثقلةِ بالنجوم، والرموزِ العسكرية، تحطُّ على كتفيه العريضتين، وتتدلَّى عدةُ أوسمةٍ ذهبية، معلقةٌ على صدرهِ المنتفخ.
اتخذتُ مقعدي على الأريكة المذهبة، التي أشارتْ إليَّ بها والدةُ سارة، تدعوني للجلوسِ، فيما دخلتِ امرأةٌ سمراءٌ قصيرة،تضعُ مئزراً على وسطها، وتدفعُ بكلتا يديها عربةًذهبية اللون، اصطفَّتْ فيها أطباقُ الحلوى، والسكاكين، والملاعق، وأكوابُ الشاي الخزفية، ووضعتْها بيننا، ثم تكلَّمتْ مع والدةِ سارة، بلكنةٍ أجنبية، ثم أومأتْ لها والدةُ سارة بالانصراف، وتولَّتْ هي بنفسها صبَّ الشاي مع ابتسامةٍ مُتكلِّفة ارتسمتْ على شفتيها.
ولأنَّني ممن يدخلون البيوت من أبوابها؛شعرتُ أنها فرصتي، كي أفاتحَ والدة سارة برغبتي في الزواجِ من ابنتها الوحيدة، وقلبي يضربُ في صدري مثل طبولِ المعركة، خوفاً من رفضها لي. .
والدةُ سارة، امرأةٌ هادئةٌ، رقيقة، لم تفقدْ تلك الرقة، رغم عشرتها الطويلة، لزوجٍ عسكري
حدَّ النخاع.فما زالت تعشقُ الأغنياتِ القديمة، وتضعُ قطَّتها البيضاء في حجرها، تداعبُ ظهرها الناعم بيديها الصغيرتين. إنها نسخةٌ من سارة، لكن مع بعض الخصلاتِ البيضاء في شعرها الأسود، وقليلٍ من الخطوط الرفيعة التي ارتسمتْ تحت عينيها، وفي جبهتها الناصعة، مع فارقٍ يبدو أنه جوهري، بين شخصيتها وشخصيةِ سارة، أو قد أقولُ بين أفكارهما، فوالدةُ سارة، يظهر عليها النعيمُ، وحبُّ الترف، والحياةُ الناعمة، كان ذلك واضحاً من تعلِّقها الشديد بالظهور في أتمِّ زينتها من الفساتين المستوردة، وإصرارها على وضعِ المجوهرات بكثرة، وعلى تنوعِ موديلاتها، في حين كانت سارة فتاةً تعشقُ البساطة في المظهر، وتظهر وهي بجوار والدتها، كأنها تلميذةٌ تقفُ بجوارِ سيدةٍ في قصرٍ ملكي.
كنتُ أتأملُ تلك السيدة الغنيّة، وكلماتُ سارة، تمرُّ في رأسي، فقد أخبرتني يوماً، أنَّ والدتها نشأتْ في أسرةٍ فقيرة، وأنَّ كلَّ هذه الرفاهية، هي لما يمتلكه والدها من مزارعٍ وأراض، فجال ببالي خاطرٌ شغلني عن الحديث، فمثلاً، إن كان المرءُ قد ذاقَ العوزَ لردحٍ طويلٍ من الزمن، فلماذا حين يتغيّر حاله، ويرفل في الجاه والنعيم، يصبح مبالغاً في التعبير عن غناه، مترفِّعاً عن فقراء القوم؟ فلو شعرَ ذلك النوع من الناسِ بقيمةِ ذاته، وهو فقير؛ لما زاده الغنى، سوى تواضعٍ وبساطة، لكنها عقدةُ النفوسِ الخاوية، التي لا تملكُ من ميزةٍ تعتزُ بها،فيُهيَّأ لها؛ أنَّ ذلك البهرج الخداعَ، سيضفي عليها كرامةً ورفعة.
تبادلنا أنا ووالدة سارة الأحاديثَ طويلاً،وكنتُ أرمي بكلماتي عن مذهبي، وجذورِ عائلتي على مسامعها، وأرقبُ ما يطرأ على وجهها من تعبيراتِ رفضٍ أو قبول،لشابٍّ مخالفٍ لها في المذهب!
فقد وصلَتْ بنا الحالُ،إلى أن يقاطعَ الأخُأختَهٌ،إذا كان زوجها من غيرِ مذهبه، ويبتزُّآخرون أقرباءهم وأبناءَ حيِّهم،إن كانوا مخالفين لهم في المذهبِ،مقابل السكوتِ عنهم، والامتناعِ عن سَوقِهم مثل الخراف، وتسليمهم لعصاباتِ الموت.
لكن يبدو أن خوفي لم يكن في محله، فقد أخبرتني سارة – لاحقاً – أنها عانتِ الأمرَّين في سبيل إقناع والدتها أنَّ اختيارها لي قرارٌ صائب، معتمدةٌ على حبي لها، والشهادةِ العليا التي سأحصلُ عليها قريباً، ثم حصولي على درجةِ أستاذ في الجامعة.فقد كنت أخشى أن يكونَ فارقَ المذهبِ هو ما يشغلُ بالَ والدةِ سارة، لكن اتضحَ لي أنَّهالمال، وكوني من أسرةٍ فقيرة، هو ما يمنعُ موافقتها، وبعد جهدٍ كبير، تمكَّنتْ سارة من انتزاعِ الموافقةِ على زواجنا من والدتها، بشرط أن نسكنَ بعد زواجنا في منزلٍ منفصل، ويكون في حيٍّ راق، ونبتعدُ عن حيِّنا الشعبي.
توالتْ زياراتي إلى منزلِ سارة كل أسبوع تقريباً، بعد أن طمأنتْني والدتُها بموافقتها على الزواجِ،بشرطِ أن تكمل سارة دراستها الجامعية.كانت زيارتي لهم بسببِ ضعفِ سارة في أحدِ الدروس، فاتفقنا أن أحضرَ لمدةِ ساعةٍ كل أسبوع، لأساعدَها في شرحِ مايصعب عليها، وقد كانت والدتها مضيافةً، كريمة، إذ لم تنقطع أقداحُ الشاي، وقِطَعُ الحلوى، طيلةَ الساعة، التي أجلسُ فيها في غرفةِ الضيوف، حول الطاولة، أشرحُ لسارة وأضعُ لها اختباراتٍ كانت تنجح في قليلٍ منها، وتخفقُ في كثير.
في حين كانت والدتها،تجلس على الأريكةِ المقابلةِ لنا،بعد أن تضعَ ما لذَّ وطابَ على المائدة، ثم تشغل وقتهابتقليبِ مجلاتٍ من النوعِ التي يعرضُ الأزياءَ، وآخرَ صيحاتِ عالم المجوهرات، طيلةَ تلك الساعة.
(36)
كان موعدُ محاضرةِ سارة، هو السابعة مساءً، حيث أنتهي في تمامِ الثامنة، وأخرجُ من منزلهم الكائن في جانب الكرخ،قاطعاً الطريقَ بسيارتي الخاصة،إلى الجهة الأخرى من الجسر. حيث جانبُالرصافةِ من بغداد، فمنزلنا يقع في حيٍّ شعبي من أحياءِ ذلك الجانب المزدحم بالكتل البشرية.
كان الحيُّ ساخناً، وتعجُّ فيه الفصائلُ المسلحة، والوجوهُ الملثَّمة، والمسدساتُ الكاتمةُللصوت.
عصاباتٌ فاقتْ بغرابتها كلَّأفلام “الأكشن” الأمريكية، لكنني كنتُ قد تعوَّدتُ على الأوضاعِ في حيِّنا، فلم أتورَّعْ عن الدخول،أو الخروج، مساءَ كل يوم.
في تلكالليلةِ كنتُ قد تأخَّرتُ في العودةِ بسببِ عطلٍ بسيطٍ في سيارتي، التي توقَّفتْ وسطَ الشارع، بعد خروجي من منزل سارة، قاطعاً منتصفَ الطريق، فاضطررتُإلى أن أركنَ سيارتي قربَ الرصيف، وأصلحَ العطلَ بيدي، ثم أواصلُطريقي الذي كان مزدحماً جداً بسبب كثرةِ الحواجز، ونقاطِ التفتيش،التي لا طائلَمنها، وحين دخلتُإلى حيِّنا، كانتِ الساعةُ قد شارفتْ على الحاديةِ عشرة ليلاً، حيث الأزقةُ مظلمةٌ، باردة، خاليةٌ تماماً من المارّة،
فليلُ الشتاءِ طويلٌ،موحشٌ في حيٍّ تنشرُ العصاباتُأجنحتها السوداء فيه ليلاً، ويطبقُ السكونُ على الشوارع،إلا من نباحِ الكلابِ السائبة، وبعضِ الإطلاقاتِ النارية، مجهولة المصدر، تخرقُ السكونَ المخيفَ بين الحين والآخر.
حيُّنا يسكنُه الفقراء، أو من هم تحتَ المتوسطِ بقليل، ولم يبقَإلا بيتنا، لم يطلْه التقسيمُ بعد، حيث لم نزلْ نحتفظُ بمساحتهِ المكونةِ من مئتي متراً، كما هي، في حين أصابَ بيوتاتِ الحي جميعها مرض التقزُّمِوالتقلُّص،فراحتْ تصغرُ وتصغر، بسببِ تجزئتها إلى مجموعةِ بيوتٍ صغيرة، مكوَّنة من أربعين أو خمسين متراً،تلتصقُ جدرانها ببعضها البعض، فمن يسعلُ وهو جالسٌ في غرفةِ المعيشة؛ يسمعه الجارُ الملاصق له، وهو مستلقٍ على الأريكة، في غرفةِ جلوسه، التي تشترك معها بنفس الجدار.
أما غرفُ النومِ، فكانت كارثةً بحق، فما أن يحلَّ منتصفُ الليل،أو قبيلَ حلولِ الفجر بساعتين، حيث تخيِّمُ العتمةُ التامة، مثل عملاقٍ أسودٍ ضخم، ويصمتُ الضجيجُ وتنامُ الأبدانُ المتعبة، وتبدأ نارُ الرغبةِ بالاشتعال في أجسامِ الرجال، في تلك الساعات الهادئة من الليل؛ ستشعر عندها أنك وسط غرفةٍ مغلقةٍ لتصويرِ فيلم إباحيٍّ طويل، فالتأوّهات تأتيك من خلفِ الجدران الملاصقة لبعضها، حيث يتمتعُ الأزواجُ بخلوتِهم الشرعية في تلك الساعات، بعد أن يغطَّ الصغارُ في نوم عميق.
ولا أظنُّ- ونحن في هذه الخنادق الصغيرة المكدسة بالبشر – يستطيعُ الزوجُ التفريقَ بين تأوّهِ زوجتهِ من زوجةِ جارهِ في تلك الحبكة الليلية المظلمة.
حقَّاً،إنَّ الفقرَ لايشبعُ بطناً، ولا يسترُ عورة..
حين عبرتُ بسيارتي مدخلَ الحي، اتجهتُ يميناً كعادتي، للوصول إلى الزقاقِ الثاني، الذي يقعُ فيه منزلنا,لاحَ لي في العتمةِ خيالٌ لأربعةِ رجالٍ ملثَّمين،يتجهون نحوي،فأسرعتُ وأدرتُالمقودَ لأفلتَ من المواجهةِ، لكن رصاصتان في العجلتين الأماميتين لسيارتي،أطلقها أحدُ هؤلاء الأربعة؛ أوقفتني في مكاني، وسدَّتْ عليَّ طريق الهرب.
كنتُ أعلم أنهم يجوبون الشوارعَليلاً، ليسرقوا عرباتِ الخضار، والفاكهة المغطَّاة، بعد أن يتركها أصحابُها في “بسطيّاتهم” التي تحتلُّ الرصيفَ ليلاً، ويحكِمون تغطيتها، ليعودوا كشفها وبيعها نهارا، أو يقتحمون منزلَ هذا وذاك، ممن ترصَّدوهم خلالَ اليومين السابقين،واكتشفوا إنهم باعوا بيتاً، أو سيارة، وبحوزتهم مبلغٌ من المال، كل ذلك “الأكشنالهوليودي”كنتُ على علمٍ به، لكنني ابنُ الحي، ولطالما تنقَّلتُ فيه دون أن يقطعَ طريقي أحد،أو أدخلَ في اشتباكٍ مع أحد.
ضربَ الرجلُ الذي يقفُأمام سيارتي بعصا طويلة، لها رأسٌ حديدي، فحطَّمَ الزجاجَ الأمامي للسيارة إلى قطعٍ صغيرة،ثم ضربَآخرَ زجاجِ النافذة، الملاصقة لي، فحطَّمها أيضاً،ثم مدَّ يدَهُالتي تحملُمسدساً صغيراً، وجَّهَ فوهته إلى صدغي، وهمسَ في أذني:
(انزلْ دون ضجيج يا أستاذ علي، ولا تجبرني على ضربك)
– من أنت، تناديني باسمي، وتعرفني جيداً، قل لي ماذا تريدون مني؟ مادمتم لستم غرباءً عن الحي على مايبدو.
– أغلق فمك، وتعال معنا
سحبني هو وصاحبُهُ، والمسدسُ مازال بجانبِ رأسي، وربطَ الآخر عيني بعصَّابة، وساروا بي بضعَ خطوات، حيث دفعني رجلٌ منهم داخل سيارة، ثم جلسوا يحيطون بي من الجانبين، ورائحةُ البول التي تنبعثُ من الرجلِ الملاصقِ لي، تزكمُ أنفي، وتقلبُ معدتي، ثم انطلقوا يقطعون الأزقّة الخالية على ما أظن،لأنَّني طيلة الوقت لم أسمعْ ضجيجاً، أو أبواقَ سيارات، كالتي نسمعها لو كنا نسير في الشارع العام. إنهم رجالُ الأزقة الخلفية، فهؤلاء لن يظهروا إلا في العتمةِ، مثل الخفافيش.
(37)
اليوم هو الأحد.موعدُ بدءِ الامتحاناتِ النهائية، في قسمِ العمارة، وقد أكملتُ مشروعي الذي أبهرتُ به الجميع، ولم يبقَ أمامي سوى أسبوعين من التعب، إن تخطيتها بنجاح؛ سينتهي مشواري الطويل، وأحصل على شهادةِ البكالوريوس في الهندسة المعمارية، وأحققُ لوالدي حلمه.
والدي الحبيب الذي لم يمهلْه القدرُ ليشاركني فرحتي بتحقيقِ ما كان يتمناه لي.
كان الجو بارداً جداً، فالشتاء قاسٍ هذا العام.لكنَّ اليومَ كان مشمساً، والسماءُ صافيةُ الزرقة، ورائحةُ الأرضِ الرطبة، تعبقُ في الجو بعد ليلةِ أمس الماطرة، حيث أفرغتْ السماءُغيماتها الحبلى،وغسلتِ المياهُ سقوفَ المنازل، وما تبقَّى من الأشجارِ في الشوارع.
كنت أنظرُ من نافذةِ السيارة، وأنا في طريقي إلى الجامعة،حيث كان امتحاني يبدأ في الساعة التاسعة صباحاً، وكم كانتْ تبدو بغدادُ جميلةً في هذا الصباح المشمس، بعد ليلٍ ماطرٍ طويل.
أوصلني العمُّ توفيقُ إلى جامعتي، وودَّعني عائداً إلى بيتنا، حيث كانت والدتي تنتظره للخروجِ في جولتها الأسبوعية للتبضّع.
والعمُّ توفيق، هو سائقنا الذي تعوَّدنا عليه منذ عشرة سنوات، يرافقنا في كل مشاويرنا، رجلٌ طيب،وقورٌ في الخامسة والخمسين من عمره، ورغم أنَّ صحَّتَه لم تكن على ما يرام، إلا أنه يكرهُ الجلوس في البيت.
كان يقول لي:
“الكسلُ وتركُ العمل، يصيبنا بالمرض يا ابنتي، فمنذ طفولتي وأنا أصحو مبكّراً مع صياحِ الديك، وأخرج على بابِ الله، طالباً رزقي، ولن أتركَ عادتي، مادام الهواءُ يدخل صدري”
كان علي قد أخبرني ليلةَأمس – بعد أن انتهى من شرح الدرس لي في الساعة الثامنة – أنه سيكون بانتظاري في كافتيريا الجامعة، بعد خروجي من الامتحان.
أكمتُ مراجعتي الأخيرة لأجوبتي على الأسئلة، وأغلقتُ دفترَ الامتحان، وسلمته إلى الأستاذ في القاعةِ الواسعة التي كنا فيها، وخرجتُ مسرعةً إلى نادي الجامعة، متلهفةً لموعدي مع علي.
اتخذتُ مكاني في الكرسي المقابل للنافذةِ التي تطلُّ على حديقة الجامعة، ووضعتُ حقيبتي على الطاولة، بعد أن صحّحتُ من هيأتي وأحمرِ شفاهي، جلستُ مسترخية، أترقَّبُ دخوَل علي في أيَّةِ لحظة.
مرَّتْ ربعُ ساعة، ولم يحضرْ علي، كنت وقتها أشغل نفسي بتقليبِ صفحاتِ”الفيس بوك” على هاتفي، لأتجنَّبَ مللَالانتظار، بحثتُ عن علي في “الماسنجر” فوجدتُ آخرَ اتصالٍ له ليلةَ أمس، في الساعة التاسعة مساءً! شيءٌ غريبٌ حقاً.. فهو كل صباحٍ كان يفتحُ هاتفَهُ مبكّراً، ويدقِّقُالرسائلَ الألكترونية المرسلة له على صفحته الشخصية.هل يُعقل أن يكون نائماً إلى هذه الساعة؟!
لكنَّ الوقتَالآن، هو الحادية عشرة صباحا.. تسلَّلَ القلقُ إلى نفسي، فاتصلتُ على رقمهِ لكنِ الصوتُ المملُّ هو من رد علي “الهاتف مغلق، يرجى الاتصال في وقت لاحق”.
تبدَّل القلقُ إلى شعورٍ بالغضب، وبدأتِ الحرارةُ تنبعثُ من وجهي وأذني، فكيف له أن ينامَ ويغلقَ هاتفَهُ، وهو يعلم أن اليوم، هو أول يوم لي في الامتحانات، ونحن على موعدٍ مسبقٍ في النادي!
أعدتُ الاتصالَ ثلاثَ مرَّاتٍ متتالية، والصوتُ نفسُهُ يأتيني من الهاتفِ، ويؤكّدُ لي نسيانَ علي لموعدنا، فقررتُ أن أخرجَ من النادي، وأذهبَ إلى المنزل مباشرة، وسيكون حسابه معي عسيراً، بعد أن يستيقظَ، ويرى مكالماتي الفائتة، ويعاودَ الاتصالَ بي، سأعلَّمه عدمَ تكرارِ فعلتهِ هذه معي، مرّةً أخرى، فلابد أن أضعَ منهجاً واضحاً لتعامله معي قبل الزواج، فأبغضُ الرجالِ إلى قلبي، هو الرجل المهملُ لزوجتِه.حسناً يا علي، سترى سارة المجنونةَ على حقيقتها اليوم.
(38)
كنتُ معصوبَ العينين، حين اقتادوني إلى مكانٍ مجهول، وأدخلوني بيتاً، تنبعث منه رائحةُ روثِ البهائم، ثم دفعتني كفُّ أحدهم بقوةٍإلى داخل الحجرة،وسمعتُ صوتَ المفتاح، وهو يطقطقُ في قفلِ بابٍ حديدي، كنتُ مربوطَ اليدين إلى الخلف، بحبلٍ خشنٍ غليظ، يضغطُ على معصمي.
بقيتُ ساكناً في مكاني، أستغلُّ حاسةَ السمعِ التي تضاعفتْ لدي الآن، بفعلِ انعدامِ الرؤيةِ لعينيَّ المعصوبتين، فكانت أصواتٌكثيرة،لرجالٍ تطرقُ سمعي من الحجرةِ المجاورة، وصوتُأغنياتٍ ريفيةٍ قديمة، تصدحُ عالياً،وتزاحمُ تلك الأصوات.
يبدو أنهم في جلسةِ سمر الآن، بعد أن أكملوا مهمَّتَهم واحتجزوني في هذه الحجرة، ولا أدري ما الذي ينوون فعله بي في الصباح.
بعد ساعات لا أعلم عددها، سمعتُ البابَ الحديدي يفتح، وخطواتٍ تقترب مني، ثم أحسستُ بيدٍ تنزعُ العصَّابة عن عيني، وتفتحُ الحبلَ المربوطَ حول معصمي، فالتفتُّ ونظرتُ من فوق كتفي، لأشاهدَ وجهَ الشخص الذي فكَّ قيودي، لكنه كان ملثَّماً بالكامل، عدا فتحتين صغيرتين حول مكان العينين، ينظر منهما بعينين سوداوين، لم أتبينْ حجمهما.
ودون أن يتكلمَ الرجلُ الملثَّمُ كلمةً واحدة، وضعَأمامي صحناً يحوي قطعةً من الجبنِ ونصفَ رغيف خبز، ثم خرجَ وأغلق الباب خلفه بالمفتاح،نظرت إلى طعامي، يبدو أنني عزيزٌ جداً على قلوبِ هؤلاء الخاطفين! وإلا لماذا يقدّمون لي الطعامَ بدل أن يجلدوني،أو يبصقوا في وجهي مثلا؟
ثم أنَّفي ساعةِ الخطفِ، ناداني أحدهم باسمي..هذا يعني أنهم يعرفونني حقَّ المعرفة، ولابد أنهم من حيِّنا، فقد يحييك الرجلُ صباحاُ، ويصافحك بحرارة، ثم يضعُ اللثامَ على وجهه، ويأتي ليأخذك رهينةً ليلا، يساوم عليها بأموالٍ لو بعتَ بيتك وكلَّ ماتملك، لما استطعتَ تسديدها.
تناولتُ قطعةً صغيرةً من الطعامِ الذي تكرَّموا به عليّ، ثم جُلْتُ بنظري في الحجرةِ التي تسلَّلتْ أشعةُ الشمسِ إليها من كوّةٍ صغيرة، في أعلى الجدار، بعد زوال عتمةِ الليل.كانتِ الحجرةُ خاليةً من الأثاث،إلا من بعضِ المقاعد المكسورة، والخردوات، ولها أرضٌ إسمنتية قذرة، لم تمرْ عليها المكنسة منذ أن بُنيتْ.
مرَّ عليَّ النهار في سكون، فلا صوتَ ينبعثُ من الحجرةِ المجاورة،ويتهيأ لي أنَّ البيتَالآن خالياًإلا مني..حاولتُ فتحَ الباب الحديدي، فهذه فرصتي للهربِ ماداموا خارج البيت، لكنَّ البابَ كان محكمَ الغلق تماما، فعدتُإلى مكاني، وجلستُأفكّرُ في طريقةٍ للخلاص، وصورةُأبي وأمي وسارة، لمتفارقْنني، فلابد أنهم قلقون جداً لغيابي، وماذا لو ساومهم الملثَّمون على المالِ..شعرتُ بخوفٍ يعتصرُ قلبي على والدي، فخبرٌكهذا كافياً للقضاءِ عليه تماما.
(39)
استغرقتُ في نومٍ عميق، بعد رجوعي للمنزل،فقد كنت أشعرُ بصداعٍ فظيع ينبضُ في رأسي،لابد أنه بسببِالسهرِ ليلةَ أمس وأنا أذاكر، وأيضاً بسببِ غضبي من إهمالِ علي لموعدنا. استيقظتُ بعد الغروبِمفزوعة، وتناولتُ هاتفي من على المنضدةِ بجانبِ سريري، فتحته وبحثتُ عن أيِّ رسالةٍأو مكالمة من علي، فلم أجد.
جُنَّ جنوني..وتحوَّل غضبي إلى قلقٍ وخوف، وهاجسٍ يهمس لي أن مكروهاً قد حدث لعلي، فاتصلت عليه مراتٍ عديدة، وما زال هاتفه مغلقا، فكدتُّ أجزم أن حبيبي في مأزقٍ،أو مشكلة، كبيرة، خرجتُ من غرفتي، وارتميتُ باكيةً على حجرِ أمي، حيث كانت تجلسُ في المطبخ، تتابع إعدادَ طعامِ العشاء مع الشغّالة، وتشرف على عملها.
– ماما.. ماما.. علي لايردُّ، وهاتفه مغلقٌ، لابد أنَّ حدثاً جمّاً لا أعرفه قد حصل، ساعديني وقولي لي كيف نطمئنُّ عليه،أو نعرفُأين هو!
– اهدئي، اهدئي ياسارة، لابد أنَّ بعضَ المشاغلِأخَّرتْه،أو قد يكون هاتفه معطّلاً.
– لا.. ماما،إنَّ قلبي يحدثني بأمرٍ سيئٍ قد أصاب علي.
– طيب، اتصلي على أيِّ أحدٍ من أسرته.
– لا أعرف رقمَ والدتهِ ولا والده.. لكنني سأتصلُ بالدكتور عمار، فهو صديقُ علي الحميم، ويعرفني جيداً.
– حسناً، هذا هو التصرُّفُ الصحيحُ يا سارة، فقط حافظي على توازنك.
بيدٍمرتعشةٍ، طلبتُ رقمَ دكتور عمار، وكلِّي أملاًأن يكونَ المانعُ خيرا..
– مساءُ الخيردكتور
– مساءُ النور،أهلاً سارة
– دكتور عمار، كنتُ اليوم على موعدٍ مع علي في النادي، ولم يحضرْ، ومنذ الصباح وحتى هذه الساعة، وهاتفه مغلق. هل تعرف أين هو الآن؟ أنا قلقةٌ جداً.
– الحقيقةُ يا سارة، لم ألتقِ اليوم بعلي، لكن اطمئنّي، سأتصلُحالاًبوالده، ثم أعاودُ الاتصالَ بك،وإبلاغك بأخبارِ علي.
– انتظرك..
مرَّتْ عشرون دقيقة، ولم يعاودْ دكتور عمار الاتصال بي، وقد نفدَ صبري، فأمسكتُ بهاتفي وعاودت أنا الاتصال.
– ألووووو
– أهلاً سارة
– ماهي الأخبار دكتور، هل اتصلت بوالد علي؟
– سارة.. اهدئي أرجوك، سأخبرك كلَّ شيءٍالآن..
اتصلتُ بوالد علي.. علي مفقودٌ منذ الأمس ياسارة، لم يعد إلى البيتِ منذ أن خرج عصراً، ووالداه في حالةٍ يُرثى لها، فقد بحثوا عنه في كلِّ الأماكن التي يرتادها، ولم يعثروا على خبرٍ له، لكنَّ الشيءَ الغريبَأنهم وجدوا سيارته في الحي، وقد كان زجاجُ النوافذِ محطَّماً، وحين سألوا الجيران القريبين من موقعِ السيارة في الزقاق،إن كانوا قد سمعوا صوتَ اصطدامٍ بين سيارةِ علي وسيارةٍأخرى؛ نفى الناس تلك القصة، وقالوا أنهم لم يسمعوا أيَّ صوتٍفي الليلةِ الماضية.
خوفي ياسارة،أن يكون علي قد تعرَّضَ للاختطاف، فالحي الذي يسكنُ فيه، تسيطر عليه مجموعاتٌمسلحة، وقد تعبتُ وأنا أنصحُهُ ببيعِ المنزلِ والانتقالِإلى حيٍّآخرَ أكثر استقراراً.
-عفوا دكتور عمار.. أنا والدةُ سارة التي تتكلمُالآن، فالخبرُ قاسٍ علينا جميعاً، لكنه وقعَ على سارة مثل الصاعقة، فقد رمتْ الهاتف في حجري، وراحت تجري إلى غرفتها كالمجنونة تبكي، وتضربُ وجهها.. آسفة جداً، سأنهي المكالمة، وألحق بها، لأرى ماذا حصل لها.
– نعم، أتفهَّمُ الحالة.. مع السلامة.
– مع السلامة.
(40)
قضيتُ ساعاتِ النهار أقطع الأرضية الإسمنتيةللحجرة الصغيرة، ذهاباً وإياباً.. مازال السكونُ يخيِّمُ على البيت، ورائحةُ الروثِ تشتدُّ مع تغيُّرِ اتجاهِ الرياح، لا أعلم هل هذه مزرعة؟أم منزلٌتقع بجانبهِ حظيرةٌ للحيوانات، فحين أدخلوني أمس إلى هنا كنتُ معصوبَ العينين، لكنَّ المكانَ رائحتُهُنتنةٌجداً.
سمعتُ صوتَ الأذان يرتفعُ من مسجدٍ غيرِ بعيد، أعتقد أن صلاةَ المغرب قد حانتْ، وضوء النهار في الحجرة الصغيرة تلاشى، وحلَّتِ العتمةُ سريعاً، الحجرةُ باردةٌ ومظلمة، ومنذ الأمس والبرد يتشرَّبُ في عظامي، والرطوبةُ تبللُ ملابسي.
هل سيتركونني وحدي مرميا هنا في هذا البيت المنعزل عن العالم .وإذا طال مكوثي هنا ماذا سيحل بوالدي المتعب ؟….قلقلي عليك الآن يا أبا علي أكثر من قلقي على حالي .
كان أبي يقولُ: أنَّ الصدمةَ تكون شديدةَ الوقعِ إذاتتلقَّاها حين تكون شابّاً, فما إن تُهزمَ في نزالٍ أو قصةِ حب؛ حتى تهبطَ على رأسك، حينما كنت تحلّقُ عالياً في السماء, وحالماً؛ ترديك صريعاً، مثل طائرٍ أُصيبَ بسهمٍ وهو غافلٌ منتشٍ في تحليقه,طائرٌ مغرور,كلُّ ذلك يحدث في شبابك فقط,والسببُ هو أنَّ الشبابَ يفتقرُ إلى الدهشة, نعم فالشباب لا يتوقَّعون اللامتوقع, لكن تخيل أن تتلقى إحدى تلك السهام وأنت تحثُّ الخطى نحو الشيخوخة, صدّقْني ستتلقاها وكأنها قرصةُ بعوضةٍ قذرةٍ وخبيثة فحسب, ستشعرُ بالانزعاج، وتُصابُ بحكَّةٍ وبعض التعكّرِ في المزاج، لكن سرعان ما ستبتلع كل ذلك، كمن يسيرُ أساساً بحذاءٍ مثقلٍ بالوحل, فلن يرديه قتيلاًإن التصقتْ بحذائه المتسخِ الثقيلِ بعضُ الغرامات الإضافية من الوحل, هكذا هو الأمرُ دوماً, يبتلعُ الشيوخُ جرعاتِ السمِّ بشهيّة، وكأنها جرعاتُ دواءٍ مرِّ المذاق، لكنه يخفضُ ارتفاعَ الضغط والسكر في الدم,لذا فرغم مرارتهِ، لكنه ليس أشدَّ مرارةً من الآلامِ المبرحةِ لأمراضهم المزمنة، التي توقظ مضاجعهم ليلا, لكنك إن كنتَ شابّاً، سيكون لسقوطِكَ بعد الصدمة صوتاً مدوّياً، كأنه صوتُ أطنانٍ من الحديد، رُميتْ من بناءٍ عال، لترتطمَ بالأرض, إنكم تفتقرون للدهشة يا ولدي,مثلكم مثل ذلك الأحمق الذي يرافق عاهرة، ثم يلوذُ بالعويلِ حال رؤيتها في فراشٍ رجلٍ غيره.
كم كان أبي يتعمَّقُ في تحليلِ الحياة,ربما كان يقصدُ أن يسقينا عصارةَ خبرتِهِ، لتحذيرنا من المطبَّات التي تنتظرنا في الطريق.
سحبني من رحلتي مع ذكريات كلمات أبي، وقعُأقدامٍ كثيرةٍ تقطعُ الباحةَ الخارجية..لابد أنهم قد عادوا..
تربَّعت قربَ الباب، وأرهفتُ السمعَلحديثِ الرجال في الحجرةِ المجاورة.كان بين أصواتهم صوتٌ لامرأة, بقيتُ في مكاني ساكناً، أنصتُ لما يحدث.
بعد ساعة من الزمن، صدحَ صوتُ الأغاني الريفية، تماماً كليلة أمس، ولغطُ وضحكاتٍ كثيرة يعلو عليها صوت الموسيقى الريفية. إنهم يقيمون حفلةَ سمرٍ في كلِّ ليلةٍ إذاً، لكن هذه الليلة جاءوا بامرأة، فصوتُ ضحكاتها العالي ينتشرُ في المكان، إذاً فهي حفلة سمر بصحبةِ عاهرةٍهذه الليلة.
لم يتفقدْني أحدٌ منهم، ولم يُفتحْ بابُ الحجرةِ الحديدي طيلةَ الليل، قضيتُ ليلتي أنصتُ لصوتِ العربدة والرقصِ في الحجرةِ المجاورة، حتى غلبني النوم.
شعرتُ ببرودةِ البابِ الحديدية، تدفعُ ظهري ببطء، فقفزتُ من مكاني ودخلتُإلى جوفِ الحجرة، وجلستُ لصقَ الجدار، كان الظلامُ دامساً، والسكونُ يخيِّمُ على المنزل، وخطواتٌ خفيفةٌ تتقدمُ نحوي، لكنَّ الظلمةَ الحالكةَ حالتْ بيني وبين الخيالِ الآدمي الذي اقتربَ كثيراً، حتى تسمَّر أمامي؛ فلم أستطع تمييزه.
ثم سمعتُ صوتاً نسائياًيخرج من الخيالِ الواقف بمواجهتي يهمسُ لي:
– أستاذ علي هل تسمعني..لا أستطيع أن أرفع صوتي خشيةَأن يستيقظَ هؤلاء الفجرة المجرمون.
سألتها بصوتٍ قريبٍ من الهمس:
– من أنت؟!
– لا تسألني من أنا..لكن لوالدك أفضاٌل كبيٌرة علي وعلى أولادي الأيتام، أنا أرملةٌمن حيِّكم، الفقرُ والحاجةُ والابتزازُ الذي تعرَّضتُ له من القذرين النائمين الآن في الحجرة المجاورة؛ هو من أوصلني لهذا الحال.أنا الآنامرأةٌ عديمةُ الشرف، يستغلني هؤلاء اللصوص لأنَّ لازوجَ لي، ولا أهلٌ ولا سند.
بدأتُ أسمعها تشهقُ وتبكي بصوتٍ خفيضٍ ثم أكملتْ حديثها:
حين تكلِّمَ أحدُ هؤلاء اللصوصِ اليوم عنك، ونحن في طريقنا إلى هنا، صمَّمت أن أسرقَ المفتاح، بعد أن يثملوا ويفقدوا وعيهم، وأفتحَ لك طريق الهرب، حتى أردَّولو مقداراً صغيراً من فضلِ والدِك علينا، أنا وأولادي الصغار.
هيا يا أستاذَ علي، اخرجْ بسرعة، قبل أن يفيقوا..اخرجْ واركضْ بأقصى سرعتك، حتى تصلَّإلى الطريقِ السريع فهو قريبٌ من هنا.
ثم تدبِّرُأمرك من هناك، لتصلَإلى أهلك.وأتوسَّلُإليك أن لا تخبرَأحداً بقصتي أو وجودي هنا الليلة.
لأوَّلِ مرةٍ في حياتي أقابل إنساناً يحملُ الذلَّ والعار، مع النقاء والشرف سوية! إنها تلك المرأة، أو ذلك الخيال الذي يقفُ قبالتي الآن، ويحدّثني بصوتٍ مرتعشٍ,صوتٌ قهرَهُ الزمنُ، والفقرُ، والبطنُ الخاوية,قلتُ لها صادقاً:
– اعطيني يدك لأقبلها ياسيدتي.. إنك أشرفُ من كثيرٍ، ممن يدَّعون الشرف، وقرّي عيناً، لن أخبرَأحداً عنك، رغم أنني لم أر وجهك أصلاً، ولم أتعرَّفْ عليك حتى من صوتك.
– أنت وأبوك وأخوتك، رجال طيبون، لو كان كل الرجالِ مثلكم؛ لما حصل لنا ماحصل.
اخرجِالآنأرجوك، هيا.
– باركك الله ياطيبة..
خرجتُ أجري على غير هدى، أقطعُ الشوارعَ الترابيةَ في ظلمةٍ حالكة، لاينيرها قمرٌ ولا حتى نجوم، فالسماء تغطّيهاطبقةٌ كثيفةٌ من الغيومِ على ما أعتقد، فحجبتْ عني ضوءَ النجوم.
كنتُ أجري وقطراتُ العرَقِ تتساقطُمن وجهي وظهري وسط البرد القارص، وحال تلك المرأةِ يشغلُ تفكيري..كيف تكمنُ كل تلك الطيبةِ والنقاءِ في نفسها وروحها، في حين تستمرُ في إغراقِ جسدها في القاذورات كل يوم! لا يمكنُ أن يقالَ أنها متجرّدةٌ من الشعور ومنحطة، فمن الواضحِ أنَّ الفسادَ لم يمْسسْها إلا آلياً، ولم تصلْ إلى قلبها قطرةٌ من الانحطاط الحقيقي..لقد رأيتُ كلَّ ذلك حين اخترقتُ مكامن نفسها، وهي تقفُ أمامي تحدثني..
تذكرتُ سارة..وحديثها عن الضفدعِ، وسخريتي التي أثارتْ حنقها..
المرأةُ المومس، الضفدع، محاولتُهُ المتكررة للتكيّف مع الماء وهو يغلي، غباؤه أو ضعفُ حيلته، قتلَ الضفدعُ نفسَه، قَتَلَتِ المرأةُ نفسَها…
بعد مدَّةٍ من الزمن، ليست بالقليلة، رأيتُ ضياءَ مصابيحِ الطريق السريع، فتنفَّستُ الصعداء، وضاعفتُ سرعتي في الجري، حتى وصلت، ثم وقفتُ في وسطِ الشارع رافعاً ذراعيَّ الاثنتين عالياً، محاولاً التلويحَ لأيِّةِ مركبةٍ تمرُّ من هنا.
كان الطريقُ السريعُ خالياً، أعتقدُأنها الساعةُ الأولى قبل حلول الفجر، لكن برحمةٍ من الله، لم يطلِ انتظاري، ورأيتُأضواءَ شاحنةٍ من بعيدٍ تتجه نحوي، فرحتُ أقفزُ وألوِّحُ لها، حتى توقَّفَ السائق قبالتي مباشرة، فتوسَّلْتُإليه أن يسمحَ لي بالصعود، على أن أنزلَ في بدايةِ الشارع العام، عند انتهاءِ الطريقِ السريع.
وافقَ الرجلُ على مساعدتي، وأركبني شاحنته، وانطلقَ في طريقه، وبعد ساعةٍ تقريباً، وصلنا إلى بدايةِ الشارعِ العمومي، الذي بدأ يزدحمُ بالسيارات، نزلت هناك وسرتُ عدَّةَأمتار على قدمي، أرقب ضوءَ الفجرِ المنتشرِ في السماء، وانحسارَ العتمةِ في الأفق.
شعرتُ بالهواءِ البارد يلامسُ قطراتِ العرقِ على جبيني، ونسيمٍ عليلٍ خالٍ من رائحة العفن والروث، التي تشبَّعتُ منها طوالَ ليلتين في حظيرةِ البهائم تلك.أحسستُ في تلك اللحظةِ بقيمةِ عملِ الخير، وكيف ردَّهُ اللهُ لأبي وقتَ شِدَّتي.
(41)
حين دخلتُ منزلي، كنتُ شاحبَ الوجه، ورائحةُ العرقِ والروثِ تنبعثُ مني. كان الصباح قد سلخ الظلام، والشمسُ المختبئةُ بخجلٍ خلف الغيوم، ترسلُ دفئاً وضياءً يكفي لنسيانِ برودةِ وعتمةِ الليلةِ الماضية.
راعني هولُ المنظرِ في غرفةِ الجلوس، فقد كان البيتُ يعج بأقاربي وأصدقائي، وحتى جدي شاكر كان هنا.جالساً ورأسه مطرق، وحباتُ الخرز في مسبحتهِ تتساقط، محدثةً طقطقةً عالية وهي بين أصابعه.
كان الرعبُ والحزنُ يسكن ملامحَ والدي ووالدتي، اللذان تعلَّقا برقبتي، وانفجرا ببكاءٍشديدٍحين دخلتُ المنزل، وكلماتٌ مثل الله اكبر..حمداً لله، كانت تتعالى من الجمعِ الذي يغطُّ به منزلنا منذ يوم اختطافي وحتى عودتي.
كان التعبُ والجوعُ قد نالا مني، فقصصتُ ماحدث لي باختصارٍ شديدٍ، لأريحَ القلوبَ القلقة التي تجمَّعت حولي، وحين سكنَ حال المنزل قليلاً؛ توجَّهت سريعاًإلى الحمامِ وفتحتُ الماء الساخن، ثم وقفتُ تحته ساعةً كاملة، مغمضَ العينين،أحاول طردَ كلِّ تلك الأحداث من رأسي، فكان سيلُ المياهِ الساخنة ينساب على ظهري وصدري، فترخى عضلاتُ جسمي التي تقلَّصتْ وتخشَّبتْ بفعلِ رطوبةِ الحجرة، في منزلِ الروثِ والبهائم.
خرجتُ من الحمام الدافئ، وأنا أشعرُ بتحسُّنٍ كبير، وقبل أن أضعَ لقمةً في فمي، طلبتُ من أبي هاتفه لأنَّ هاتفي أخذه الخاطفون، ثم اتصلتُ بسارة، التي قد تكون الآن في حالةِ انهيارٍ كبير، وقلق لايحتمله قلبها الطفولي البريء.
– ألووو
أتاني صوتها من الهاتفِ مبحوحاً، كمن أُتلفتْ حبالُهُ الصوتية، بالغناء أو البكاء
– ألوو…من؟
– سارة
– علي …يارب.. علي..أين أنت حبيبي…لم يبقَ بيني وبين الجنونِ سوى خيطٍ رفيع، ماذا حصل لك، وأين أنت الآن؟
– قصةٌ طويلةٌ يا سارة.. اتصل بك الآن من هاتف والدي، فقد دخلتُ المنزل منذ ساعةٍونصفٍتقريباً، اطمئنِّي.. أنا الآن بخير، سأرتاح قليلاً ثم أتصلُ بك لأراك.
– لا تتصل..اذهبْ وخذْ قسطاً من الراحة، وسنأتي أنا وماما لزيارتكم هذا المساء..أريد أن أفهمَ ماحدث بالتفصيل.
– حقّاً يا سارة.. فهل ستتنازلُ والدتك، وتوافقك على زيارةِ حيّنا الفقير؟ لا أعتقد ذلك، اتركي الأمر، أرجوك.
– ما دامت قد وافقت على مشروعِ خطبتنا، فلماذا لا توافقُ على أن ترافقني لأطمئنَّ عليك؟ لا تبالِ، سأتدبر أمري معها.
– سأنتظركم إذاً، وسأبلغُ والدتي الآن؛ لتستعدَّ لاستقبالكم.
– قلبي معك حبيبي
– أميرتي، اهدئي..لقد عدتُ، ولن نفترقَ عن بعضنا بعد اليوم.
أبلغتُأمي وأبي بزيارةِ سارة ووالدتها لنا مساءً . كان والداي على بيّنةٍ من الحب الذي يربطنا أنا وسارة، فقد أخبرتهما مسبقاً بالقصةِ كلها، ووعدُ والدةِ سارة لي، بأن توافقَ على زواجنا بعد تخرج سارة من الجامعة.
دخلتُ غرفتي لأنامَ قليلا، بينما انهمكتْأمي في تنظيفِ وترتيبِ المنزل، استعداداً لاستقبالِ سارة ووالدتها بعد ساعاتٍ قليلة.
(42)
كنتُأقفُ على عتبةِ البابِ الخارجي لمنزلنا، أرقبُ وصولَ سارة ووالدتها، وحين وصلتا دخلنا إلى منزلنا المتواضع جداً، قياساً بالقصر الذي تسكنان فيه، كانت سارة شاحبةَ الوجه، مخطوفةَ اللونِ من شدّةِ القلق عليّ، وكنتُأنا بشوقٍ كبيرٍ لرؤيةِ عينيها الساحرتين.
أدخلتهما حيث كانت والدتي في غرفة الجلوس، مستعدةً لاستقبالهما.. سلَّمتْ والدة سارة على أمي، وباركتْ لها عودتي حيّاً، ثم دخل أبي للترحيب بهما.كنا مانزال واقفين نتبادل كلماتِ الترحيب والشكر فيما بيننا، حين نظر والدي إلى والدةِ سارة الواقفةِ قبالته، لم يفتحْ والدي فمَهُ ولم يرحِّبْ بها بل ظلَّينظرُإليها نظرةً غريبةً، خليطةً بين المفاجأةِ والحزنِ والذهول، وبدا كمن توقَّفَ عنده الكونُ عن الحراك،وقد امتقعَ وجهَهُ امتقاعاً شديداً، كمن يرى شبحاً، أو من يلتقي بالموت ساعةَ الاحتضار.تعطل عنده الكلام..تقنَّعَ وجهُهُ الباسمُ بالجدية، وامتلأتْ عيناه دموعاً خجولة، ارتجفت أهدابه وكأنها أضلَّتْ طريقها، حتى أنا شعرتُ بغصَّةٍ مع أني لم أفهمْ ما يحدث.
ثمانتبهتُأنَّ والدة سارة تبادله نفسَ نظراته تلك، وهي مسمّرةٌ في مكانها، وملامحُ وجهِها تنطقُ بتعبيراتٍ غريبة، لم أستطعْ تفسيرها، شعرتُأنَّ الموقفَبدا محرجاً وغريباً، فقطعتُ الصمتَ بدعوةِ والدة سارة إلى الجلوسِ، وشكرتها على حضورها لتبارك لي عودتي من الموت.
قدَّمتْ لنا أمي الشاي مع قطعِ الكعك التي أعدَّتْها بنفسها، وكنت أنا وأمي وسارة من يديرُ دفَّةَ الحديث.قصصتُ عليهما قصةَ هروبي من الموتِ تلك، وتحدثنا في كثيرٍ من الأحاديثِ الجانبية فيما كان أبي طيلةَ الوقت مطرقاً ينظرُإلى الأرض، ولا ينبسُ بكلمةٍ واحدة.أما والدة سارة، فقد كانت مثل من يتحاملُ على نفسهِ ليجاملَ من حوله بكلماتٍ قليلة، ومسحةُ الحزنِ كانت واضحةً في عينيها المجهدتين،ووجهها الوديع، ومن حسنِ حظي، أن أمي لم تنتبهْ لتصرّفِ أبي وارتباكِه، فقد شغلها الترحيبُ بالضيفتين عن النظرِ في وجه أبي.
انتهتْ الزيارةُ سريعاً، فقد استأذنتْ منا والدةُ سارة، واعتذرتْ عن عدمِ تمكّنها من البقاءِ لوقتٍأطول،لأنَّها تشعرُ ببعضِ التوعّك، وقد لاحظتْ ذلك على وجهها بالفعل، حتى أن يديها كانتا ترتعشان مثل سعفة.
ودَّعناهما وشكرناهما على الزيارة، وظلت عيناي ترقبهما حتى تحركت السيارة بهما، يقودها العم توفيق السائق.
دخلتُ بعدها لأطمئنَّ علىأبي، فقد كان وضعه غريباً طيلةَ وقتِ الزيارة، وأسئلةٌ كثيرةٌ تدور في رأسي، بدأتُأفكِّرُ بردِّةِ فعلِ والدي الغريبة هذه، هل يُعقل أنه امتعض من سارة ووالدتها مثلا؟ هل غيَّرَ رأيه ولن يأتي معي، بعد أن تتخرجَ سارة لنطلبَها من والدتها، وهل سيرفضُ زواجي منها؟
بحثتُ عنه في البيت، فلم أجدْهُ، ثم أخبرتني أمّي بأنَّ والدي شعرَ بدوارٍ وصداعٍ مفاجئ، ودخل غرفته لينامَ وأوصاها أن لايزعجَهُ، ولا يدخل عليه أحدٌ منا هذه الليلة.
“الماضي والمستقبلُ هما في أذهاننا نحن فقط..لا وجوداً حقيقياً إلا للحظة.. الآن..ما تفعله الآن، سيصنعُ المستقبلَ، ويفتدي الماضي”
(43) (بغداد, الجسر 2015)
حالةٌ من التحليقِأو الطفو..أطفو مثلَ ورقةِ شجرٍ فوقَ الأمواج، وأُحلِّقُ خفيفاً مثل طائر “السباراكوف”أغيِّرُ لوني مبتهجاً كل ثانية…
لا يزعجني سوى هذا الرجل المرمى على الجسر قربي، إنه يلتصقُ بقدمي، والدماءُ الساخنةُ تتفجَّرُ من ثقبِ في جبهتهِ السمراء، وتغرقُ وجهَهُ وقميصه..لا أدري لِمَ يلتصقُ بقدمي! حتى لا يكادُ يترك لي متعةًللتحليق..يبدو أنَّ رصاصةً طائشةًأصابتْه في رأسه..
فالرصاصُ كثيف هنا..والاحتفالُ بهيج..وكلما ازدادتِ البهجةُ؛ ازدادَ الرصاصُ كثافةً… مسكينٌ هذا الرجل، تبدو الحيرةُ على ملامحه الشاحبة، ربما قضى ليلتَهُ على الجسرِ يفكّر في حلٍّ لمعضلةٍ طحنتْهُ، لكن لو أخبرني بمشكلتهِ قبل أن يموتَ؛ لكنتُ ساعدتُهُ في حلِّها..
فأنا أشعرُالآن بطاقةٍ عجيبة، حتى أنني بدأتُ ألمحَ مخلوقاتٍ ضوئيةً رائعةَ الجمال تحلِّقُ هنا فوق الجسر..
سأحاولُ التخلِّصُ من هذا الرجلِ الملتصقِ بقدمي، فالمخلوقاتُ الضوئية تناديني، لكن ربَّاه.. إنه يمسكُ بي بقوة..يقيّدُ حركتي، بل يقيّدُ رغبتي في التحليق…
أرجوك أيها الغريب المضرَّجُ بالدماء.. ابتعدْ عني، فها قد توازنتْ معادلتي أخيراً.. دعني أحلِّق.. أحلِّق
لا أدري أن كان ميتا أم على قيد الموت ..أو ربما هو يحتضر ببطء مثل سلحفاة .
أيها المحتفلون.. هل يسمعني منكم أحد؟ هنا رجلٌ مصابٌعلى الجسرِ، ينتظرُأن يحملَهُ أحدُكم، ويسعفه أو ربما هو ميتٌ، فتعالوا لتقبروه وتريحوه..أيها الأوغادُ المحتفلون بالموت.. ألا من رحمةٍ في قلوبكم الصدئة!..أم ران على قلوبكم النفاقُ، فصمَّ الآذان، وأبكم الأفواه…
ألا يمكنُأن يكونَ لهذا الرجلِ زوجةً تنتظرُ عودتَهُبفزعٍ وفؤادٍ فارغ..
ثم أنه يلتصقُ بي بقوة..
رفعتُ بصري إلى السماء، فوجدتُ القبَّةَ الزرقاءَ المرصعةَ بالنجومِ قد اختفتْ.. أو أعتقد أنها فقدتْ لونها، ونجومها اندثرتْ..حتى القمر الذي كان بدراً منذ قليل؛ رحل..لا شيء فوقي سوى الفراغ، ولا أحدَ معي على الجسرِ سوى جثةٍ مثقوبةِ الرأسِ لرجلٍ أشعر أنني رأيته في يومٍ ما، في مكان ما..كان مسجَّى على الأرضِ، منفرجَ الساقين والذراعين..وجوده يشعرني بوحشةٍ خانقة..وددتُ لو أعودُ لمنزلي الآن، أرتمي في فراشي، ولا أفكرُ بأمرٍ مطلقا.
سمعتُ صوت أحدهم ينادي باسمي من الجهةِ اليسرى للجسر..التفتُ نحو مصدرِ الصوت، وإذا بشابٍّ طويلِ القامة، يلفُّ رأسَهُ بقماشٍ يبدو أنه “شرشف” ممزقٌغطَّتْه بقعُ الدم، فلم أتبينْ لونَهُ، بينما ظلَّثوبُه الأبيضُ ناصعاً لم تلوِّثْهُ الدماء.. كان الشابُّ يبتسمُ لي، وينادي حسين.. حسين.. فتملَّكني الذهولُ عندها، ركضتُ نحوه محتمياً به من وحشةِ وحدتي..كان أفطسُالأنفِ، بنيَّ العينين.. تلك العينان أذكرهما جيداً.. ولولا أنه أطولُ قامةٍ وأرشق جسماً من زوجِأختي عمر؛ لخلتُه هو…
توقَّفتُ قبالته ونظرتُ في عينيه، كان شعاعاً غريباً مطمئنّاً للروح، ينبعثُ منهما.. بادرني بالسؤال.. قال لي حسين ألم تعرفني؟ عمر..أنا عمرُ زوجُأختك مريم.. شعرتُ بالراحة، لكنني وجَّهتُ له عتابا:
– مادمتُ هنا ياعمر، لماذا لمْ تسرعْ لمساعدتي حين كنتُ أصرخُ طالباً العونَ كي أحملَ هذا الرجل الملقى هنا على الجسر، فإن كان ميتاً؛ فلنحملْه إلى ثلاجةِ الموتى،أو أيِّ مكانٍآخر يمنحُ تلك الجثةَ شهادةَ وفاةٍ وحقاً في الدفن، فأنا مسمَّراً هنا على الجسر منذ ساعات، أحرسُ جثَّتَهُ، خوفيإن تركتها تنهشها الكلاب..وعدى هذا،فأنا أشعرُ بعطفٍ كبيرٍ نحوه يمنعني من تركه وحيداً.
تركني عمرُ في ذهولي، ولم يقابلْ لهفتي بكلمة..دار ظهرَهُ لي وسار متسرْنماًنحو وجهةٍأخرى يتبعُ نوراً بعيداً ينبلجُ قبالته..أرى الضوءَ الذي يتبعُهُ عمر ولا أرى مصدره، ثم اختفى كلُّ شيء كأنه لم يكن، فعدتُأدراجي نحو جثةِ الرجلِ الغريب، مثقوبِ الرأس.. بقيتُ جالساُ هناك، كمن فقد ذاكرته..حتى أنني نسيتُ طريقَ العودةِ للمنزل، كانتِ الأصواتُ الغريبةُ تطرقُ سمعي من كل الجهات، وأجسامٌ ضوئيةٌ تتراقصٌأمامي في الأفقِ البعيد، كأنها هالةٌ من نورٍ تتشكَّلُ بأشكالٍ بشريةٍ صغيرةٍ وكبيرة، لم يكونوا بشراً، كانوا شيئاًآخرَ لا أعرفُ كيف أصفُه، كان بعضهم يقفُ، وبعضهم يحلِّق..وآخرون يشكلون دوائراً، ممسكين بكفِّ بعضهم بعضا.. أسمعهم يطلقون ضحكات.. ضحكاتٍ بصخبٍ لذيذٍ لا ضوضاءَ فيه.
وفي ظلِّ وحشتي هذه وعيناي تراقبان الجثةَ التي أجلسُ قربها؛ خطرَ لي خاطرٌ مخيفٌ وأنا أحدِّقُ بالثقبِ في جبهةِ الغريب…
ألم أكنْ وحيداً هنا طيلةَ الليل؟ فمن هذا الرجل الملتصقُبقدمي!!
أيُعقلُ أن أكونَ قد…..؟!!
هل يمكن ذلك حقاً؟
(44)
(ما حَدَثَ قبل شهر)
لم أخرجْ للعمل، كنتُ ملازماً لفراشي في غرفتي، أشعرُ بأنَّ كلَّ بقعةٍ في جسدي تؤلمني، وأكثرُ بقعةٍهي تلك التي في يسارِ صدري..قلبي يبكيك ياندى…ويبكيك ياولدي علي.
كيف ساقتك الحياةُ اللعوبُ تلك، لتقع في حبِّ ابنةِ حبيبتي وألمي العميق! وماذنبك أنت، وذنبُ تلك الزهرةِ اليانعةِ البيضاءِ سارة..سبحان الخالق،إنها صورةٌ طبقَ الأصلِ من ندى.
سحبت ساقي بتثاقلٍ ونهضت من سريري، كانت زوجتي قد تمدَّدتْإلى جانبي في السريرِ وراحتْ تغطُّ في نومٍ عميق، تركتُ الغرفةَ وخرجتُإلى غرفةِ الجلوسِ، كان البيتُ ساكناً والكلُّ قد هجعَ ونامَإلا أنا وقلبي المضطربُ التائه..لم أوقظْ زوجتي المتعبة، وتحاملتُ على نفسي وذهبت أعدُّ الشاي لي في المطبخ، يبدو أنَّ النومَ لن يعودَ لزيارتي بعد هذه الليلة.
كنتُ أرتشفُ الشاي الساخن، وأسحب أنفاساً متلاحقةً من سيجارتي، وخيالاتُ الأمسِ البعيد تمرُّمن أمامي مثل شريطٍ سينمائي قديم..حين وصلتني رسالةٌ على هاتفي، فتحتها وقرأتُ كلماتها:
“حسين..أنا ندى، لابد أن نتكلم.. أأتصلُ بك الآن ؟”
ندى..إنها الماضي والحاضرُوالمستقبل، إنها وجعي الذي يرفضُ كلَّ مسكناتِ الألم.
رددتُ على رسالتها ب “نعم..أنا في انتظارك الآن”
بعد ثوانٍ رنَّ هاتفي، وسمعتُ صوتها ينساب في أذني..ويسحبني لأعماقِ محيطٍ لا قرارَ له..
– حسين..كيف حالك؟
– حالي..أتسأليني عن حالي يا ندى؟وماذا تتوقعين أن يكونَ حالي بعد أن فقدتك؟
– حسين في قلبي سؤالٌ عشتُ بعذابِه سنواتٍ طويلة، وقد جاء بي القدرُ العجيبُإلى منزلك..يومان وأنا مترددةٌ في محادثتك، لابد أن تجيبني عن سؤالي ياحسين ليرتاح قلبي.
– أجيبك ياندى، تكلمي
– لماذا.. لماذا أدخلتَ نفسك في مصيرٍ كان مجهولاً بالنسبة لي، وتركتني أواجه وحدتي بمفردي؟
– نفس هذه ال “لماذا” تلح عليَّ منذ أن أخبرتني والدتك بأنك تزوَّجت..أكانت ثمانيةُأشهر من غيابي عنك؛ كافيةً لتخوني عهدك لي ياحبيبة القلب؟
– لست خائنة أنا يا حسين..أنت من هجرني وأخلف وعده.
– إنها ثمانية أشهر يا ندى، حتى أنك لم تفكِّري – ولو بدافع الفضول – أن تنتظريني، لتعرفي ما حل بي..لكنني أعذر تخليك عن العهد يا ندى، أين أنا من زوجك العقيد رفيعِ المستوى
– لا تطعن بوفائي لك، أنت لا تفهم ما الذي مررتُ به في غيابك
أربعُ ساعاتٍ من الليلِ مرَّتْونحن نجترُّ ألمَالسنوات الغابرة، أجبتها على سؤالها، وقصصتُ لها مالم أقصْهُ على أمي وزوجتي من عذابات الزنزانة ولياليها، ثم حان دورها هي لتجيبني على كل “لماذا” طرحتها عليها..
أخبرتها برسائلي التي كنتُ أكتبها لها في كل مرة، وكيف كانت تغرقُ بدمي مرة، وتضيع في الزنزانة السوداء مراتٍ عديدة.
– يا إلهي..ما الذي فعلته بنفسك! أيُّ حمقٍ قادك لترتكبَ فعلتك تلك؟ هذا جبن وتخاذل منك يا حسين.
– جبان أنا يا ندى! هل هذا ما علمك إياه زوجك القائد العسكري الكبير؟
يبدو أنك ممن يعتقد بأنَّ الرجال البسطاءَ من الجرمِ أن يفكروا، أن تكونَ لهم معتقداتٌ يؤمنون بها، وأنَّ التفكيرَ هو من حقِّ القوي الجريء المقدام، والمقدامُ هو على حقٍّ أكثر من غيره، وهو من يقرِّرُ مصيرَ سوادَ القوم،لأنَّه أقوى منهم إرادة ولا فائدةَ من شرحِ وجهةِ نظرهِ للناس،لأنَّهم لا يفهمون، فهُمْ في نظرهِ رعاع..ولا داعي من بذلِ مجهودٍ لتغييرهم…المقدامُ وحده له الحق في تشريعِ وتسييرِ أمورهم.
– لم يحطمْك سوى تلك الأفكارِ الغريبة والمتطرفة يا حسين، مالك أنت وما ستؤولُ إليه حال الآخرين.. كان لابد لك أن تكملَ خدمتك العسكرية مقتنعاً كنتَ أم رافضا، أما ما أقدمتُ عليه؛ فلا يعدو كونه ضعفاً وهروباً من المواجهة…
– قلبتك عشرتك مع الزوج العظيم إلى امرأةٍ أخرى، امرأةٍ أرستقراطية ترفلُ في النعيم لا يعنيها من أيِّ قمامةٍ يتناولُ الفقراءُ عشاءهم..
أسمعيني يا ندى، يا ماري أنطوانيت زمانك.. لن أبرِّرَ لك سببَ رفضي لحربٍ لم تُمسكْ نيرانها،فنحن في بلدٍ يعيشُ بعض منا مثل النملِ، نحملُ عشرةَ أضعافاً وزنناً من الهمومِ والمتاعب، في حين يعيشُ القلائلُ في زمر، تظنُّ أنَّ ثورةَ الشعبِ لم تكن بسببِ الجوعِ، بل فقط لأنَّه سئمَطعمَ الكعكِ والحلوى، وراح يشتهي الحنطةَ والشعير.
تغيَّرتِ نعم.. تغيَّرتِ يا ندى، ولا أقصدُ بذلك التغيِّرَ الظاهري..فأنت لم تزيدي سوى بعض الكيلوغرامات، وبعض الشعيرات البيضاء التي تضيء ليلَ شعرك الناعم..
لا يعنيني ما تحمليه لي الآن في قلبك.. حبّاً أم سخرية، شفقةً أم فضول.
– لم يغادرني حبك، ولم يتركني أنعم بالهدوء..كنتِ كابوسي المقيم في صباحي وليلي.
– لكنني لم أعد أقوى على النظرِ في وجهك مرة أخرى، فعيناك تطرقان على أبواب النسيان، وصوتك يسري في أوردتي، ويصعد مع مجرى دمي إلى قلبي المنهك، ثم يستحم هناك بـأوكسجين السنوات الضائعات على ضفافِ جدول الدموع، ليعودَ وينتشرَ بفورانٍ مخيفٍ عبر شراييني.
كيف السبيلُ إلى الخلاص يا ندى…
دليني بالله عليك.. كيف السبيلُ إلى نهارٍ صيفيٍّ لا قيظَ فيه، وليلٍ قطبيٍّ دون ارتعاش…
دليني على موتٍ دافئ، يذيبُ صقيعَ الوحشة، فما تبقَّى من الصبرِ لا يكفيني
– وماذا في ذلك.. ما تزال أمامنا فرصة للقاء.. لابد أن تراني وأراك، ولدانا عاشقان، وأنا لم يبرحْ حبك قلبي حتى اليوم..لماذا هذا الضعفُ منك يا حسين، أين جرأتك المعهودة.
– يبدو أنَّ مقياسَ الجبنَ والشجاعة، الضعف والقوة؛ قد اختل لديك يا ندى. تتهمينني بأنني رجلٌ جبانٌ منذ قليل فقط لأنَّني أرفضُ أن أساقَ لأمورٍ لا أعتقد بصحّتها..والآن حين يتطلَّبُ الموقفُ مني الشدّةَ والصبرَ للحفاظِ على ترابط عائلتي، أبدو في نظرك ضعيفا. بأيِّ لغةٍ تترجمين مواقفَ الرجال أنت يا ندى.. ألم أقل لك أنك ندى أخرى لا أكاد أعرفها..ندى ترى من الحياةِ الأسودَ والأبيض، ما يجعل من مزاجها رائقاً هو الصواب، وما يضر بمصلحتها هو ضعفٌ وجرم…
– لستُ كذلك..لكن كفاك تلعبُ دورَ الضحية، وتتلذَّذُ بالعذابِ مثل قدِّيسٍ يرى في عذابهِ خلاصاً لبني البشر..قد ارتكبتَ أنت حمقاً فيما سبق، وحال ذلك دون زواجنا، وأرغمتني الظروفُ فصرتُ زوجةً لرجلٍ آخر، لكنه كان كريماً معي ولم يحرمني من شيء، وها قد حانتِ الفرصةُ لنا مرةً أخرى، فلماذا نستكين، ونبقى جبناءً ولدينا متسعٌ من الوقتِ لإصلاحِ ما فسد؟
– أيُّ أنا ترضخُ تحتها روحُك يا ندى! لمْ تصبري على اختفائي، واقترنتِ برجلٍ آخرَ فقط لأنَّه منحك رغدَ العيش، لم تعنيك مبادئه ولا مبادئي، لم تنظري حتى للفرقِ الشاسعِ بيني وبينه..زوجك كان يؤمنُ بفكرةِ الضابطِ المقدامِ الذي يطيع الأوامر ويخوضُ الحروبَ دون أن يكلِّفَ نفسَهُ معاناةَ فهمِ ما تخلّفه حروبه تلك من كوارثٍ ومآسي، لم يرفْ جفنُهُ حين كان ينتهي من كل صولةٍ وجولة،ثم تُحملُ الجثثُ بالمئاتِ إلى المقابرِ فقط لأنَّ وساماً ذهبياً جديداً، سيعلق على صدره، مصطفَّاً مع دزينةِ الأوسمةِ العديدة التي لم يعد صدرُهُ الضخمُ أن يسعها.. كل ما كان يعنيك منه، هو تضاعفُ الأموالِ في رصيدهِ، والطباخ، والسائق، والخادم، ثم الحارس الذي وظَّفَه لحمايتك وتحت أمرك.. فيما كنت أنا أعرِّضُ نفسي للهلاك،لأنَّني رجلٌ يرفضُ أن يراقَ دمه ليعلِّقَ القادةُ الأوسمةَ على صدورهم، قاسيتُ شظفَ العيشِ طيلةَ عشرِ سنواتٍ عجاف، بُليَتْ فيها أبدانُ الناسِ من العوزِوالفاقة، ولم أفكِّرْ بالسرقةِ أو صعودِ السلّمِ عبر الانضمام لكيانٍ لا أؤمنُ به، والآن تصفين جلدي، وصبري، أمام سيولك الجارفة بالضعف..
– تحمِّلُ نفسَك فوق ما تطيق، وتتحدث بحديثٍ أكلَ عليه الدهر وشرب، لا أحدَ يفكرُ اليوم إلا بمصلحته يا حسين، ولو توافرتْ فرصةٌ للمرأةِ التي تزوجتها أنت مثل فرصتي حين تقدم لي زوجي رحمه الله؛ لما تأخرتْ في تفضيلِه عليك.. أقول لك هذا الكلام لعلمي بحبك لي، وعدم مقدرتك على الصمودِ أمام ماضينا وذكرياتنا..
– أنتِ تعتبرينني ضعيفاً وخيالياً، أو ربما سريالياً..بل الحقُّ أنك تفكرين نيابةً عني، وتفترضين ما يتناسب والأنا التي يقوم عليها عمودُ روحِك الفقري.
حمداً لله أن ما كتبته من رسائلٍ عند رقودي في المستشفى العسكري، وفي زنزانتي، لم تصلْ إليك..فلو وصلتْ لكان مصيرها سلةُ المهملات، فهي رسائلُ شاعرٍ موهومٍ بالحرية والسلام، يؤمنُ أنَّ ما يقوم عليه الكون هو الحب، وللحبِّ أوجهٌ كثيرة..ما تحمليه لي في قلبك ليس حبَّاً يا ندى، إنه الغرور.. ترغبين إرضاءَ غرورك حين ترين العاشقَ يرتمي تحت تراب قدميك، بعد أن قاربَالستين من العمر، ضارباً كلَّ أوجهِ الحبِّ الأخرى، ناحراً إياها في محرابِ عينيك.. كلا يا ندى.. إن فعلتُ ما تطلبيه مني؛ فلن أكون سوى رجلٍ مخادعٍ تافه..وهذا ما لستُ عليه في الحقيقة، حبي لك ظلَّ سريّاً، ولم أفشِ به لأحد، وزوجتي لا تستحقُّ مني تلك الضربةُ المؤلمة التي ستمزق قلبها ولا ريب، صفيني كما تشائين، لكن كوني رحيمةً بالعاشقين الصغيرين، ولا تتخذي منهما طعماً لتصطادي ما زهدتِ به فيما مضى، وتذكَّري أنَّ للحبِّ عدة أوجهٍ.. لا وجه واحد.
********
تسيرُ ممسكةً بذراعي، وعطرها يعبقُ في الأرجاء، كانت تبدو مثل باقةِ وردٍ يانعةٍ في فستانها الأبيض الطويل، أميرة من قصصِألفِ ليلةٍ وليلة، سارة.. هدية الحياة إلي، هدية هذه الأرض التي شبعتْ من الموتِ، وسقيتْ بالدماءِ بدلَ المطر، هذه الأرضُ المنكوبة،أهدتني أجملَ زهرةٍ تفتَّحتْ على ترابها..
سارة.. إنك تختزلين كلَّ حسنِ الكونِ في خضرةِ عينيك، أين شبيهاتك التسعُ والثلاثين ياسارة.. لابد أنَّ الله اختزلهن كلهن فيك، فلا شبيهةً لك مابين السماءِ والأرض، نجمةٌ وحيدةٌ ترصِّعُ خدَّ السماء.. مددتُ كفي، فراحت تنامُ بين راحتي، ونورها يضيءُ عتمةَأيامي…
كان عرسنا حفلاً صغيراً، لم ندعُفيه غير الأحبةِ والمقربين جداً لنا,كان احتفالنا ببيتِ والدةِ سارة، فلو أقمناه في حينا؛ لهرعَ الملثَّمون إلينا، يأمروننا بأن نضعَ عباءةً سوداءَ نغطِّي بها العروس، وأن نغلقَ جهازَ التسجيل الذي يبث الموسيقى،لأنَّها من المحرمات…
.كنتُأشاهدُ الدمع يتلألأ على خدّيّ خالتي ندى، وهي ترقبُ سارة بعينين ملؤها الفرح والرجاء..واليوم الوحيدُ الذي رأيتُ فيه أمي، وهي ترقصُ من شدةِ الفرحِ؛ كان يوم زواجي…
كانتْ ترقصُ مثل طفلةٍ مبتهجةٍ بحركاتٍ غير نظامية، ولاتمتُّ للرقصِ بصلة، لكنها كانت سعيدةً، فراحت تدورُ وتدور حول نفسها، وتلوح بذراعيها مرة، ثم تعودُ لتصفِّقَ وتدندنَ مع الموسيقى مرة أخرى.
فالناسُ يرقصون فرحاً، ويرقصون ألماً، وكذا حال البكاء.. الدموعُ خير من يعبِّرُ عن الحزنِ والفرحِ في حالةِ عجزِنا عن كتمِ الألم،أو عن الرقص فرحاً.
قضينا ليلتنا الأولى في منزلنا الجديد الصغير، والذي اختارتْ سارة كلَّ قطعةِأثاثٍ فيه على ذوقها..فكان البيتُ يشبهها، ببياضُه، ورقَّته،والنباتاتُ الخضراءُ المنتشرة في جميع أركانِه.
كنتُ وأنا داخلَ المنزل، يتملَّكني إحساسٌ بأنَّ الربيعَ فصلٌ دائمٌ لا يرحل، ففي كل زاويةٍ التفتُإليها؛ تقع عيني على لونِ العشبِأيامِ الربيع، غير عيني سارة الخضراوين اللتين كانتا ربيعي الأبدي.
لكنَّ صوتَ بائعِ قناني الغاز وهو يضربُ قنانيه بقطعةٍ من الحديدِ، أحدثَ فزعاً حتى على الموتى في رقادهم، فأيقظني من نشوةِ حلمي اللذيذ، والتي بقيت ساعاتٍ النهار التي تلتِاستيقاظي القسري، أسترجعه في أحلام يقظتي.سارة وثوب زفافها، ومنزلنا الغارق بالعشب وعطر جسدها، ورقص أمي البريء المضحك…
ما أجملَ الأحلام.. فهي تحقِّقُ لنا كلَّ ما نرغبُ به بأجزاء من الثانية! إنَّ الأحلامَ وسائدٌ تحتضنُ رؤوسنا المتعبة.
لا أدري لِمَ تأخّرَأبي في الردِّ على طلبي في أن يأتي معي لخطبةِ سارة، وطلْبِ يدِها من والدتها؟ إنَّأمرَهُ يحيُّرني، فهو متجِّهمٌ شاردُ الذهن منذ ذلك اليوم الذي زارتنا فيه سارة ووالدتها.
أمي تعلل شرودَهُعلى أنه متعبٌ من كل شيء،سيما ماحدث لي من اختطافٍ كاد يودي بحياتي، ومن الهاويةِ التي يسيرُ نحوها الجميعُ في بلدٍ على شفا جرفِ الجحيم.
45)
برعمان صغيران تحملهما بطنُ سارة منذ تسعة شهور.. كان وصولي للمستشفى أنا وسارة وخالتي ندى عسيراً جداً، فأغلب الشوارع مغلقة، الناس سئمتْ من الموتِ والذل، سئمتِ الجحيمَ الذي تعيش فيه، تظاهراتٌ واحتجاجاتٌ وأفواهٌ غرثى تصرخ، مما أفضى بناأن نستغرقَ وقتاً طويلاً لأصلَ بسيارتي، ومن معي إلى المستشفى، في الموعد المحدد لإجراءِ العمليةِ القيصرية لسارة وولادةِ التوأم.
طفلانا الحبيبان.كانت صورتهما تظهرُ في شاشةِ جهازِ الأمواج فوق الصوتية، وهما يحتضنان بعضهما مثل زهرتين في غصن.
قبَّلتُ سارة في جبينها الناصع، وأخبرتها أنني سأقفُ هنا خارجَ بابِ غرفةِ العمليات بانتظارها:
– تشجعي حبيبتي ..لا تخافي أبداً، فأنتِأميرتي وبطلتي التي أنتظرُ منها رافدين حديثي الولادة، يمرَّان في ترابِ العراق فتنبتُ الأرضُ الجدباءُ ريحانا.
– علي، إن حدث لي مكروه.. وصيتي َ َ َ
– ششششش…ادخلي يا سارة، وإياك أن تعيدي ما قلتِ للتو..ستخرجين أنتِ وطفلينا معافاة حبيبتي.
كانتْ خالتي ندى تستندُ على كتفي من شدِّة ارتعاشها، فهي تفقدُ كلَّ قوتها حين يتعلَّقُ الأمرُ بسارة وحيدتها. دخلتْ سارة، وبقينا أنا ووالدتها خارجاً ننتظر…
كانتِ الدقائقُ تمرُّ علي كأنها سنواتٌ ثقيلة، وهمومٌ عديدةٌ تثقلُ كاهلي، لكنَّ سعادتي حين أتخيَّلُ
ابتسامةَ والدي وهويرى وجهَ حفيديه لأول مرة، كانت تطيح بهمومي جانباً.
….
وجَّهتُ نظري صوبَ الممرضةِ الخارجةِ توَّاً من غرفة العمليات، وهي تتجه نحوي تحملُ بين ذراعيها كائنين حمراوين صغيرين، ملفوفين بقماشٍأبيض، وأفواههما الصغيرةُ مفتوحة على سعتها تصرخ بصوتٍ حادٍّ وساحر.
ركضتْ خالتي ندى صوبَ الممرضة، وأخذتْ منها الطفلين ونادتني:
– علي..انظرْ لابنك وبنتك، ملاكان صغيران، مباركٌ لك ياولدي.
نظرتُإلى وجهيهما كانا مغمضي العينين، كأنهما طيران من الجنة..
التفت إلى الممرضةِ الواقفةِ قبالتي وسألتها:
– كيف حال زوجتي، اخبريني من فضلك؟
– بخير، سنخرجها بعد أن تفيقَ من التخدير، مباركٌ لكم الصغيران.. ماذا ستسميهما؟
كنتُأهمُّ بالردِّ على الممرضة باسمي طفلينا أنا وسارة، حين سمعتُ أحدهم ينادي باسمي، التفت خلفي، فوجدتُ زوج عمتي عمر يقفُ ممسكاً بكيسٍ كبيرٍ من الورقِ الأبيض السميك
– علي خذْ هذه الملابس لوالدك، قل له أن يستحمَّ ويرتدي ما أحضرته له، وليسرعْ فنحن بانتظاره.
– لكن ما الخطبُ يا زوج عمتي، أين ستذهبان، ومن هم الذين في انتظار،ثم إنَّ والدي في البيت، لماذا لم تذهبْ أنت بنفسك وتسلِّمُهُ هذا الكيس؟
– حكاية طويلة يا علي، اذهب فقط لوالدك، وأسرع الخطى، إنه مستلقٍهناك بين الأزرقين ..
– لم أفهم، أين أبي الآن!؟
– أنه بين المرفوع والجاري.. المجهول والمعلوم، في وسطِ المسافةِ على مرمى رصاصة.
تركني زوج عمتي عمر، بعد أن رمى تلك الألغاز في وجهي، ووضع في يدي ذلك الكيسَ الكبير، فتحته ولم أجدْ فيه سوى ثلاثِ خرقٍ بيضاء بمقاساتٍ مختلفة، مطرزةٌ بكلماتٍ يبدو أنها طلَّسم أو دعاء، فدهشت لذلك..ما الذي يمكن لأبي أن يفعلَهُ بتلك الخرق، على أنَّ هاجساً غريباً كان يحوم حولي، شعورٌ مخيفٌ يقول لي أن أبي ليس بخير..
علي.. علي.. مابك ياولدي، ماذا حصل لحسين.. اخبرني؟؟
كانت خالتي ندى تصرخُ في وجهي وذراعاها تحتضن الطفلين، وعيناها تبعثانألفَ علامةِ استفهام، تريد مني جواباً.
…
لكنَّالدموعَكانتْتغرقُ عيني، وتمنعني من الرؤيةِ وأنا أضحك بشكلٍ هستيريٍّ مجنون.
وخالتي ندى تحتضن الطفلين وتبكي، فتركتُها وخرجتُ مهرولاًأبحثُ عن أبي،
وصوت خالتي ندى يأتي من ورائي وهي تصيح:
– سأسميهما حسين وندى…
حسين وندى …
ابنك حسين، وابنتك ندى ياعلي..
كنتُ أركضُوساقي تسابقُ الريح، فارتطمَ كتفي من شدة سرعتي والدموع التي تحجبُ الصور أمام عيني بكتفِّ امرأةٍ لم أتبينْ ملامحَ وجهها، فقد كانت مبرقعةً بالسواد من قمّةِ رأسها إلى أخمص قدميها، لكن ارتطامي بها دفعها إلى التعلّق برقبتي بيديها الاثنتين، والصراخ في وجهي بأعلى صوتها:
مجرمون… مجرمون.. قتلة.. مجرمون
وحين حاولتُ التخلُّصَ من كفَّيها المطبقتين على عنقي؛ وقعت أرضاًوشدتني معها، فشعرتُ بيدها تضرب على صدري..
عندها فتحت عيني واستيقظت… وجدتُ أمي هي من يمسكُ بعنقي، ويضرب على صدري لتوقظني من نومي الثقيل وكابوسي المزعج،وهي تصرخ باكية:
– علي.. انهضْ يا ولدي، انهضْ وارتدِ ملابسك بسرعة
– أمي مابك؟ سحنتك غريبة، وكأنَّ الحربَ العالميةَ الثالثةَ قد قامت!
– ارتدِ ملابسك الآن، ولنخرج
– الساعة هي السادسة صباحاً، أين نذهب في هذا الوقت يا أمي، مابك!
– انهضْ.. توقَّفَ الزمنُالآن ياعلي.. قد عثروا على زوجِ عمتك عمرَ مقتولاً في مكتبه قبل ساعات، شقَّ أحدهم رأسَهُ بفأس، لم يعثروا على القاتل.
وأبوك..
– ماذا حل بأبي.. تكلمي، أمي، أجيبيني؟
وبصرخةٍ عاليةٍ هبطتْأمي نحو الأرض على ركبتيها وهي تصيح
“والدك لم يعد للبيت منذ ليلة أمس”
بعينين مفزوعتين كنتُ أنظُر لوالدتي، وأحاول أن أتذكَّرَ ما قاله لي زوج عمتي عمر في حلمي..وفي ذهولي تهاويتُ أرضاً، محتضناً أمي، مازجاً دمعي بدمعها الساخن..خدّي يلتصقُ بخدِّها البارد، وذراعي ترتعشان فوق كتفيها، وجدتُ نفسي أهمسُ لها بصوتٍ لم يكن صوتي، كان يشبه صراخاً مكتوماً لشخص لا أعرفه:
-انهضي يا أمي.. وشدّي مئزرك للعزاء، أنا ذاهب لحمل أبي، فقد تأخرنا على مراسم الدفن.
********
من النافذةِ المفتوحةِ لغرفةِ النوم بدأتْ خيوطُ الشمسِ الأولى تتسلَّلُ وتشقُّ العتمةَ، مشكِّلةً شلالاً من نورٍ تسبحُ فيه كائناتٌ صغيرة، غير مباليةٍ بضجيجِ الكونِ،ثم تراقصتْ في الشلالِ فراشتان تسبحُ أجنحتهما الصفراء الذهبية ببقعها السوداء، في عالمٍ ضبابيٍّ سحري يأتي من بعيد, من الجانب الآخر,حيث تسكنُ الحقيقةُ خلف أسوار الانتظار.
(انتهتْ)